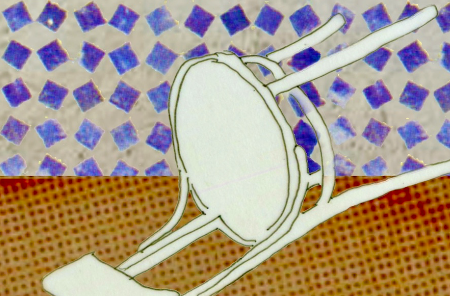لا أطمح ولم أبحث يوما عن كتابة متساوية ومشتركة للأسماء على نفس الحور أو نفس الرمل فربما كان ذلك عدل زائف، فقد وجدت الحب منثورا بين الكلمات وبين التنهدات وفي لحظات الصمت والتأفف، هو وحده من يكتب ويمحي أحداث قصصنا ولا تسجنه أسامينا، أسامينا وحدها لا تبني بيتا ولا تحكي قصة.
تتعبني الأيام العادية، لا لرتابتها بل لكمية التفسيرات والتبريرات المطلوبة مني وكأن اللغة وكلماتها خلقت لهذا الغرض فقط، أول التبريرات وأعتقها هو حول طريقة مسكي لقلم الرصاص . منذ المسكة الأولى في الصف الأول أو ربما الروضة، إلى يومنا هذا وما بعده، إلى حين أن يفلت القلم من يدي.
مسكي للقلم لم تكن مثل بقية أبناء جيلي، ولم أكن من الاقلية التي اختارت أن تمسك القلم باليد اليسرى واحترم الجميع رأيها بعد تبريرات قليلة . فقد قررت أن أمسك قلمي بيدي اليمنى بطريقة مريحة لها، ألفها قليلا دون ان ألف الورقة، لا وصف دقيق لدي للطريقة ولا أريد الاجتهاد في ذلك ولم يكن لدي حينها عقيدة او فلسفة عميقة خلف تلك المسكة إلا أن علاقتي بها وإصراري عليها كان يتعمق مع كل مطالبة بالشرح والتفسير الذي لا أملكه.
أذكر جيدا كل ملاحظات المعلمات والمعلمين لأمي، بأن تلك الطريقة تدل على استيعاب بطئ وعسر تعليمي وأنني من الصعب أن أكتب بخط جيد ومفهوم وسيؤثر ذلك حتما على تحصيلي العلمي وشخصيتي وأن عليها اخذي لأخصائيين للعلاج . أمسكت أنا بقلمي وأمسكت أمي بيدي، حضنتها ودافعت عنها بكل شراسة ولم تطالبها بأي تبرير.
لازلت في عيادتي اليوم بعد خمسة وعشرين عاما من مسكتي الأولى والثابتة للقلم، أجلس خلف مكتبي ومعطفي الأبيض ولقب الطبيبة، تلك الامتيازات التي خلت أنها قد تحميني من كثرة الإجابات إلا أنها قادت إلي المزيد من الاسئلة، يستمرون بالسؤال، استمر بالكتابة، أبتسم ولا أجيب.
في أحد الأيام العادية، في الساعة الثالثة وربع عصرا، دخلت سيارتي أدرت المحرك، فانطلقت من الراديو أغنية فيروز " بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، بتكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، بكرة بتشتي الدني ع القصص المْجَرَّحة يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى" توترت قليلا، أطفأت الراديو وفضلت أن أقضي طريقي وتلك الازمة المرورية الخانقة مع صمتي وصوت افكاري. لم تكن مشكلتي مع الاغنية توقيتها، فصوت فيروز لدي ليس مفتاحاً للصباح، أحبها وأحب صوتها جدا بكل الاوقات، إلا أن الكلمات هي أكثر ما يهمني في الأحاديث والأغاني، حتى في لحظات الصمت تشغلني تلك الكلمات التي لم تقال.
دائما أتخيل هذا المقطع، كمشهد صامت، بارد الأجواء، يحدث في بيت شفاف مكون من طابقين مفصولين نرى ما بداخله، ففي الطابق الثاني امرأة رقيقة متعبة تحفر بكل قوتها وحواسها اسما ما على الحور العتيق (نوع من الأشجار)، وفي الطابق الأول رجل دون ملامح واضحة يكتب اسما بطرف عود خشبي على الرمل وخلفه في الطابق نفسه بحر هائج ينتظر أن ينهي كتابة الاسم ليمحيه.
لا درج ولا نافذة ولا تواصل بين الطابقين كل منهما منهمك بكتابة اسم الآخر وحيدا، وفي مشهد آخر رأيت نفسي مع نساء كثيرات في الطابق العلوي نجتهد ونتسابق في كتابة أسماء أحبتنا على الحور العتيق، نريد ان نثبت لفيروز ولأنفسنا كل صباح عن قدرتنا بالحب اللا متناهي في النقش على الحور ليلا نهارا، و قد ننزل بين الحين والآخر الى الطابق الأول، إن تأخر البحر الهائج لنمحي اسمنا عن الرمل بأنفسنا بدلو ماء.
بيوت كثيرة الزجاج، قليلة المرايا، تكون فيها عيون النساء مرايا، تظهر لكي تقصيرك في الحفر، وتشير الى التجاعيد التي لم تظهر بعد وشحوب الوجهة والهالات السوداء حول العين قبل حدوثها، فهي مرايا ناطقة تحدثك عن أسرار إخفاء وتخبئة أي شيء وكل شيء. وهناك في ركن مهجور معتم، مرآة مكسورة تعتليها طبقات من الغبار لكنها تبقى واضحة، يهرب منها الجميع ويخافون النظر إليها ربما لأنها تظهر العيون المنطفئة، الملامح والأحرف والأجزاء الناقصة منا وما خلفته من فراغ، تخبرنا أين وقعت منا وكيف لنا أن نستعيدها، لا يحجب صورتها الكاملة شيء لا الغبار أو المساحيق، لا الأقنعة ولا حتى الكمامات.
رغم اجتهادي،لم استطيع البقاء بورشة النحت والمرايا الناطقة تلك كثيرا، هربت منها بعد أن أخذت كسرة من مرآة الحقيقة ولملمت جميع الأحرف التي سقطت مني هناك.
وعدت إلي بيتنا حيث تقام ورشة حب مكثفة يومية بإشراف أمي وأبي علماني فيها عشرة آلاف أبجدية حب لم تكن كتابة الأسماء العمودية تلك بينها.
أول تلك الأبجديات كان اسمي المكون من اربعة حروف، اختاراه معا تيمنا باسم جدتي (أم أبي) التي توفيت قبل ولادتي، فحمل اسمي قبل أن يلتقيني حنينها وأمومتها، وفاء والديّ واشتياقهم لي ولها، فكان كتلة من الصدق والاحضان لا تتفكك ولا تتجزأ.
حضنني اسمي منذ يومي الأول، قد أحتاج أحيانا كثيرة إلى تفسير سبب تسميتي وطريقة نطقه (حلوة بالفتحة، حلوة بالضمة، حلوة بالكسرة) وأن أتعامل مع نظرات استغراب والفضول من جرأة الاسم فليس من الاسماء الدارجة في محيطنا، وأحيانا تكون تلك أسئلة عابرة سريعة لا تنتظر إجابة بين وابل الأسئلة والتفسيرات التي أواجهها بدقائق معدودة، عن عائلتي وبلدتي ومكان دراستي وعمري الدقيق وحالتي الاجتماعية عن حجابي ولون عيناي وهدوئي، وعن طلاء أظافري وعن مسكي للقلم...
فصرت قادرة على تفكيك حروف اسمي وتفكيك جسدي وتفكيك روحي إلى ذرات ذرات. كل منها قابلة أن تفسر وتحلل على حدى، وفي آخر النهار اعيد لملمتها وتركيبها مجددا لتفك من جديد في صباح أو مساء اليوم التالي، من كثرة الفك والتركيب عرفت أنني لست من نساء الانطباعات الأولى، ولن أعتذر عن ذلك، ووجدت أن بعض من قوتي، التي حاولت كثيرا إخفاءها خوفا من المرايا الناطقة، يكمن بثالوث دموعي، كلماتي وأحلامي. وأكثر ما قد يعرفني هو اسمي فهو قادر على ضمي ولملمتي واحتضاني.
فهو مرآة لها جوقة، تكشف لي عمق محبتي في قلوب من حولي، دون أن يسألونني عن نطقه أو أي شيء آخر .فأرى نفسي عبره بعيونهم بجمال لم أعرفه من قبل، أنا التي خلت أنني أعرف روحي وذراتها وندباتها جيدا. ويتحول على لسانهم إلى سيمفونية عذبة يرقص قلبي عليها طويلا.
لا أطمح ولم أبحث يوما عن كتابة متساوية ومشتركة للأسماء على نفس الحور أو نفس الرمل فربما كان ذلك عدل زائف، فقد وجدت الحب منثورا بين الكلمات وبين التنهدات وفي لحظات الصمت والتأفف، هو وحده من يكتب ويمحي أحداث قصصنا ولا تسجنه أسامينا، أسامينا وحدها لا تبني بيتا ولا تحكي قصة.