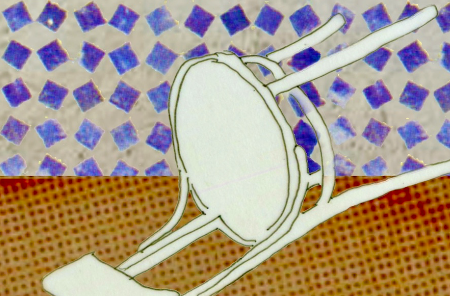قرأت مرّة جملة منسوبة لفان غوخ يقول فيها: "أنا أحلم بالرسم، ومن ثم أرسم حلمي". تذكّرتها الآن بينما أفكّر بفتيات غزّة، وأحلامهنّ التي يحلمن بها قبل الحرب، ويتخيّلن تحقيقها كلّ يوم؛ حتّى يحوّلها الاحتلال إلى كلماتهنّ الأخيرة، ونستخدمها نحن في نعي موتهنّ. هل تخيّلتم أحلامًا تُحال إلى نصوص لرثاء أصحابها؟
في غزة الحبيسة بين معبرين، خُلقت الكثير من الأجنحة لفتيات لم ترضى بالمساحة الضيّقة للمكان، ولم يقتنعنّ بالأبواب التي تُغلقها من جهة "إسرائيل"، ومن جهة أخرى مصر. وفي المنتصف، يقبع امتداد صغير وكثيف لا يحظى بمرونة كبيرة في التعامل مع الأجنحة؛ ليس لأن الحريّة شيء هجين في غزة، وإنما كامتداد لثقافة فلسطينية محافظة مجتمعيًا، تضيق أكثر عند جنوب الساحل.
ومثلما تتقن غزة العنيدة البقاء بمقارعة سجّانيها؛ تورّث هذا العناد لفتياتها، وتعلمهنّ الإصرار على الحلم؛ في ظل بيئة ليست سهلة للأحلام، وفي خلفية لديها معايير كثيرة للحلم، وقاسية تجاه الأحلام التي لا تتناسب تمامًا مع تلك المعايير. لكن ليس من طبيعة الحلم أن يكون مفصّلًا بغير ما يريده صاحبه، أو ما تريده صاحبته. فكان عليهنّ أن يظهرن قوّة كبيرة للاحتفاظ بالأحلام، ويخلقن مرونة عالية للتعايش معه في اللاوعي إلى جانب وعي مصبوغ بالأعراف واللاءات الكثيرة، وذلك إلى حين موعد التحليق.
لم ينتبه القانون الدوليّ الذي نصَّ بنودًا لحمايـة النسـاء أثنـاء الحـرب، إلى ضرورة التطرّق لحماية أحلامهن أيضًا؛ فتجريد الفتاة من أحلامها، لا يقلّ أهميّة عن بقيّة حقوق الإنسان المُسلّم بها عالميًا. والعنف النفسيّ الواقع عليها جرّاء احتمالية الموت دون تحقيق ذاتها، أو العيش بالطريقة التي تناسبها وتحلم بها؛ يوازي ما تعانيه مـن أشـكال العنف المركّب الذي يهندسه الاحتلال بدقّة في حروبه على غزّة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأذى.
وهكذا، تقضي الشابات في غزّة معظم حياتهنّ بتناقضات، بين الفضاء المتخّيل والمراد في أذهانهنّ، وذلك المُعاش في غزّتهن، والمفروض عليهنّ. وتزيد الحرب الأمرَ تعقيدًا؛ إذ تفرض واقعًا يتطلب الصمود من أجل حياة عاديّة، وحقوق بديهيّة، وقتال من أجل الماء والطعام؛ فكيف بما هو أبعد من الطبيعي، وأوسع من العادي، كالحلم!
تُقطع رحلة الحلم لدى الفتيات في غزة بشكل مأساويّ؛ الأمر الذي يدفعهن لوصف هذه القسوة عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات إذا تأمّلناها، نرى فيها نضالًا من أجل شيء أبعد من الحرية التي نعرفها؛ لأن الحريّة في غزة متخيّلة، وذات مراحل عديدة، انتهت هذه المرّة بوقعٍ قاسٍ يتمثّل بمرحلة "الوحش" الذي غالبًا ما تنتهي مواجهته بالقتل. قتل الوحش مريم سمير، وهبة أبو ندى، وأصاب ريتا، وترك ديما وروان ويارا وهيا وضحى وسجود وميس ومجد، وأسماء كثيرة تناضل نضالًا صامتًا لم يصلنا، تركهنّ غاضبات، يُحابين أحلامهن لتقاتل حتى النهاية المرجوّة التي تنجو فيها الأحلام، فتنجو معها صاحباتها.
قتلت إسرائيل رغبات عارمة في العيش، وأحلام مؤجّلة لبنات غزة، وقتلت مريم مرّتين؛ مرّة عندما أصيبت بصاروخ يعرف طريقه جيدًا إليها، ومرّة عندما فقدت قدرتها على الحلم. وقد تكون أحلام البقيّة أصيبت إصابات بالغة في الرغبة والإيمان، والقدرة على الصمود؛ لكن درسًا تقدمه غزة التي تخوض حروبها كل يوم في ساعاتها الصاخبة، وتخرج لتلعب مع البحر في ساعات الهدوء القليلة؛ علّم فتياتها مقارعة وحوش الأحلام.
لم يكن سهلًا غياب أصواتهن عن مشهد غزة الحالم بالحياة، ولن يكون كذلك أبدًا، سيكون هذا الغياب توثيقًا للحضور العارم للظلم، وشهادة على الأسباب التي صادرت حقّهن في الحلم، وأردته تحت الأنقاض لأيام عديدة قبل أن يغادر للمرّة الأخيرة مع بناتنا، ومُلهماتنا. ستتحوّل أحلامهن إلى غصّة لن تُشفى منها غزّة، ولا نحن، لكننا سنتحدث دائمًا عن مقاتلات كانت كلماتهنّ الأخيرة في مواجهة الحرب، عن الرغبة في الحياة؛ ليس بشكلها المفروض عليهن، وإنما بشكلها المتخيّل في أذهانهنّ، وعن الحريّة "التي هي نفسها المقابل".