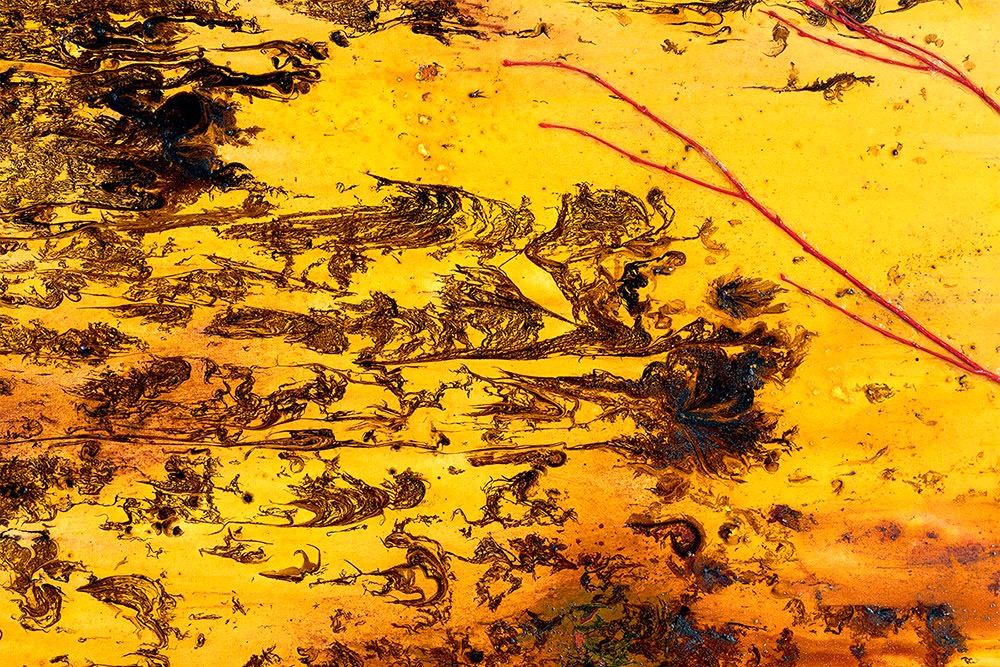لقد كرس خالد كل حياته من أجل الناس، وخصوصاً الفقراء منهم، فخدمهم وهم بدورهم أحبّوه، ولطالما كان يشكل حالة من الوفاق والإجماع، سواء في السجن أو خارجه، ولا سيما في زمن الانقسامات المقيتة التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، لكن بوصلته لم تنحرف يوماً عن الهم الوطني، ولا عن هموم الفقراء وحاجاتهم، حتى يومه الأخير.
سأكتب لكم عن صديق وصهر رحل باكراً، رحل في ذروة الموت والقتل في فلسطين، وكنتيجة طبيعية لما يحدث في بلادنا، رحل وآخر ما كان يفعله مشاهدة قناة "الجزيرة" وقنوات التلفزة الأُخرى التي كانت تبث مباشرة القصف الهمجي والبربري الذي تشنه الطائرات الإسرائيلية على قطاع غزة؛ على أطفالها ونسائها وشيوخها وشبابها، على مشافيها ومتاحفها ومدارسها ومزارعها، على بحرها وشاطئها.
رحل عند الثالثة صباحاً يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ الثالثة صباحاً هي ذروة ساعة النوم عند الناس الطبيعيين، لكن قلبه وعينيه لم يطاوعاه، فظلا يسهران مع أطفال غزة علّ في هذا عزاء له ومواساة لأهل غزة الذين يناشدون من أجل إخراجهم من تحت ركام المباني؛ رحل وهو يصلي صلاة الغائب على مَن لم يحالفه الحظ في الخروج حياً من تحت الأنقاض.
عندما يقال إن فلاناً توفي وفاةً طبيعية تكون هذه الوفاة ناجمة عن ذبحة قلبية مفاجئة أو تكون ساعته قد حانت، لكن ومن خلال معرفتي بخالد الخالدي، الصديق والصهر الوفي، فإن وفاته لم تكن طبيعية، وإنما كانت امتداداً لتجربة طويلة، بدايتها من قرية عنابة قضاء الرملة التي دُمّرت وهُجّر سكانها في العاشر من تموز/يوليو 1948، فتهجّرت العائلة في مخيمات اللجوء واستقر بها الحال في مخيم الجلزون القريب من رام الله ، لتبدأ رحلة المعاناة والفقر والنضال في آن واحد؛ فالأب والأم، رحمهما الله، أمضيا معظم وقتهما يتنقلان من سجن إسرائيلي إلى آخر يزوران أبناءهما، وخالد كان أحد هؤلاء الأبناء، إذ سُجن أكثر من مرة وفي أكثر من سجن، وكان ما يلبث أن يتحرر حتى يعود إلى السجن مرة أُخرى، وخصوصاً في سنوات الانتفاضة الأولى التي كان أحد فرسانها وقادتها الميدانيين.
وفي إحدى المرات، وبعد زواجه بيومين من شقيقتي مريم فراج عام 1990، أوقفته دورية لجيش الاحتلال في أزقة المخيم، وكان قد مضى على خروجه من السجن أسبوعان، فطلب الجنود هويته، وبعد التدقيق فيها قالوا له إنه مطلوب ورهن الاعتقال، وما إن سمع ذلك من ضابط الدورية حتى فر هارباً بعد أن عض يد الجندي، ليتحول في لحظات إلى مطارَد من مطارَدي الانتفاضة الأولى. وبرر هروبه من قبضة الجنود، لاحقاً، بأنه لم يكن خوفاً من السجن، وإنما رغبة في الاستمرار في تأدية دوره في الانتفاضة الشعبية، وبسبب حبه وتعلقه بالحرية.
إن هذه التجربة امتدت طوال سنوات، وشاركه فيها أشقاؤه وشقيقاته والجيلان الثاني والثالث من العائلة الذين خاضوا غمار تجربة الاعتقال والشهادة؛ فقد استشهد ليث ابن شقيقه فضل في صيف عام 2015 بعد أن قنصه جندي إسرائيلي متحصن في برجٍ عالٍ شمال بلدة بيرزيت في أثناء تظاهرة منددة بجريمة حرق عائلة الدوابشة من جانب المستوطنين في قرية دوما القريبة من نابلس. إذاً، فالموت الطبيعي لا ينطبق على حالة خالد، وحتى إن كانت وفاته بالذبحة الصدرية أو الجلطة، إلاّ إنها نتيجة مباشرة لتجربته؛ خالد رحل نتيجة معايشته ومواكبته لتاريخ طويل من القهر والقتل والفقر والسجن؛ رحل وهو شاهد على حرب إبادة غير مسبوقة على شعبه الذي أحبَّ وعمل طوال حياته من أجل أن يحظى هذا الشعب بحقوق عادلة، من حرية وكرامة وحياة بلا احتلال.
لقد كرس خالد كل حياته من أجل الناس، وخصوصاً الفقراء منهم، فخدمهم وهم بدورهم أحبّوه، ولطالما كان يشكل حالة من الوفاق والإجماع، سواء في السجن أو خارجه، ولا سيما في زمن الانقسامات المقيتة التي عاشها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، لكن بوصلته لم تنحرف يوماً عن الهم الوطني، ولا عن هموم الفقراء وحاجاتهم، حتى يومه الأخير.
لقد كان رحيل خالد قاسياً على الجميع؛ على شقيقتي مريم وبناتها حنين وهديل وديما ومرح وتيا، كما كان قاسياً على كل مَن عرفه، لأن كل من عرف خالد أصبح صديقاً له، فهو الإنسان الودود والقريب من القلب، ولهذا اكتظ عزاؤه بالأصدقاء والمحبين على مدى ثلاثة أيام. وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لناحية الحصار والحواجز التي حالت دون مشاركة كثير من الأصدقاء والمحبين في وداعه، فإن بيت العزاء كان مكتظاً بآلاف الناس من كل المدن والقرى في كل فلسطين.
إلى شقيقتي مريم، وعلى الرغم من قسوة الرحيل، فإن عزاءنا في أن تمنحنا وتمنحك الذكريات الجميلة والطيبة التي تشاركناها مع خالد قليلاً من السكينة.
لروحك السلام صديقنا وحبيبنا خالد.