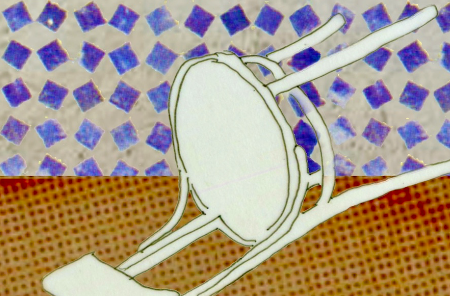ولزاوية سيدي عبيد الغرياني أن تعطي مثل هذا النَّظر؛ ففيه بعدان، ظاهريٌّ كما هو محرابها القائمُ ببهوٍ مفتوحٍ على الشَّمس، وباطنيٌّ كم هو محرابُها الثَّاني القائمُ بقاعةٍ في الجهة المغطَّاة. وما دامت أعمدتُه قائمةٌ في صلابة الرُّخام، وتيجانُهُ ثابتةٌ على المقام، فإنَّها قادرة على تجاوز محنتها وإعادة بعث ماء الحياة بسحنتها.
أهِيمُ كأنَّ عينيكِ ليلٌ بهيمٌ، اِسْتَبدَّت بالجُيُوشْ
وفي طَرَفَيْهِ زُرَّتْ مُهْجَتِي بَعْدَ أنْ حُلَّتْ على ضِيمِ الوُحُوش
فمُذْ أَسْلَمْتِنِي خَتْمًا تَفَتَّحَ قَلْبِي بَيْنَ طَيَّاتِ النُّقُوش
ومَا زَالَتْ أحاديثُ الهَوى تتقَتَّلُ بينَها شَغَفَ الرُّمُوش
لَقَدْ أضْحَيْتُ، مِنْ قَيْسٍ وَلَيْلَى، بِوَجْهٍ عَائِمٍ فوقَ الخُدُوش
ولقد جال بخاطري أن أُسني في القيروان، لعمومِ صفائها ونقيِّ هوائها، وعَليلِ صباحها وطيبِ مسائها، ومشمول أُنسِها في فضيضِ الرِّيف، ومعهود عرسها المُقامِ بين الشِّتاءِ والصَّيف، فلقد أجدبت روحي بغربتها وبغت عليها السِّنينُ العجاف، ثمَّ شذَّ عليها الأليفُ، فما لبثَتْ في موضعٍ زاد عليها من ذلك إلَّا وكان مرادها كرًّا وفرًّا إليها وإلى فاس.
وأستغربُ امتناع الحكَّام عن أن يكون بين فاس وتلمسان والقيروان ما يسري بالعباد إليها ليلاً أو نهارا، ففي فاس، بَنَتْ فاطمةٌ القيروانيَّة أوَّل جامعةٍ بها فسميَّت جامع القروِيِّين بمسمَّاها ، فكان ذلك منها عزمُ النَّفس بناءً واقتدارَا، ثمَّ تلتها مريمُ بجامع بعدوة الأندلس، وفي تلمسان وفاس فضلُ بعضٍٍ على بعض، تعليمًا واعتبارَا، ولقد وقفتُ على أضرحةٍ كثيرةٍ لعلماء مغاربةٍ بالقيروان، وهي أضرحةٌ بحجمِ زاويةٍ صغيرةٍ في بناءٍ مستقلٍّ قد أوصِدَ بابهُ بمفتاحٍ مُغلِقٍ، وقد كان فيه من السِّعة لو افْتُتِحَ للنَّاس لكان أصلح لهم في تحفيظِ نفرٍ من الصِّبيان القرآن. فلا تزال هذه المدنُ باسطةً جناح العلم على رؤوسِ المريدين، وعاقدةً إليهم بحزام أولي الألباب من الأولياء المنسيِّين، الذين اصطبَروا أنفُسَهُمْ إليها على ما ضاق من المسالكِ، بغية إصابة حقائق الممالك.
ولقد جمعت فاسُ بجانبين منها بلدين أوَّل أمرِها؛ الأندلس والقيروان، فسمَّيتا بالعدوتين؛ عُدوة الأندلسيِّين وعدوة القيروانيِّين، وقد شيَّدهما عام 192 هـ- 808 م إدريسُ الأصغر نعَّم الله روحَه برحمته الواسعة، وذلك لمَّا توافد عليه هؤلاء، فأراد تيسيرَ حالهم، وجمعَ أهاليهم، وإكرامَ وفادتهم، فجعل لهم مدينة فاس مقامًا كريما وأرضًا تطيبُ لأوَّلهم وآخرهم.
وهلِ الفتحُ أن تفتِّشَ في قوارع الطَّريق عن مُؤدَّى إلى موصِلكَ دون حاجةٍ مكلِفَةٍ إلى ذلك أو أتعابٍ مُتلفة، أم أن تُعينَ القدمَ على اكتشافِ الطَّريق الذي اختفت فيه مريرتُه، بعدَ أنْ جَسَتْ غَضيرَتُهُ وتبيَّنت وَتيرتُهُ ؟
إنَّ هذه الطَّريق التي استوت بين شرقٍ وغرب وجنوبٍ وشمال، وبين بحر وصحراء وتلٍّ وجبال، قد ضاعت بعد سقوط غرناطة، فتقطَّعت السُّبُلُ بين الرِّباط والجزائر وتونس، وبين طنجة ووهران وبنزرت، وبين فاس وتلمسان والقيروان، وانفلتت عرى الأسباب بين مراكش وغرداية وجربة، ولم تبق من هذه المدنِ إلا الأسماءُ نعرفها كما كانت تعرفها الجمالُ وهي تقود القوافل في الصَّحراء.
وإنَّ تعبيد الطَّريق من جديد بينها لَهُوَ أسهلُ ممَّا وجدَهُ عليه الأسلافُ، ومما تداولت عليه بينهم الأعراف، فليس من حاجة إلَّا إلى عقدِ نيَّة لمِّ شملِ الذين فرَّقتهم الهزيمة، وشدِّ بذلك إزارِ العزيمة، والمضيِّ في ضمِّ ما تشتَّت من الصِّدامات العاطلة، وتناثرَ من الدَّعاوى الباطلة.
وأستذكِرُ تلك الطَّريق وأنا فتًى، إذ لم تكُن لدينا إلَّا ما يتَّسعُ لرِجْلٍٍ واحدَةٍ حتَّى نصل بيتنا القصيَّ في مزرعتنا ببضرابين، وقد كان واجبًا علينا بعد كلِّ حرثٍ للأرض فصلَ الخريفِ، أن نمشي على التُّراب لعدَّة أيَّام حتَّى يتعبَّد بأقدامنا الطَّريق، ويهون أمامنا الطِّين الرَّقيق، وكان يقتضي ذلك منَّا أسبوعين، فنسمِّي ذلك بالمريرة.
وما أصعب رسمها في بداياتها، فلقد كانت القدمُ تتلكَّأ بين جانبينِ موحِلَينِ أحمرين، وترتطمُ بالكومات على جهتين اثْنَتين، فيصيرُ المشيُ فاترًا، والخاطرُ نافرًا، إلى أن يَستبِدَّ الحَذْوُ بالأرض فتتَّضحُ حوافُّها الجدعاءُ حتَّى ترى الجُعْل عابرًا أمامك بينها كسيزيفٍ مقلوب، والزُّخاليَّاتِ كأنَّها عرباتٌ موعودَةٌ بحمرةٍ كاللَّهب.
ثمَّ ترى الأرضَ تهتزُّ بعد ارتفاع سنابلِها فتخضَرُّ، فتنتشر بين أحشائها بقعٌ من اليعضيدِ ذي اللَّون الفاقع، والأقحوان المنثور كمسكٍ لونُها المرمريّ الناصع، وبعد حُوَّةِ اخْضِرارِهَا تصفَرُّ، ثم بعد اصْفِرارِها يُجَزُّ حبُّ البُرِّ المحصود، حتى يصير عَصْفُهُ على عَصْفٍ في تبنٍ منضود.
فكأنَّما بين هذه العناصر التي تختلف باختلاف القادمِ والبائد، وبين هذه الأركان التي تأتلف فيها المشاهد، يكاد معدن الطَّريق لا يتغيَّر برفع القدمِ وخفضِها، إنَّما الذي يغيِّره اجتثاثُ الأتربةِ من أرضِهَا، فتعود الأقدام إلى سالفِ مَهْدِها و سابق عهدها. لكنَّ الطَّريقَ بعد حرثه الثَّاني لا يكونُ إلَّا يَسيرَ التَّعبيد، وسهلَ التَّجْديد، كأنَّما قد ألِفَ منْشأهُ بما كان عليه، ثمَّ اسْتَجْمَعَ موطئَهُ لِما صار إليه.
وليست المشاهدُ إلا ما مرَّ على شمال إفريقيا من بلاء التَّاريخ، وسطْوَة الفرقةِ، وجبروت الأنفس الحاقدة، فعزَّت الأركانُ، وتعالتِ الأقدامُ على أن تضعَ موضعَ خطوِها في الأرضِ لرسمٍ جديد.
والعودةُ إلى القيروان إنَّما هي من هذا الأمر، فلا يأبه لها من أرخى في نفسِه عنوةً مطالَ النِّسيان ، ومكَّن في الذَّات من جُحُودها بالنُّكران، إنَّما تُؤتَى خالصةً للمدينِ بنفسه للتَّاريخ والحاضر والمستقبل. ولقد حظيتُ ورفيقي الكنزي بوجود قيس العامريّ معنا، وهو الذي قضينا معه ظهيرة بأكملها نستنجدُ بالتَّاريخ لولوجِ الرُّسوم بعد أن ناءَ زئيرُها واستتبَّ زفيرُها، فأخذنا إلى قلب المدينة القديمة حيث هندسةُ المدينة معلَّقةٌ على الجدار في شكل لوحة تفسيريَّة لطريقة بنائها.
وبينما تُحيطُ المنازل ذات الجدران العالية بالجامعِ الذي يظهرُ في قلب المدينة عظيمًا من جهاتِه الثَّلاث، فتنظرُ إليه كأنَّه يجذِبُها نحوَهُ جذبَ العيونِ لعاشقها، ثمَّ تمدُّ بفضل رسوم دروبِها بيدٍ خالصةٍ تُطيع له بالأمر والولاء، نرى صومعتَهُ المهيبة تُطلُّ على جبَّانةٍ بأجداثٍ اِبيضَّت كأقحوانٍ ملتئمٍ في جرَّة خضراء، فتبدو كأنَّها حارسةٌ على الأحياء والأموات معًا.
وإذا كان جامعُ القيروان هو أوَّل البيوت، وأوسطُ الثَّلاث، ورابعُ الجهات، فإنَّه في كلِّ ناحيةٍ من الدُّروب، يقومُ مسجدٌ في طرفِ العينِ التي إذا ابتدأت دربًا، رأتهُ بآخرِهِ، وإذا عاجَت ربضًا ألْفَتْهُ في سائِرِهِ، جُوَيْمِعَاتٌ تكادُ لا تَقدرُ على ضمِّ أكثر من مئة رَجُلٍ، تستقرُّ بين زواياها ووسطَها أعمدةٌ أوتِي بها من قرطاج وروما والقسطنطينيَّة، ولا نقصد ههنا العواصم، إنَّما نقصدُ ما أنشأتهُ فجلبَ النَّاسُ منها ما قامت بها حضارتُهم، واستقَرَّت به سياسَتُهُم، وهل يوجدُ أعمق من الأعمدة الجاسيات رمزًا وأبعدها دلالةً عندما نرى بالعين الشَّاهدة حتَّى اليوم أولئكَ الذي بنوا مساجدهم بغير أعمدةٍ صنعوها، ورفعوا مآذن بغير حجارة نحتوها، فلكأنَّهم لم يتوانَوْا عنْ شيءٍ تنشُصُ به كالغيم رؤوسُهُم وتعزُّ به في الفضلِ نفوسُهُم إلا أخَذُوا به أخذَ اقتدار، دون ملامةٍ أو اعْتذار.
وإذا كان الإسلام لم يحمل من عمدِ شمال إفريقيا سوى ما استقرَّ فيها من القوَّة والحكمةِ والسَّندِ، بقوَّة الأرض التي حملته، وصبر التِّلال التي أسندته، فإنَّ لا أحد يستطيع أن يتصوَّر كيف جيئ بالأعمدة من مدنٍ بعيدةٍ ولا يستطيع على حملها آنذاك حامل، إن لم يكن قد وُجدت بالقيروان مدينة رومانيَّةٌ أو بمحاذاتها، ولقد رأيت على أحد أعمدة جامع عقبة بن نافع صليبا منقوشًا على عمود، وأغلب الظَّنِّ أن يكون قد أوتي به من معبدٍ مسيحيٍّ قريب. ويقول البكري، إنَّ حسّان قد هدم جامع عقبة إلا المحراب، وبناه وحمل إليه السَّاريتين الحمراوين الموشّاتين بصفرة (...) لم ير الرّاءون مثلهما، من كنيسة كانت للأوّل في الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق الضرب. ويقولون إنّ صاحب القسطنطينية بذل لهم فيهما قبل نقلهما إلى الجامع زنتهما ذهبا، فابتدروا الجامع بهما. ويذكر كلّ من رآهما أنّه لم ير في البلاد ما يقترن بهما.
وتلفُّ هذه القصَّة كثيرٌ من الأساطير والخرافات، فالبكري قد وضع هذا الخبر أو نقله من مصدرٍ كان يريد استبعاد خطر الفاطميِّين من أن يسارعوا إلى مسجد القيروان فيهدِّموه، فنقلوا أخبارا واهيةً تزيدُ من هيبته رهبا، وتجهل قيمة محرابه بزنة ساريتيهِ ذهبًا. وفي هذه القصَّة ما يمنحنا سندًا في حلِّ مشكلاتِ الامكنة، وتحديد ما بينها من مسافات وأزمنة، فلطالما تكون الازمنة بمسافاتها دليلا مشتملا على الأمكنة ومزاراتها ، فمسافة ذهاب الخبر إلى القسطنطينيَّة وإيابه المحسوم هي نفسها ما تقتضيه عندما تُجلب السَّاريتان إلى الجامع من الموضع المزعوم.
ويكاد يضطربُ العقلُ عندما يرى في مساجد المسلمين مثل صليبٍ في عمود، وهو أمرٌ توارثه العربُ بمجيئهم لمَّا أخذوا من المسيحيِّين جَلَدَهُمْ وصَبرَهُم، ولقد سمعت في ملتقى بإشبيلية أنطونيو بيلايز روفيرا، وهو أستاذٌ بجامعة غرناطة يتعجَّبُ وهو يلقي محاضرته عن أصل الورق واستخدامه في مملكة غرناطة النَّصرية قائلاً إنَّ بعض نسخ القرآن يظهر على طرف صفحاتها المقدودة من ورقٍ جنويٍّ صليبٌ، وهو يَعُدُّ هذا تناقضًا في رأيه، فكيف يقبلُ المسلمون بقراءة القرآن على ورقٍ توشِّحُ أعلاهُ علامة التَّثليث. وفي الواقع، لم ينتبه أنطونيو بيلايز روفيرا إلى أنَّ المسلم باستطاعته إقامة صلاته بالكنيسة إن تطلَّب الأمرُ، ولو كانت كلُّها تماثيل وصلبان.
ولعلَّ مساجد تونس أكثر المعابد بأقاليم شمال إفريقيا من ضمَّت إليها بيُسرٍ عجيب بقايا ثقافة كان وجهها مكِبًّا على الاندثار، فهاهو جامع الزَّيتونة قد اختلَفَ النَّاسُ في تسميتِه، فمنهم من قال إنه كان على ربوة فيها زيتون، ومنهم من قال إنَّه كان كنيسةً ضمَّت ضريح القدِّيسة أوليفيا، وأوليفيا تعني بالعربيَّة الزَّيتونة. وإنَّني إذ أرجِّح التَّأويل الثَّاني، فإنَّني أستبعد أن يكون معبد توناس عامرًا بشجر الزَّيتون، فالبناء الرُّوماني يستبعدُ الشَّجر وسط ساحات المعابد وما جاورها اتِّقاءً لشرِّ الحروب الخادعة والرَّزايا التي إذا نزلت لا توفي أحدًا بحصَّةِ الفرار منها.
ومن الجوامع من كان قديمًا مشكاة للتَّعليم الدِّيني الرُّوحي، إذ أُسِّست على شكلِ زوايا لتدريس القرآن، وللأسف، فقد هذا النَّوع من البناء دوره الفلسفي في العودة بالمجتمعات إلى سابق العهد بالرُّوحانيَّات، والأدلُّ على ذلك والبيِّن فيه فراغُه من المرتادين والمريدين، وبيانُه عن الدَّور المنوطِ بها في الزَّمان القديم. وتستحقُّ هذه الدُّور أن تكون في وقتنا الحاضر محجًّا عالميًّا للدِّراسات الدِّينيَّة الثِّيُولوجيَّة. ففي زمن الرَّقميَّات، تتحوَّل هذه المعابد والزَّوايا إلى مراكز للبحث في الدِّراسات المغاربيَّة والإفريقيَّة والمتوسِّطيَّة أوَّلاً والعالميَّة ثانيًا، وورشات لإقامة الكتَّاب واشتغال المؤلِّفين، وفضاء لتشجيع التَّرجمات الدِّينيَّة إلى لغاتٍ عدَّة، ومعاهد منفتحة على التَّواصل مع تراث العلماء الدِّينيِّين العالمِيِّين وجديدهم لاسيما مع أولئك الذين لهم في الاسلام الغربي فضلٌ في الذَّهابِ بفكره إلى أبعاد صوفيَّة وروحانيَّة جديدة كما هو الحال مع روني غونون وغيره.
ولقد عرفت مراكش هذا النَّوع من تحويل البيوت التَّقليديَّة إلى بيوتٍ لإقامة الكتاب، كما هو الحال مع رياض دونيز ماسون الذي تمَّ تحويله إلى فضاء لدراسات الأديان المقارنة. ولقد عقدتُ في دونيز ماسون كتابًا ظهرت لي فيه الأهميَّة التي ينبغي أن يحظى بها هذا النَّوع من المدن التَّاريخيَّة في تنشيط الحركة العالميَّة للدِّراسات الدِّينيَّة.
ولزاوية سيدي عبيد الغرياني أن تعطي مثل هذا النَّظر؛ ففيه بعدان، ظاهريٌّ كما هو محرابها القائمُ ببهوٍ مفتوحٍ على الشَّمس، وباطنيٌّ كم هو محرابُها الثَّاني القائمُ بقاعةٍ في الجهة المغطَّاة. وما دامت أعمدتُه قائمةٌ في صلابة الرُّخام، وتيجانُهُ ثابتةٌ على المقام، فإنَّها قادرة على تجاوز محنتها وإعادة بعث ماء الحياة بسحنتها.
بدأ العطشُ يدبُّ في نفس الكنزي وفي نفسي، فاستكنَّا في المقهى المقابل إلى جرعةٍ باردةٍ ذكَّرتني بقريتي ببضرابين التي أنعم الله عليها ببئرٍ عجيبةٍ بمدخلها، بجنب الولِّيِّ سيدي عبد القادر، فقد كنَّا، تيمُّنا بالبرودة أيَّامَ القيظ، نتزاحم والنَّحل العطِشُ تلك الـحنفيَّات الثَّلاث التي لم تنقطع يومًا. استلقيت أعلى الشُّرفة على الأريكة، مقابل زاوية سيدي عبيد الغرياني، وألوانُ العلَّاني كطير أبابيل تتخطَّف الأرواح من بين غُرَزِ بساطه المفروشِ للبيع.