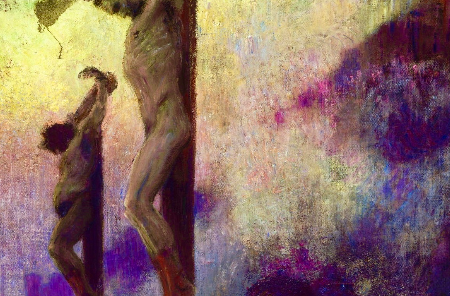أي مفارقة أن يظهر تحت هذه اليافطات الشنيعة شعب صغير كالشعب الإيزيدي عاش عزلة تاريخية كبرى، محاطاً بجيران عرب وأكراد وفرس وأتراك ارتكبوا مجازر أخرى بحقه! لم يذكر شيء عن الساسة الذين أجرموا بحق الإيزيديين ولا يُسمّى أيّ مجرم منهم بالاسم، فهذا أمر خارج السياق بالضرورة.
لجنة نوبل التي حجبت جائزة الآداب هذه السنة بعد فضائح الاغتصاب كرّمتْ مغتصَبة من الشرق الأوسط وطبيباً عالج مغتصَبات في أفريقيا. أعلم أن صفة "مغتصبة" العارية وقحة هنا، ولكن "سبيّة إيزيدية سابقة لدى داعش" هو التعريف الذي تناله ناديا مراد في عناوين الأنباء، ولا أحسبه قد اختارته بنفسها، مشفوعاً بمديح الشجاعة والتنويه بالفظاعات التي شهدتها. أليس مثل هذا التكريم شكلاً آخر من الهوان، وربما جائزة لداعش أيضاً؟ امرأة باسلة وطبيب جسور غيور ينالان شرف جائزة نوبل للسلام. ألا يحسّ الضحايا المكرّمون، أي ضحية على منصة أي تكريم، إنهم مستغلون أو مستخدمون كشخوص الدعايات؟ ألا يتضمن أي تكريم من هذا القبيل وجهاً فاجراً، سافراً أو مضمراً؟ أهكذا يخلق النجوم المهانون الذين لا مفرّ أمامهم من الدونية، والأيدي التي ساهمت في مصيبتهم تحوّل وصمتهم إلى وسام يُرفع أمام العدسات قبل تعليقه إلى صدر النائب العام للضحايا؟
سيبزغ النواب الناطقون باسم الضحايا العاجزين عن الكلام، ويجوبون العالم كسفراء الشجاعة والجرأة ومواجهة الذات والوقوف في وجه الشرّ، في الحفل التنكري الكبير على هذا الكوكب، حيث يظهر زعماء العالم في الأمم المتحدة وهم يخطبون أمام عدسات التاريخ كجنود أبرار منشقين عن جيش هولاكو. ألم تكن الكرامة تقتضي أن تبقى آلام الناس عالية بعيداً عن هذا الحضيض فيُشار إليها كثلوج لن تذوب عن قمم الجبال في أرض كردستان أو أي بلاد أخرى؟
كنتُ أتساءل غير مرة، خلال السنين الماضية، هل يشعر المُكرّمون من دول العالم الثالث بشيء من الإهانة والانتقاص عند تكريمهم في دول العالم الأوّل، أياً كان هذا التكريم بجائزة كبرى أو صغرى، ومهما كان نصيبهم من الأضواء وافراً أو شحيحاً، في هولندا أو ألمانيا أو فرنسا أو إنكلترا أو السويد أو أمريكا، فيصعد إلى منصة الشرف مصوّر شجاع أو كاتب شجاع أو مناضل شجاع أو مخرج شجاع؟ أليست هناك قسوة مضاعفة حين يبقى التعريف الأول لكاتبٍ ما، على سبيل المثال، إنه سجين سياسي سابق؟ أسوق هذا المثال لأقول إن من يعطي هذه الهوية المبتسرة للضحايا هم غالباً الأطراف الأقوى وأصحاب النفوذ، وإن المجرمين، بطريقة أو بأخرى، يرسمون حدود اللعبة ويحددون أدوار الضحايا على مسرح العالم. هكذا يكون الوجه الآخر لتكريم نادية مراد هو إدانة داعش التي ستبقى تحت الضوء ما دام ضحاياها على قيد الحياة، وهو كذلك تكريم الغرب لنفسه بعد الحملات العالمية المناهضة للعنف الجنسي، وتأكيد على ريادته في المساواة بين الرجل والمرأة، وخصوصاً الدول الإسكندنافية.
أي مفارقة أن يظهر تحت هذه اليافطات الشنيعة شعب صغير كالشعب الإيزيدي عاش عزلة تاريخية كبرى، محاطاً بجيران عرب وأكراد وفرس وأتراك ارتكبوا مجازر أخرى بحقه! لم يذكر شيء عن الساسة الذين أجرموا بحق الإيزيديين ولا يُسمّى أيّ مجرم منهم بالاسم، فهذا أمر خارج السياق بالضرورة. يكرم ضحايا "داعش" ولا شيء جدياً يُذكر عن التسهيلات التي قدّمها أمثال أردوغان أو حكومة العراق. استقبلت ألمانيا عدداً كبيراً من الإيزيديين المضطهدين، فهي لم تتوقف عن بيع الأسلحة إلى المجرمين ثم احتضان الإيزيديين الناجين من المذابح. ألمانيا في الواقع إحدى الدول البارعة في التكفير عن ذنوبها، ولا تزال تكفّر عن ذنوبها في إسرائيل التي زارتها نادية مراد وتكلّمت في الكنيست أمام أبناء وأحفاد ضحايا نجوا من المحرقة النازية. المصيبة هي أن الضحايا يتعامون أحياناً ولا يشعرون بآلام غيرهم من الضحايا. العكس صحيح في أحيان كثيرة، فقد تضطهد الضحية ضحية أخرى وتنكّل بها بالأشكال كافّة.
لم أقصد ثقافة التهنئة والاحتفاء والافتخار لأن شابّة "كردية" نالت جائزة رفيعة، وبالطبع لا أعني إشادة دونالد ترامب بشجاعة الأكراد وشهامتهم. متذكّراً الأمّ اليهودية التي كتب عنها فيليب روث ساخراً وتخيّل افتخارها بظهور صورة ابنها على غلاف مجلة "تايم"، كنتُ أقصد كيف يتم تحويل الألم إلى موضوع دبلوماسي أو درس في التربية، وتنصيب المتألم كقدوة أو رمز أو نموذج يحتذى ليكون صوت المظلومين ويقف إلى جوار سفراء وسفيرات النوايا الحسنة وملكات الجمال وممثلات هوليود مثل أنجيلينا جولي التي لم تبخل بزيارة مخيمات اللاجئين. هذه الطريقة في التقريب بين الشعوب عبر الجوائز، ومضاعفة الانتباه إلى محنةٍ هنا أو محنة هناك من هذا العالم، لا تختلف في شيء عن نهج الدعايات، والضوء الذي تسلطه على المصائب ليرى الغافلون وجهَ الحقيقة البشع لا يختلف عن الضوء الذي تسلطه نشرة أخبار أو إعلان تجاري على وجوه مسافرين في قاعة انتظار لن يلبثوا أن ينسوا ما شاهدوه. ألا نقرأ، هنا أو هناك، في الجرائد ومواقع التلفزيون، عن اللاجئة الأشهر التي نصّبوها واحدة من الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم؟ إذا نظرنا إلى أمثلة أخرى كرّمتها نوبل السلام، لرأينا كيف سوّقتهم الآلة الجهنمية لصناعة النجوم، شجعانَ موصومين بتجاربهم المرعبة، وصولاً إلى إعاقة سعيهم نحو العدالة التي ينشدونها وربما إفسادهم وابتذالهم وتفريغهم من قوّتهم الأخلاقية.
شُبّهت ناديا مراد بـ "الوردة". يُعيدني هذا التشبيه إلى عشق الورود الذي جمع بين سيدة أولى كردية وسيدة أولى فرنسية، وأعني هيرو طالباني ودانييل ميتران "أمّ الأكراد". لنبقى في فرنسا التي عيّن رئيسها الشابّ كاتبة شابّة مغربية الأصل "سفيرة للفرانكوفونية" (وقد يعيدنا هذا، رغم التباعد الشديد بين الأمثلة، إلى خرافة الشباب في حكم "الرئيس الشابّ" بشار الأسد، أو الخرافة المضادة التي روّجتها قنوات إعلامية كالجزيرة وشقيقاتها لتقديم "الربيع العربي" بوصفه ثورة شباب أولاً). سوف أذكر مثالاً فرنسياً من عالم الأدب:
كتب غايل فاي رواية "بلد صغير" عن ذكريات طفولته أثناء مذابح رواندا ونال جوائز في فرنسا، ولم يكد يستحضر الإعلام دور فرانسوا ميتران في تلك الإبادة، الرئيس المثقف وأحد العاملين في حكومة فيشي الذين انقلبوا في اللحظات الأخيرة إلى صفوف المقاومة ضد النازيين. جوليان غراك رفض دعوة عشاء شخصية مع ميتران ثلاث مرات، ورفض جائزة الغونكور، وعمل معلماً للتاريخ والجغرافية في مدارس باريس عشرين عاماً، ولم يعرّفه أحد بأنه جندي سابق اعتقل في معسكر ألماني للجنود الأسرى خلال الحرب العالمية الأولى. أعلم أن مثل هذا الرفض في منتهى الصعوبة، وقلةٌ يرونه صائباً، بل قد يُرى تطرّفاً مجانياً وسخفاً واستعراضاً أو حتى حسداً. سأختم بما قاله رونيه شار في "أوراق هيبنوس": "القبول يضيء الوجه. الرفض يزيده بهاء".