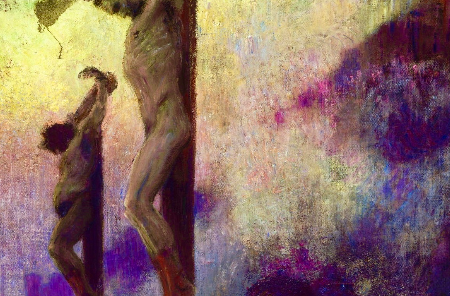صحيح أنّه لا يمكن الفصل بين السياسيّ والأديب في حالة إميل حبيبي تحديدًا، فقد حمل البطيختين بقوّة طيلة حياته، كما أنّه لا يمكننا عمومًا تجاوز تأثير السياسة، بكونها فكرًا وموقفًا من الشأن العام ونسقًا قيميّا وعلاقات قوة وسيطرة وسرديات، على الأدب كتعبير عن التجربة الفرديّة والجماعيّة ومحاولة لإعادة صياغة الوعي والذاكرة في سياق محدّد. إلا أنّ عدم الفصل بينهما، عليه أن لا يمنع منا أن نحمل كل بطيخة من بطيخات إميل لوحدها ونتأمل في تفاصيل تشعباتها، ونشمّ رائحة التراب التي نبتت جذورها فيه، قبل أن نعيدها إليه.
في نهاية روايته الأخيرة، أو للدقة "خرّافيته" الأخيرة، «سرايا بنت الغول»، أو للدقة أكثر وأكثر في نهاية فصول حياته الشخصيّة، وصل الكاتب إميل حبيبي إلى نتيجة أذهلته، نتيجة تُناقِض نهجَ حياته كلّها، من حيث اعتقاده السابق أنّه من الممكن "حمل بطيختين بيدٍ واحدة: أي الانشغال بالسياسة والانشغال بالأدب"، قال هذا ودخل إلى صومعة النهاية، ذات القبة الزجاجيّة، يراجع تجربته بعد انهيار عالمه الفكريّ، منتظرًا أن يردوا له “سرايا”، أي حبّه للأدب والإبداع بصدق وسذاجة، التي أهملها بعد أن اختطفها منه غول الحياة السياسيّة الحزبيّة الصاخبة وما فيها من كذب وقسوة ووسخ، كما وصفها، وتساءل: “هل نقبل عذرًا لشجرة إجاصٍ أثمرت باذنجانًا أنّها توفّر للفقراء “لحم الفقراء”؟”.
“ليس مصادفة أنّ شجرة الإجاص موجودة”، يقول إميل حبيبي في مقابلة أعادت نشرها مؤخرًا مجلة الدراسات الفلسطينيّة، ويضيف “صحيح أنّ الباذنجان أهمّ للحياة، لكن الإجاص ضروري أيضًا. أنا لا أفصل السياسيّ عن الثقافيّ”.
صحيح أنّه لا يمكن الفصل بين السياسيّ والأديب في حالة إميل حبيبي تحديدًا، فقد حمل البطيختين بقوّة طيلة حياته، كما أنّه لا يمكننا عمومًا تجاوز تأثير السياسة، بكونها فكرًا وموقفًا من الشأن العام ونسقًا قيميّا وعلاقات قوة وسيطرة وسرديات، على الأدب كتعبير عن التجربة الفرديّة والجماعيّة ومحاولة لإعادة صياغة الوعي والذاكرة في سياق محدّد. إلا أنّ عدم الفصل بينهما، عليه أن لا يمنع منا أن نحمل كل بطيخة من بطيخات إميل لوحدها ونتأمل في تفاصيل تشعباتها، ونشمّ رائحة التراب التي نبتت جذورها فيه، قبل أن نعيدها إليه.
وللصراحة، فإنّ ما دفعني إلى هذه الاستعارة هو حاجتي للبحث الجادّ عن مكمن القيمة الأدبيّة والفنيّة التي أعطت مكانة خاصة لنتاج إميل حبيبي في الأدب العربيّ المعاصر، حيث أنّه من أهمّ أدبائنا العرب والفلسطينيّين، بعيدًا عن كلّ الجدل الصاخب حوله دوره ومواقفه وخلافاته كقائد سياسيّ حزبيّ وكتاباته الصحفيّة اللاذعة ضد خصومه، وبعيدًا عن الأوصاف المألوفة حول "المتشائل"، إذ كان لدي دومًا انطباع أنّ أمر هذه المكانة الأدبيّة لا يرتكز أساسًا إلى المضمون السياسيّ والإيدلوجيّ لهذا النتاج، ولا حتى خصوصية السياق، سياق "الباقين في وطنهم”، فلم يكن قلمًا وحيدًا في عصره هنا، في الأرض المحتلة، كما نعلم جميعًا، بل اعتقد، إلى حدٍ معيّن، أنّه نال المكانة الأدبيّة عربيًا رغمًا عن هذا كله. وهنا أوافق الرأي الذي يرى بأنّ أسلوب السرد الخاص الذي صاغه حبيبي لنفسه، المعتمد على التراث الأدبيّ العربيّ القديم، ببلاغته وسحره، والحكايات الشعبيّة وعلى أسلوب السرد الشفويّ، وأثر أصحاب البيان القدماء في لغته وسخريته، مكمن قيمته، ومصدر قوته، وهو ما ميّزه في فترته.
ففي المقابلة التي نشرتها “رمّان”، يقول حبيبي: “وإذا أردت أن أشدّد على ناحية أو مصدر أدبيّ فإنني أقول إنني تأثرت كثيرًا بالمقامات والأدب الهزلي الكلاسيكي العربي، أدب الكشاكيل… وأنا عندما أكتب أعمل كثيرًا في القواميس القديمة، قاموس الفيروز أبادي، وبعض الكتب كـ «العقد الفريد»، كما أنني أشعر بأن الجاحظ يشجعني على اختراع الكلمات”. ففي مقابل مدرسة “الواقعية الاشتراكية” الطاغي على “الرفاق” في العصبة، وعلى الحقبة، كانت لإميل حبيبي وجهة أخرى، فقد فتّش “عن أسلوب جديد في الأدب يتفق وإمكانية الاستيعاب الجماهيري العربي الخاص”، ويضيف “أما لجوئي للأدب الساخر فإنه يعود إلى أمرين: أرى في السخرية سلاحًا يحمي الذات من ضعفها. كما أرى فيها تعبيراً عن مأساة هي أكبر من أن يتحملها ضميري الإنساني. ولقد وجدت في التراث العربي معيناً لا ينضب في هذا المجال، وكم من أعمال عربية كلاسيكية لم يفهمها جيلنا باعتبارها أدبًا ساخرًا، وعلى رأس هذه الأعمال تأتي «رسالة الغفران»، للمعرّي، و«ألف ليلة وليلة»”.
وصحيح أنّ حبيبي كان مهتمًا بالمنجزات الأدبيّة العالميّة ويعترف بفضلها على كتابته وأهميتها لكل كاتب، لكنه لاحظ بأنّ “كثيرًا ما يتم نقل ميكانيكي لمكتسبات الآداب العالمية بما لا يتلاءم، لا مع أذواقنا الجماعية الخاصة، ولا مع الحاجة إلى الاستمرار في رفع مستوى هذه الأذواق. وبهذا يختلف الأدب عن بقية فروع المعرفة، من حيث أن علم الحساب هو علم الحساب في كل مكان، أما الأدب وبقية الفنون، فتظل في الأساس تعبيرًا عن خصوصية الإسهام الذي يقدمه شعب من الشعوب للتراث العالميّ. ومن هنا اهتمامي الخاص بلغتنا وأسلوبنا…من الواضح بالنسبة لي أن الأسلوب الأدبي هو الذي يميز الأدب عن غيره من الأعمال الكتابية، وأنا لا أسمح لنفسي بارتكاب أي خطأ في اللغة حين أكتب الأدب. وأسلوبنا معرض ونحن ومعرضون سياسيًا للتلوث، وإننا نعتز في بلادنا بأننا أسهمنا في منع مأساة شبيهة بمأساة شمالي أفريقيا (من حيث قضية إحلال لغة أخرى مكان لغتنا العربية)”.
فلنأخذ «سرايا بنت الغول»، بما أننا قد بدأنا بها، فهذا العمل استلهم بالأساس من حكاية شعبيّة فلسطينية، وهي تحكي، كما لخّصها حبيبي، عن فتاة قرويّة جميلة لم يمسّ المقصّ شعرها، وكانت فضوليّة، تذهب إلى الغابات والوديان تبحث عن الزهور وعن أعشاش الطيور، وكان هناك غولٌ يراقبها، ثمّ أحبها. ويبدو أنّ الناس في القرية كانوا يعرفون أمور هذا الحبّ. لهذا صارت الفتاة تسمى “سرايا بنت الغول”. وفي يومٍ من الأيام، خطبها الغول وبنى لها قصرًا من الذهب والبلور وحبسها فيه. وكان لها ابن عمٍ في مثل عمرها يحبها أيضًا. فراح يجول في الوديان وفي الجبال يبحث عنها وينادي: “سرايا يا بنت الغول، دَليلي شعرك لأطول”. وظلّ يبحث عنها حتى سمعته في أحد الأيام، فدلّت له جديلة شعرها، فتمسّك بها وصعد إليها في القصر وأنقذها.
وفي أحد فصول هذه “الخرّافية”، التي يكون مجرد إطلاق هذه التسمية عليها دلالة على سعي الراوي إلى صوغ أسلوب سرديّ أدبيّ يشبه أسلوب السرد الشفويّ، ففي فلسطين نقول “نتخرف” أي نحكي أو نتحدث، و”خرّافية” هي قصة مثيرة فيها قدر لا بأس به من التشويق والتأزم. وهو بسرده ينتقل، مثلما نفعل في جلساتنا، من “خرّافية” إلى أخرى ويستطرد و”يشطح” ثمّ يستعيد “الخرّافية” التي يدور “الخرّاف”، أي الحديث، الأساس حولها، وهو أسلوب يذكر، بنفس الوقت، بأسلوب سرد القصص في «ألف ليلة وليلة» مثلاً، فهناك قصص دخل قصص في إطار قصة محورية، كأنها أزقة مدينة عربية قديمة.
فمثلاً، في مطلع «سرايا بنت الغول»، كان الراوي، هاوي الصيد العجوز، يجلس على صخرة أهملها الصيادون الجادّون على شاطئ الزيب المهجرة، حين لم يفاجأ من ذلك “الشيء” الذي فاجأه بظله علـى البحر المضطرب! فيبدأ بالحديث عن مولده وعلاقته بالبحر وحيفا وصيد الأسماك، وقصة جرت معه حين انقضت عليه النوارس وبعدها الغربان بينما اصطاد السمك علـى شاطئ البحر الأسود. ثمّ ما يلبث يعود للظلّ، الذي ظنّه ظلّ سمكة قرش، فكان ظلّ جسم نحيل ضامر لصبية في مقتبل العمر تخطو نحوه فوق رمل الشاطئ بمشية مسحورة، خال أنّها تناديه: “يا يابا”. هرب من “الشيء” فزِعًا، وبعد سقوطه من على الدرجات الحجرية، على هضبة شاطئ الزيب، التي تنيرها الكشافات العسكريّة الدائرة، “وإذ بيدٍ تأخذ يدي وتسحبني وراءها شمالاً نحو مصب “وادي القرن”. وتصعد في الوادي وأنا أسير وراءها مأخوذًا”. عادت سرايا فأنقذته، ليعود إلى نفسه، ولو قبل النهاية بقليل. مدت لها شعره ليطول..نفسه.
في السطر الأخير من خطبة (مقدمة) رواية (خرّافية) «سرايا بنت الغول» يجيب إميل حبيبي، في الفصل الأخير من حياته، أجاب عن سؤاله أعلاه عن جرة الإجاص: “لقد وُلِدتْ لإطعامنا إجاصًا!” إنّ الإجاص الذي أثمرته شجرة إميل حبيبي فاكهة لذيذة الطعم والأسلوب، حتى لو لم نشتهي الباذنجان الذي أنبت.
“ليس مصادفة أنّ شجرة الإجاص موجودة”، يقول إميل حبيبي في مقابلة أعادت نشرها مؤخرًا مجلة الدراسات الفلسطينيّة، ويضيف “صحيح أنّ الباذنجان أهمّ للحياة، لكن الإجاص ضروري أيضًا. أنا لا أفصل السياسيّ عن الثقافيّ”.
صحيح أنّه لا يمكن الفصل بين السياسيّ والأديب في حالة إميل حبيبي تحديدًا، فقد حمل البطيختين بقوّة طيلة حياته، كما أنّه لا يمكننا عمومًا تجاوز تأثير السياسة، بكونها فكرًا وموقفًا من الشأن العام ونسقًا قيميّا وعلاقات قوة وسيطرة وسرديات، على الأدب كتعبير عن التجربة الفرديّة والجماعيّة ومحاولة لإعادة صياغة الوعي والذاكرة في سياق محدّد. إلا أنّ عدم الفصل بينهما، عليه أن لا يمنع منا أن نحمل كل بطيخة من بطيخات إميل لوحدها ونتأمل في تفاصيل تشعباتها، ونشمّ رائحة التراب التي نبتت جذورها فيه، قبل أن نعيدها إليه.
وللصراحة، فإنّ ما دفعني إلى هذه الاستعارة هو حاجتي للبحث الجادّ عن مكمن القيمة الأدبيّة والفنيّة التي أعطت مكانة خاصة لنتاج إميل حبيبي في الأدب العربيّ المعاصر، حيث أنّه من أهمّ أدبائنا العرب والفلسطينيّين، بعيدًا عن كلّ الجدل الصاخب حوله دوره ومواقفه وخلافاته كقائد سياسيّ حزبيّ وكتاباته الصحفيّة اللاذعة ضد خصومه، وبعيدًا عن الأوصاف المألوفة حول "المتشائل"، إذ كان لدي دومًا انطباع أنّ أمر هذه المكانة الأدبيّة لا يرتكز أساسًا إلى المضمون السياسيّ والإيدلوجيّ لهذا النتاج، ولا حتى خصوصية السياق، سياق "الباقين في وطنهم”، فلم يكن قلمًا وحيدًا في عصره هنا، في الأرض المحتلة، كما نعلم جميعًا، بل اعتقد، إلى حدٍ معيّن، أنّه نال المكانة الأدبيّة عربيًا رغمًا عن هذا كله. وهنا أوافق الرأي الذي يرى بأنّ أسلوب السرد الخاص الذي صاغه حبيبي لنفسه، المعتمد على التراث الأدبيّ العربيّ القديم، ببلاغته وسحره، والحكايات الشعبيّة وعلى أسلوب السرد الشفويّ، وأثر أصحاب البيان القدماء في لغته وسخريته، مكمن قيمته، ومصدر قوته، وهو ما ميّزه في فترته.
ففي المقابلة التي نشرتها “رمّان”، يقول حبيبي: “وإذا أردت أن أشدّد على ناحية أو مصدر أدبيّ فإنني أقول إنني تأثرت كثيرًا بالمقامات والأدب الهزلي الكلاسيكي العربي، أدب الكشاكيل… وأنا عندما أكتب أعمل كثيرًا في القواميس القديمة، قاموس الفيروز أبادي، وبعض الكتب كـ «العقد الفريد»، كما أنني أشعر بأن الجاحظ يشجعني على اختراع الكلمات”. ففي مقابل مدرسة “الواقعية الاشتراكية” الطاغي على “الرفاق” في العصبة، وعلى الحقبة، كانت لإميل حبيبي وجهة أخرى، فقد فتّش “عن أسلوب جديد في الأدب يتفق وإمكانية الاستيعاب الجماهيري العربي الخاص”، ويضيف “أما لجوئي للأدب الساخر فإنه يعود إلى أمرين: أرى في السخرية سلاحًا يحمي الذات من ضعفها. كما أرى فيها تعبيراً عن مأساة هي أكبر من أن يتحملها ضميري الإنساني. ولقد وجدت في التراث العربي معيناً لا ينضب في هذا المجال، وكم من أعمال عربية كلاسيكية لم يفهمها جيلنا باعتبارها أدبًا ساخرًا، وعلى رأس هذه الأعمال تأتي «رسالة الغفران»، للمعرّي، و«ألف ليلة وليلة»”.
وصحيح أنّ حبيبي كان مهتمًا بالمنجزات الأدبيّة العالميّة ويعترف بفضلها على كتابته وأهميتها لكل كاتب، لكنه لاحظ بأنّ “كثيرًا ما يتم نقل ميكانيكي لمكتسبات الآداب العالمية بما لا يتلاءم، لا مع أذواقنا الجماعية الخاصة، ولا مع الحاجة إلى الاستمرار في رفع مستوى هذه الأذواق. وبهذا يختلف الأدب عن بقية فروع المعرفة، من حيث أن علم الحساب هو علم الحساب في كل مكان، أما الأدب وبقية الفنون، فتظل في الأساس تعبيرًا عن خصوصية الإسهام الذي يقدمه شعب من الشعوب للتراث العالميّ. ومن هنا اهتمامي الخاص بلغتنا وأسلوبنا…من الواضح بالنسبة لي أن الأسلوب الأدبي هو الذي يميز الأدب عن غيره من الأعمال الكتابية، وأنا لا أسمح لنفسي بارتكاب أي خطأ في اللغة حين أكتب الأدب. وأسلوبنا معرض ونحن ومعرضون سياسيًا للتلوث، وإننا نعتز في بلادنا بأننا أسهمنا في منع مأساة شبيهة بمأساة شمالي أفريقيا (من حيث قضية إحلال لغة أخرى مكان لغتنا العربية)”.
فلنأخذ «سرايا بنت الغول»، بما أننا قد بدأنا بها، فهذا العمل استلهم بالأساس من حكاية شعبيّة فلسطينية، وهي تحكي، كما لخّصها حبيبي، عن فتاة قرويّة جميلة لم يمسّ المقصّ شعرها، وكانت فضوليّة، تذهب إلى الغابات والوديان تبحث عن الزهور وعن أعشاش الطيور، وكان هناك غولٌ يراقبها، ثمّ أحبها. ويبدو أنّ الناس في القرية كانوا يعرفون أمور هذا الحبّ. لهذا صارت الفتاة تسمى “سرايا بنت الغول”. وفي يومٍ من الأيام، خطبها الغول وبنى لها قصرًا من الذهب والبلور وحبسها فيه. وكان لها ابن عمٍ في مثل عمرها يحبها أيضًا. فراح يجول في الوديان وفي الجبال يبحث عنها وينادي: “سرايا يا بنت الغول، دَليلي شعرك لأطول”. وظلّ يبحث عنها حتى سمعته في أحد الأيام، فدلّت له جديلة شعرها، فتمسّك بها وصعد إليها في القصر وأنقذها.
وفي أحد فصول هذه “الخرّافية”، التي يكون مجرد إطلاق هذه التسمية عليها دلالة على سعي الراوي إلى صوغ أسلوب سرديّ أدبيّ يشبه أسلوب السرد الشفويّ، ففي فلسطين نقول “نتخرف” أي نحكي أو نتحدث، و”خرّافية” هي قصة مثيرة فيها قدر لا بأس به من التشويق والتأزم. وهو بسرده ينتقل، مثلما نفعل في جلساتنا، من “خرّافية” إلى أخرى ويستطرد و”يشطح” ثمّ يستعيد “الخرّافية” التي يدور “الخرّاف”، أي الحديث، الأساس حولها، وهو أسلوب يذكر، بنفس الوقت، بأسلوب سرد القصص في «ألف ليلة وليلة» مثلاً، فهناك قصص دخل قصص في إطار قصة محورية، كأنها أزقة مدينة عربية قديمة.
فمثلاً، في مطلع «سرايا بنت الغول»، كان الراوي، هاوي الصيد العجوز، يجلس على صخرة أهملها الصيادون الجادّون على شاطئ الزيب المهجرة، حين لم يفاجأ من ذلك “الشيء” الذي فاجأه بظله علـى البحر المضطرب! فيبدأ بالحديث عن مولده وعلاقته بالبحر وحيفا وصيد الأسماك، وقصة جرت معه حين انقضت عليه النوارس وبعدها الغربان بينما اصطاد السمك علـى شاطئ البحر الأسود. ثمّ ما يلبث يعود للظلّ، الذي ظنّه ظلّ سمكة قرش، فكان ظلّ جسم نحيل ضامر لصبية في مقتبل العمر تخطو نحوه فوق رمل الشاطئ بمشية مسحورة، خال أنّها تناديه: “يا يابا”. هرب من “الشيء” فزِعًا، وبعد سقوطه من على الدرجات الحجرية، على هضبة شاطئ الزيب، التي تنيرها الكشافات العسكريّة الدائرة، “وإذ بيدٍ تأخذ يدي وتسحبني وراءها شمالاً نحو مصب “وادي القرن”. وتصعد في الوادي وأنا أسير وراءها مأخوذًا”. عادت سرايا فأنقذته، ليعود إلى نفسه، ولو قبل النهاية بقليل. مدت لها شعره ليطول..نفسه.
في السطر الأخير من خطبة (مقدمة) رواية (خرّافية) «سرايا بنت الغول» يجيب إميل حبيبي، في الفصل الأخير من حياته، أجاب عن سؤاله أعلاه عن جرة الإجاص: “لقد وُلِدتْ لإطعامنا إجاصًا!” إنّ الإجاص الذي أثمرته شجرة إميل حبيبي فاكهة لذيذة الطعم والأسلوب، حتى لو لم نشتهي الباذنجان الذي أنبت.