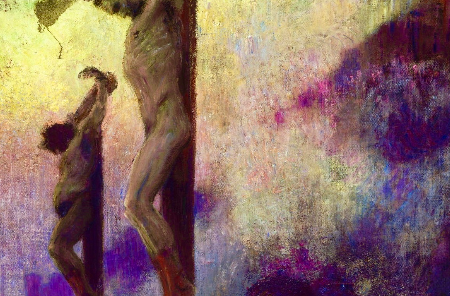من هذا المنطلق ينبغي إعادة بحث الدراسة المتعلقة بالذاكرة الإنسانية، فالأفلام الفلسطينية التي تتناول قضية الشعب الفلسطيني لم تعد عملية إنسانية تستفز العواطف لأطفال فلسطينيين يتنقلون في أروقة الأونروا أو أطفال يعيشون بعيداً عن وطنهم ويرسمون على الورق الطائرات الإسرائيلية وهي تلقي بنقاط من الحبر والألوان على مخيمات من الصفيح. إنها طائرات حقيقية من نوع الشبح والأف 16 والميراج المتطور تلقي بجحيمها علينا ونحن في لبنان نصورها ونعيشها جحيماً حقيقياً يثير الرعب مهما بلغ مستوى الشجاعة الإنسانية.
سينمائي وكاتب عراقي
على ضوء ما نُشر في صحيفة هآرتز الإسرائيلية بتاريخ الأول من شهر يوليو تموز 2017 عن العلب السينمائية الفلسطينية قياس ستة عشر ملمتراً والمحفوظة في مخزن تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والتي توضح المقالة أن الوثائق الفلسطينية المحفوظة في أرشيف "وزارة الدفاع" إنما هي "غنائم حرب" هذا يعني أن الوزارة الإسرائيلية ليست وزارة دفاع إنما هي وزارة حرب! ولذلك فإن علب الأفلام الفلسطينية هي غنائم حرب حين غزت الدولة العبرية الأراضي اللبنانية عام 1982! ومع أن المعلومات المنشورة في المقالة ناقصة كثيراً وتحتاج إلى بحث أكثر عمقاً لما ينبغي أن تتسم الدراسة بالموضوعية والشمولية، فإن الكاتب قد سلط الضوء على "بعض" الحقائق، سيما وأن المتحدثة في المقالة حسب معلوماتي تنتمي إلى اليسار الإسرائيلي. لذا أجد نفسي مضطراً لكي أعقب على المقال بما يخدم فكر اليسار الذي ينتمي إلى الحقيقة.
في الجانب المتعلق بالدولة العبرية، فإن مؤتمر بال – بازل في سويسرا الذي إنعقد في العام 1897 كان قد أوصى بضرورة إستثمار الصورة المتحركة لصالح ما سمي بالوطن القومي لليهود في فلسطين. وكانت الصورة المتحركة قد مضى على إختراعها ثلاث سنوات فقط، عام 1894، وعامان فقط على مشاهدة أول عرض سينمائي على الشاشة عام 1895. وهذا لا شك ينم على فطنة يهودية إتسم بها اليهود، ويتسم بها الفلسطينيون أيضاً، فإنهم عاشوا تاريخاً واحداً وأرضاً واحدة ومناخاً واحداً، وزيتوناً واحداً. لكن اليهود أهتموا بالمال إضافة إلى الميديا، وكانوا أوفياء لـ "ثيودور هرتزل" في نصيحته في مؤتمر بال بسويسرا، في إستثمار الصورة المتحركة لصالح ما سمي بالوطن القومي لليهود، ونصيحته في إستثمار السيولة النقدية لتحقيق هذا الهدف. فهيمن اليهود على المصارف، وكازينوهات القمار وملاعب الرياضة والمزادات العلنية للمقتنيات واللوحات، وتمكنوا من إمتلاك ناصية العالم. واليوم يلاحظ أن كل الجرائم التي نفذتها الدولة العبرية بحق الإنسانية وبحق الفلسطينيين، يتم غطاؤها إعلامياً عن طريق بث كل شاشات القنوات الفضائية للجرائم النازية بحق اليهود وأفران الإبادة بعد الحرب العالمية الثانية. يجري هذا بعد كل عدوان على غزة، بعد كل إغتيال سياسي، بعد مجازر كفر قاسم ومجازر صبرا وشاتيلا وبعد الإعتداء على الجنوب اللبناني وبعد كل الحروب الإسرائيلية ضد العرب. لتسارع كل وسائل الإعلام التي تهيمن عليها الدولة العبرية إلى بث مجازر حرق اليهود بأفران الغاز، بعد الحرب العالمية الثانية، من قبل النازية الألمانية.
لا شك أن الجرائم النازية ضد اليهود هي جرائم يندى لها جبين الإنسانية. وأنا أقف ضدها وضد النازية في عملية الإبادة الجماعية، مع أن الوسائل الإعلامية التي جسدت تلك الجرائم قد بالغت كثيراً، فأنتجت آلاف الأفلام الروائية والوثائقية عن تلك الحقبة المخجلة في التاريخ الإنساني، ولكن في المقابل فإن الشاشات التي تجسد تلك الجرائم تعزف عن بث شريط وثائقي قصير عن مجزرة ضد الفلسطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا، في بيوت من الصفيح يتم نحر ألف وخمسمائة إنسان بريء جلهم من الشيوخ والأطفال والنساء من الفلسطينيين واللبنانيين الذين يتقاسمون السكن في تلك المخيمات البسيطة، كما تعزف شاشات التلفزة العالمية عن بث شريط واحد عن تدمير كل بيوت الناس في الجنوب اللبناني، وفي حروب وزارة "الدفاع – الحرب" التابعة للدولة العبرية.
لم تكن ألمانيا تملك حينها ذلك العدد من الكاميرات السينمائية التي تنشرها في كل زاوية وفي كل شارع وبيت ونفق وساحة، وتنصبها على متن كل طائرة عسكرية، لذلك فإن توثيق تلك الجرائم بحق اليهود وما شاهدناه في الأفلام الوثائقية هو غير دقيق وينطوي على تظليل إعلامي وتزييف بصدد المبالغة لتجسيد تلك الجرائم وإبتزاز عواطف الرأي العام العالمي، لما تمتلكه الصورة المتحركة من التأثير السيكولوجي والفيزيائي على المتلقي. فعمدت وسائل الإعلام الصهيونية على إستدعاء مخرج أفلام الرعب ألفريد هتشكوك على فبركة مشاهد مخيفة "بصيغة وثائقية" وليست روائية وبمادة فلمية تدخل في مخابر الأفلام لتحويلها إلى أفلام تبدو قديمة ومستهلكة توحي بالماضي، وتُعرض على أنها حقائق موضوعية داخل أنفاق يقتاد فيها اليهود إلى الأفران الحارقة أو مقاصل الإعدام. وهذا ما أشارت له بعض الصحف الألمانية، وقد شاهدت نماذج من هذه الأفلام أو بالأحرى الوثائق التي تحولت إلى أفلام، وأنا كمخرج سينمائي أستطيع أن أرقب بدقة مدى صدق الوثيقة وواقعيتها.
ومن أجل كشف الحقائق الموضوعية لما جرى من نهب الأفلام وإعتبارها "غنائم حرب" فإني نفذت فيلماً وثائقياً أسميته «الهوية الفلسطينية» بعد أن غزت الدولة العبرية لبنان عام 1982 ودخلت عاصمتها بيروت. بل وإستباحتها وإستباحت حريتها واغتصبت أحلامها أمام مرأى ومسمع البشرية، التي كرست قنواتها الفضائية لإعادة عروض الأفلام الروائية والوثائقية التي تصور إضطهاد النازية لليهود حتى تبعد المتلقي في العالم عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة العبرية بحق لبنان والفلسطينيين، ونهب وثائقها كغنائم حرب، ومنها الوثائق السينمائية. نفذتُ فيلماً أثبت فيها أن الدولة العبرية بجريمتها هذه تستهدف محو الهوية الفلسطينية المتمثلة بوثيقة الإرث والتاريخ والتشبث بالعادات والتقاليد والثقافة التي تشكل الأفلام الفلسطينية المنهوبة جانباً منها ومن الهوية الفلسطينية.
لقد حاورت في الفيلم عدداً من الشخصيات الفلسطينية لما جرى من نهب للوثائق المنهوية، ولنقرأ ما قاله الشاعر محمود درويش في فيلم «الهوية الفلسطينية» وهو فيلم تكمن أهميته في وثائقيته، فهو يعكس بشكل موضوعي الكثير من الحقائق المتعلقة بالصورة المتحركة والخوف منها وإمتلاكها وترويضها لصالح الدولة العبرية بعيداً عن الحقائق الموضوعية والقيم الجمالية والفنية. يقول الشاعر الراحل محمود درويش:
"يبدو لي من الضروري أن نستوعب جيداً أن المشروع الإسرائيلي تجاه نفسه وتجاه الشعب الفلسطيني لا يتأسس في وعيه إلا على أساس إلغاء مقومات الوجود الفلسطيني والشخصية الفلسطينية سواء كانت هذه المقومات على مستوى العلاقة بين الإنسان والأرض أو بين التاريخ والذاكرة، لأن العملية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية منذ تأسيس المشروع الصهيوني حتى الآن وعلى المستوى الإيديولوجي، وعلى المستوى العملية السياسية، لم تقدم لنا ولا للمراقب الأجنبي غير هذا الفهم الإسرائيلي الذي يبدو أنه قد آن الأوان لنا جميعا، أن ندرك ذلك بالنسبة لمستوى مستقبل عملنا السياسي، وفي هذا المجال فإن الإعتداء على الثقافة الفلسطينية هو جزء من عملية الإبادة الإسرائيلية المخططة والواعية للشخصية الفلسطينية. ونحن نرى جميعاً أن الحق الإسرائيلي المدعى على الأرض الفلسطينية تاريخ عن صياغة علاقة ميثولوجية بين الإنسان الإسرائيلي والأرض الفلسطينية، لذلك فإن ساحة الصراع على أرضية الوجود أوصلت الوعي الصهيوني إلى حتمية الإبادة، لأن الشخصية الفلسطينية هي النقيض التاريخي للإدعاء الصهيوني الحقوقي على أرض فلسطين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الوجود الإسرائيلي الذي يعبر عن نفسه بأنه إمتداد حضاري وثقافي للغرب محتاج إلى البرهنة لنفسه أولًا، ولأنصاره بالغرب ثانياً، بأن هذه الأرض الفلسطينية هي أرض خالية، ليس فقط من السكان، إنما من العلاقة بين الإنسان والأرض والتاريخ، أي خالية من الثقافة.. ونحن نعرف أن نمو الثقافة الفلسطينية في هذه العلاقة الثلاثية بين الأرض والإنسان والذاكرة، قد ساعدت كثيراً على بلورة الإدراك الخارجي لشرعية الحق الفلسطيني في صراعه مع الإعتداء الصهيوني".
هذه عينة من داخل فيلمي «الهوية الفلسطينية» ومثلها عينات لصبري جريس وعبد الله حوراني وآني كنفاني وطلال ناجي وإسماعيل شموط. تتداخل الحوارات مع الحقائق الموضوعية التي عانت منها لبنان وعانى منها الشعبان الفلسطيني واللبناني أثناء غزو الدولة العبرية للأراضي اللبنانية، بدون أن يرفع أصدقاء الدولة العبرية إيديهم في المنظمة الدولية، "الأمم المتحدة"، إحتجاجا على عملية السطو والنهب التي حصلت في لبنان وعلى الوثائق المرئية والمسموعة والمدونة، بل أن أصدقاء الدولة العبرية تمتلئ شاشات القنوات الفضائية التابعة لهم، بمشاهد حقيقية وأخرى مزورة أو ممثلة ومبالغ في أدائها عن الجريمة التاريخية للنازية ضد اليهود والمجتمع اليهودي، وأنا أيضاً أقف ضد تلك الجريمة وأدينها بقوة وبشجاعة لكن مثل ما أدين بذات القوة والشجاعة مجازر كفر قاسم وصبرا وشاتيلا وغزو الأراضي اللبنانية واحتلال الجولان والأراضي العربية والفلسطينية!
هذا نموذج من الأفلام التي بذلتُ جهداً في المحافظة عليها وأنا العراقي الذي لم يكن يحمل جواز سفر وطنه كنت أنقل ما يقرب من خمسمائة كيلو غرام من الأفلام من بلد إلى بلد وأجتاز الحدود وأعاني من أجل أن أحفظ تلك الأفلام السينمائية بدون شروط حفظ نظامية متوفرة في أرشيف الوزارة الإسرائيلية!
من هذا المنطلق ينبغي إعادة بحث الدراسة المتعلقة بالذاكرة الإنسانية، فالأفلام الفلسطينية التي تتناول قضية الشعب الفلسطيني لم تعد عملية إنسانية تستفز العواطف لأطفال فلسطينيين يتنقلون في أروقة الأونروا أو أطفال يعيشون بعيداً عن وطنهم ويرسمون على الورق الطائرات الإسرائيلية وهي تلقي بنقاط من الحبر والألوان على مخيمات من الصفيح. إنها طائرات حقيقية من نوع الشبح والأف 16 والميراج المتطور تلقي بجحيمها علينا ونحن في لبنان نصورها ونعيشها جحيماً حقيقياً يثير الرعب مهما بلغ مستوى الشجاعة الإنسانية.
حتى ننصف القضية الفلسطينية، وحتى نكشف الحقائق الموضوعية فنحن مطالبون ليس بإدانة المنهوب والمخفي من الوثائق بل أيضاً بإدانة مؤسسات الإعلام في العالم والممثلة بالفضائيات ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء من أجل أن تكون منصفة في بث الحقائق الموضوعية أمام أنظار الرأي العام العالمي والإنساني. وهذا هو المخفي والمنهوب من الحقائق الموضوعية في التاريخ الإنساني.
لقد صورنا عائد إلى حيفا وبيوتنا الصغيرة والكلمة البندقية والنهر البارد ولماذا نزرع الورد والحياة الجديدة وتل الزعتر ومجزرة صبرا وشاتيلا… واستطعنا أن نحتفظ بها وننقلها على ظهورنا متنقلين بين بلدان العالم حتى لا نتركها عرضة لنهب الدولة العبرية.
لقد نهبت الدولة العبرية، الأراضي العربية في فلسطين ولبنان وسوريا، قبل نهب العلب السينمائية الصغيرة. نهب الأرض تسترده الحروب وهو أمر مؤسف للغاية أن تكون الحروب أداة لنهب الأراضي وأداة لاسترجاعها. ولكن ثمة حقيقة موضوعية وهي نهب التراث ونهب الصورة والكلمة والخارطة في محاولة "مستحيلة ويائسة" لإلغاء الهوية الفلسطينية، مهما حاولت الدولة العبرية دفنها في مخازن أرشيف وزارة الحرب الإسرائيلية!
لقراءة مقابلة أجريناها مؤخراً مع قاسم حول، وفيها حديث عن الأرشيف السينمائي الفلسطيني...