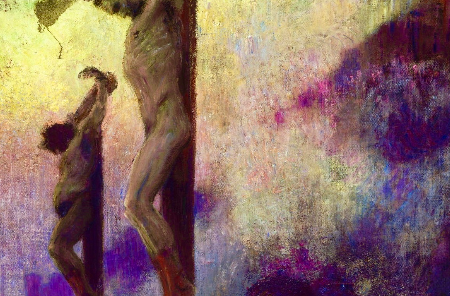الكاتب المغربي محمد شكري
لم يغادر شكري المغرب وهو يكتب روايته «الشطار»، ولعله لم يكن يفكر أثناء كتابتها تحديداً في التعددية اللغوية، أو في سؤال مكان الكاتب. لكن ما كتبه، حتى ولو عرضاً، يصلح لإنارة الطريق عند التفكير في أمر مكان الكاتب، لا سيما عندما يكتب من خارج سياق لغته. كأن شكري يريد أن يقول لنا إن الكاتب ميت أو خفيّ لأنه يسكن اللغة، أي ذلك المكان الذي تتشكل فيه الأشياء وتولد من جديد. وظيفة الكاتب لا تتمثل في أن يكون معاصراً للأحداث، ولا أن يكون حاضراً بجسده في سياق مكاني أو زماني بعينه، فهذه الاختيارات تحددها حاجات الكاتب الحياتية، وإنما وظيفته الملحّة هي العثور على اللغة المناسبة، أو خلقها إن استلزم الأمر، لكي يمكن للواقع أن يولد من جديد.
في رواية «الشُطّار»، والتي تشكل الجزء الثاني من سيرته الذاتية، يروي الكاتب المغربي محمد شكري (١٩٣٥ - ٢٠٠٣) أنه كان جالساً ذات يوم في مقهى كونتيننتال بمدينة طنجة، عندما لاحظ بجواره شخصاً أنيقاً تتحلق حوله جماعةُ من رواد المقهى، فسأل شكري أحدَ الجالسين مستفهماً عن هذا الشخص الذي بدا أنه يحظى باحترام الجميع، وجاءه الجواب بأنه الأديب المعروف محمد الصباغ. لم يكن اسم الصباغ غريباً على مسامع شكري، فقد سبق وقرأ له بعض الكتب. وبالرغم من ذلك فقد اندهش شكري كثيراً من هذا اللقاء. والسبب هو رؤيتُه لكاتب أمامه بشحمه ولحمه، لأن شكري كان يظن حتى ذلك الوقت أن الكُتّاب هم إما ميتون وإما متوارون بعيداً. شكري الذي كان آنذاك في بدايات اهتمامه بالأدب، يعلق في روايته تلك على هذا اللقاء قائلاً: "كنت أعتقد أن الأديب لا يُرى في الأماكن العمومية ولا يتحدث إلى الناس كما يفعل محمد الصباغ في هذا المقهى. إن الأديب إما هو خفيّ وإما هو ميّت". تُرى لماذا ارتبط الكاتب في ذهن شكري بالموت أو الاختفاء؟ وما الذي يعنيه الموت هنا؟ كيف يمكن لميّت أن يكتب؟ وما لذي لديه لكي يقوله لقارئ حيّ؟ لا يمكننا سوى أن نخمن إجابات عن كل تلك الأسئلة، فشكري لا يخبرنا المزيد، ويتركنا وحدنا مع ملاحظته العابرة تلك.
صدرت رواية «الشطار» في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم تتسنّ لي قراءتها سوى قبل أعوام قليلة في برلين، حيث أعيش منذ أكثر من ١٥ عاماً. حملتُ الرواية معي من القاهرة، مدينتي التي نشأت فيها، وأضحت صلتي بها متقطعة، بعد أن كنت مستقراً فيها. قد أبقى فيها شهوراً إذا سمحت الظروف، وقد يمر العام ولا أزورها سوى أيام قليلة. وفي كل رحلة بين المدينتين أحمل معي كتباً. فأنقل من برلين إلى القاهرة كتباً قليلة بالإنجليزية أو الألمانية أكون منهمكاً في قراءتها قبل سفري ولا أستطيع مفارقتها، فآخذها معي حتى أُنهي قراءتها في القاهرة، ثم أتركها هناك. وأنقل من القاهرة إلى برلين كتبا كثيرة بالعربية معظمها من أحدث الإصدارات، لكي أقرأها فيما بعد حين تعزّ الكتب العربية. عندما أفكر في غربة كتبي بين المدينتين، ومفارقتها للسياق اللغوي الذي تنتهي إليه، أجد أنها تشبه كثيراً غربتي اللغوية بعد انتقالي إلى برلين واستمراري مع ذلك في الكتابة باللغة العربية. فمثلما انتهت كتبي الأجنبية إلى القاهرة وكتبي العربية إلى برلين، انتهيت أنا إلى أن أُصبح في برلين كاتباً غير مرئي، يكتب بلغة لا يستطيع الكثيرون قراءتها، وفي القاهرة كاتباً غائباً، لا يشارك الآخرين في الواقع اليومي المعاش. أنا حاضر وغائب معاً في كلتا المدينتين. أكتب بالعربية في برلين، وأقرأ بالألمانية في القاهرة. أردّ على فكرة قرأتها بالألمانية في نص أكتبه بالعربية، وأضبط نفسي أحياناً متلبساً بترجمة كلمة من الإنجليزية أثناء حديثي بالعربية.
لذلك ما أن وقعت عيناي على ملاحظة شكري السالفة حتى ارتبطتُ بها روحياً، ولم تكفّ عن إثارة فتنتي وحيرتي من وقتها. شعرت مباشرة أن ملاحظة شكري أكثر عمقاً من إرجاعها إلى مجرد إقباله في تلك الفترة على قراءة كلاسيكيات الأدب التي كتبها كتاب راحلون. ووجدت فيها مدخلاً للتفكير في مكان الكاتب، خاصةً عندما يتعقد هذا المكان كما هو الأمر في حالتي. إذ لا بد أنني في عداد الأشباح بالنسبة لقارئ برليني، لا يستطيع قراءة ما أكتبه. ولا بد أنني في عداد الموتى بالنسبة لقارئ قاهري، تأتيه نصوصي وكتبي كأنها قادمة من عالم آخر. ولاح لي أن بالإمكان الخروج باستنتاجين مثيرين للتأمل من دهشة شكري من رؤيته كاتباً وجهاً لوجه. الاستنتاج الأول هو أن العلاقة بين الكاتب والقارئ ينبغي أن تقتصر على فعل القراءة وحده، وليس على الحضور المكاني المشترك. فالكاتب "لا يُرى في الأماكن العمومية" التي يغشاها القارئ، وإنما تتقاطع طريقُه مع طريق القارئ على صفحات الكتاب. والاستنتاج الثاني أنه حتى عندما تتقاطع طريقاً الكاتب والقارئ في فعل القراءة فإنهما لا يلتقيان وجها لوجه، فالقراءة هي دائماً حوار مع طرف غائب، طرف يصفه شكري بأنه "إما خفيّ وإما ميت". هذا الطرف الغائب هو الكاتب. الكاتب إذاً وفقاً لملاحظة شكري لا يظهر بوصفه كاتباً سوى على صفحات كتبه. وحتى عندما يظهر في كتبه عبر فعل القراءة فإنه يكون غائباً. لكن كيف يمكن للكاتب أن يكون حاضراً وغائباً في الوقت نفسه؟ حياً وميتاً معاً؟ هل الكاتب شبح؟ طيف؟ روح؟ هل يشغل مكاناً في الواقع؟ وأين هو هذا المكان الذي يتحدث منه إلى القارئ؟ أين هو هذا العالم الآخر الذي يطل علينا منه إذا كان ميتاً؟
السؤال عن مكان الكاتب هو بلا شك جوهر ملاحظة شكري. والإجابة المثيرة التي يبدو لي أنه يقدمها هي أن مكان الكاتب لا يتطابق بالضرورة مع الواقع الذي يعيش فيه. فالموت والاختفاء اللذان يسِمان الكتابة وفقاً لشكري يعنيان أخذ مسافة من ذلك الواقع. هل ينسحب الكاتب من الواقع إذن؟ ملاحظة شكري تومئ إلى إجابة معقدة، وهي أن ظهور الكاتب عبر كتبه يحدث في قلب الواقع ولكن من خلال مسافة، ربما لأن مهمة الكاتب هي أن يشقّ مسافةً في قلب الواقع الذي يعمل عليه، فيجعل الواقع غريباً عن نفسه، وفي هذه المسافة بالضبط تحدث الكتابة. أو بكلمات أخرى، إذا كانت الكتابة هي حياة أخرى after life يكتبها كاتب يطل علينا من العالم الآخر كما تقترح ملاحظة شكري، فإن الطريقة الوحيدة لفهم ذلك إذا رفضنا توريط شكري في أية تأويلات روحانية أو دينية، هي أن الحياة الأخرى تلك ما هي إلا الواقع نفسه بعد أن أصبح عبر الكتابة قابلاً للتجاوز. أي أن الكتابة ليست انسحاباً عن الواقع، بل هي نقد مبطّن له، في طريق تجاوزه. الكتابة هي الواقع بعد أن يصبح غريباً عن نفسه، وليست صورته عن نفسه. والكاتب، إذا مددنا ملاحظة شكري على استقامتها، وظيفته أن يموت، أي ألّا يكون ابناً باراً للواقع، بل عليه أن لا يتوقف عن عقوقه. وظيفته أن ينفي الواقع لا أن يثبّته، أن يُهزه ويُدخِلَه عبر الكتابة إلى مِرجل التحولات.
لنعد إلى سؤالنا مرة أخرى: أين يقف الكاتب إذن؟ أين هو مكانه بالضبط؟ والإجابة استناداً إلى كل ما سبق هي أن مكان الكاتب هو قلب الواقع. لكن الواقع بالنسبة للكاتب ليس مكاناً للمساكنة والاستقرار، وإنما هو مكان مفتوح دائماً على إمكانية تجاوزه وتغييره، على إمكانية إعادة فكّه وتركيبه. وهنا يظهر الموت، إذ لا يمكن أن يحدث تجاوز أو تغير من دون موت. لكن هذا الموت هو موت مفعم بالحياة، وليس انتحاراً أو موتاً بيولوجياً. هذا الموت هو الخروج من الحياة الميتة، التي أضحت مجرد تكرار خانق، والعودة إلى الحياة الفائرة والمليئة بالاحتمالات. مكان الكاتب إذاً هو الموت والغياب اللذان يؤذنان بالتجاوز والتغيير. أو بصياغة أفضل، مكان الكتابة هو هذه الفجوة التي يشقها الأدب داخل الواقع ليوقف تكراره وتكلسه ويفتحه على إمكانية تغييره. هذه الفجوة هي الانقطاع الذي لا يجب وصله، والفراغ الذي لا يجب ملئه، هي ذلك الموت الذي يجب أن يحدث حتى يولد الواقع من جديد. وفي هذه الفجوة نفسها تحدث أيضاً القراءة، وليس في أي مكان آخر. فالقراءة هي إعادة فتح الواقع للعمل عليه بناءً على اقتراح من الكتاب قيد القراءة. العمل الأدبي يمكنه أن "يعمل" فقط إذا تساكن الكاتب والقارئ في هذه الفجوة، لا في المدينة أو الحي، أو حتى العصر. لكن في هذه الفجوة لا يوجد سكن أو استقرار، وإنما اضطراب وزعزعة. وهذا بالضبط ما هو فاتن في الأدب، وما هو مخيف أيضاً.
أدركت حرفةُ الكتابة شكري وهو في عقده الثالث. فقد انقطع ابن منطقة الريف عن التعليم مبكراً كما هو معروف، وقضى صباه فقيراً مشرداً في دروب طنجة السفلية. ثم بدأ يتعلم القراءة من جديد وهو شاب في عشرينياته. وعندما أجادها أخذ يلتهم كلّ ما تقع عليه يدُه من كتب. هناك في عزلة القراءة يُولد الكُتّاب. وعندما يولد كاتبٌ تُكتب حياةٌ جديدة لسلالة بأكملها من الكتاب السابقين عليه. أن يولد كاتبٌ يعنى أن تُبعث معه كتاباتٌ سابقةٌ عليه، فيقوم عبر كتابته بفحصها ومراجعتها ونفيها إذا استلزم الأمر، ليكتشف فيها إمكانات جديدة لم يلتفت إليها أحد. هناك في صحبة الكتاب الموتى والخفيّين، وعلى صفحات الكتب التي يسودونها، أنضج شكري أخيرا لغةً يستطيع بها أن يتحدث عن تجارب حياته الماضية، تلك الحياة التي كانت مستبعدة من الأدب العربي، ولم يكن لها لغة بعد. وجد شكري أخيرا لغةً مدببة الحواف يستطيع أن يكتب بها عن الدعارة، عن المثلية، عن الفقر المدقع، وعن الخراب الإنساني، عن كل تفاصيل الحياة الوحشية في قاع المدينة. كل ما كان يحدث هناك في الخفاء ظهر رويداً رويداً في كتابات شكري. وإذا كانت وظيفة الموت هي أن يكون انقطاعاً أو فجوةً يحدث فيها التغير والتحول، فلعلّ وظيفة الخفاء في الكتابة هي الإنصات لتلك القوى الخافتة التي تعمل في الظلام، هي الانشغال بما هو غائب عن الحاضر، ومن ثمّ البحث عن لغة مناسبة ليظهر فيها ما استُبعد. الأديب إما خفيّ وإما ميّت، كما قال شكري، لأن الأديب ببساطة ينحاز إلى ما استُبعد أو أُخفي، وينتمي إلى ما يولد من جديد.
السؤال حول مكان الكتابة قادنا إذاً لأن نرى كيف أن المكان الأكثر أصالة للكاتب عندما يكتب قد لا يكون هو الحاضر المُعطى، وإنما هو النقطة التي ينفتح فيها الحاضر على مستقبله أو ماضيه. أي النقطة التي تنفتح فيها إمكانية تجاوزِ الحاضر من خلال محاولة استحضار ما استبعد منه. الكتابة توجد إذاً داخل الواقع وخارجه في الوقت نفسه، أو في النقاط التي ينفتح فيها داخله على خارجه. وأين يمكن لهذا أن يحدث؟ يمكن أن يحدث هذا في اللغة فقط. ففي اللغة فقط يمكن للكاتب أن يتفاوض مع الحدود التي تفصل الخارج عن الداخل، وفي اللغة فقط يمكن للكاتب أن يجد شكلا لما هو عصيٌ على التشكل، أو لما هو محرومٌ منه. السؤال حول مكان الكاتب قادنا إذن، وعبر طريق وعرة، إلى اللغة. الآن يمكننا أن نقول هذه الإجابة البسيطة عن سؤالنا: مكان الكاتب هو اللغة. واللغة هنا ليست رحماً للهوية، وإنما مكان للتفاوض والتشكّل. ولا يوجد مثال أوضح على طبيعة اللغة تلك من حالة الكاتب الذي يعيش وسط تعددية لغوية. فلغة الكتابة عنده هي المكان الذي يُمارس فيه التفاوض المستمر بين اللغات المتعددة، مما يجعل العلاقة باللغة الأم تتحول من معطى مسلم به إلى عمل شاق ودؤوب، بكل ما يحمله ذلك من لحظات كابوسية، وأخرى مضيئة.
لم يغادر شكري المغرب وهو يكتب روايته «الشطار»، ولعله لم يكن يفكر أثناء كتابتها تحديداً في التعددية اللغوية، أو في سؤال مكان الكاتب. لكن ما كتبه، حتى ولو عرضاً، يصلح لإنارة الطريق عند التفكير في أمر مكان الكاتب، لا سيما عندما يكتب من خارج سياق لغته. كأن شكري يريد أن يقول لنا إن الكاتب ميت أو خفيّ لأنه يسكن اللغة، أي ذلك المكان الذي تتشكل فيه الأشياء وتولد من جديد. وظيفة الكاتب لا تتمثل في أن يكون معاصراً للأحداث، ولا أن يكون حاضراً بجسده في سياق مكاني أو زماني بعينه، فهذه الاختيارات تحددها حاجات الكاتب الحياتية، وإنما وظيفته الملحّة هي العثور على اللغة المناسبة، أو خلقها إن استلزم الأمر، لكي يمكن للواقع أن يولد من جديد. وظيفة الكاتب ليست بالضرورة أن يشارك القارئ الواقع نفسه، وإنما أن يساعد القارئ في أن يضع يده على حدود واقعه، أن يلفت انتباه القارئ إلى ما استبعده ذلك الذي نسميه واقعاً. ولكي ينجح في وظيفته تلك لا بد من انقطاع. لكي يستعيد القارئ إمكانيةً فاتته ملاحظتها، لكي يولد الواقع من جديد، لابد أن يكون الكاتبُ غائباً عن القارئ. فقط في ذلك الغياب الذي يحتاجه الأدب، في تلك الفجوة التي تسمى القراءة، في ذلك الموت الذي هو حياة، يمكن أن تظهر إمكانية جديدة مفادها أن الواقع لا يجب أن يستمر على المنوال نفسه.
ورقة قُرئت في مؤتمر “كتابة (في) المنفى” الذي انعقد في برلين يوليو/تموز الماضي.
صدرت رواية «الشطار» في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ولم تتسنّ لي قراءتها سوى قبل أعوام قليلة في برلين، حيث أعيش منذ أكثر من ١٥ عاماً. حملتُ الرواية معي من القاهرة، مدينتي التي نشأت فيها، وأضحت صلتي بها متقطعة، بعد أن كنت مستقراً فيها. قد أبقى فيها شهوراً إذا سمحت الظروف، وقد يمر العام ولا أزورها سوى أيام قليلة. وفي كل رحلة بين المدينتين أحمل معي كتباً. فأنقل من برلين إلى القاهرة كتباً قليلة بالإنجليزية أو الألمانية أكون منهمكاً في قراءتها قبل سفري ولا أستطيع مفارقتها، فآخذها معي حتى أُنهي قراءتها في القاهرة، ثم أتركها هناك. وأنقل من القاهرة إلى برلين كتبا كثيرة بالعربية معظمها من أحدث الإصدارات، لكي أقرأها فيما بعد حين تعزّ الكتب العربية. عندما أفكر في غربة كتبي بين المدينتين، ومفارقتها للسياق اللغوي الذي تنتهي إليه، أجد أنها تشبه كثيراً غربتي اللغوية بعد انتقالي إلى برلين واستمراري مع ذلك في الكتابة باللغة العربية. فمثلما انتهت كتبي الأجنبية إلى القاهرة وكتبي العربية إلى برلين، انتهيت أنا إلى أن أُصبح في برلين كاتباً غير مرئي، يكتب بلغة لا يستطيع الكثيرون قراءتها، وفي القاهرة كاتباً غائباً، لا يشارك الآخرين في الواقع اليومي المعاش. أنا حاضر وغائب معاً في كلتا المدينتين. أكتب بالعربية في برلين، وأقرأ بالألمانية في القاهرة. أردّ على فكرة قرأتها بالألمانية في نص أكتبه بالعربية، وأضبط نفسي أحياناً متلبساً بترجمة كلمة من الإنجليزية أثناء حديثي بالعربية.
لذلك ما أن وقعت عيناي على ملاحظة شكري السالفة حتى ارتبطتُ بها روحياً، ولم تكفّ عن إثارة فتنتي وحيرتي من وقتها. شعرت مباشرة أن ملاحظة شكري أكثر عمقاً من إرجاعها إلى مجرد إقباله في تلك الفترة على قراءة كلاسيكيات الأدب التي كتبها كتاب راحلون. ووجدت فيها مدخلاً للتفكير في مكان الكاتب، خاصةً عندما يتعقد هذا المكان كما هو الأمر في حالتي. إذ لا بد أنني في عداد الأشباح بالنسبة لقارئ برليني، لا يستطيع قراءة ما أكتبه. ولا بد أنني في عداد الموتى بالنسبة لقارئ قاهري، تأتيه نصوصي وكتبي كأنها قادمة من عالم آخر. ولاح لي أن بالإمكان الخروج باستنتاجين مثيرين للتأمل من دهشة شكري من رؤيته كاتباً وجهاً لوجه. الاستنتاج الأول هو أن العلاقة بين الكاتب والقارئ ينبغي أن تقتصر على فعل القراءة وحده، وليس على الحضور المكاني المشترك. فالكاتب "لا يُرى في الأماكن العمومية" التي يغشاها القارئ، وإنما تتقاطع طريقُه مع طريق القارئ على صفحات الكتاب. والاستنتاج الثاني أنه حتى عندما تتقاطع طريقاً الكاتب والقارئ في فعل القراءة فإنهما لا يلتقيان وجها لوجه، فالقراءة هي دائماً حوار مع طرف غائب، طرف يصفه شكري بأنه "إما خفيّ وإما ميت". هذا الطرف الغائب هو الكاتب. الكاتب إذاً وفقاً لملاحظة شكري لا يظهر بوصفه كاتباً سوى على صفحات كتبه. وحتى عندما يظهر في كتبه عبر فعل القراءة فإنه يكون غائباً. لكن كيف يمكن للكاتب أن يكون حاضراً وغائباً في الوقت نفسه؟ حياً وميتاً معاً؟ هل الكاتب شبح؟ طيف؟ روح؟ هل يشغل مكاناً في الواقع؟ وأين هو هذا المكان الذي يتحدث منه إلى القارئ؟ أين هو هذا العالم الآخر الذي يطل علينا منه إذا كان ميتاً؟
السؤال عن مكان الكاتب هو بلا شك جوهر ملاحظة شكري. والإجابة المثيرة التي يبدو لي أنه يقدمها هي أن مكان الكاتب لا يتطابق بالضرورة مع الواقع الذي يعيش فيه. فالموت والاختفاء اللذان يسِمان الكتابة وفقاً لشكري يعنيان أخذ مسافة من ذلك الواقع. هل ينسحب الكاتب من الواقع إذن؟ ملاحظة شكري تومئ إلى إجابة معقدة، وهي أن ظهور الكاتب عبر كتبه يحدث في قلب الواقع ولكن من خلال مسافة، ربما لأن مهمة الكاتب هي أن يشقّ مسافةً في قلب الواقع الذي يعمل عليه، فيجعل الواقع غريباً عن نفسه، وفي هذه المسافة بالضبط تحدث الكتابة. أو بكلمات أخرى، إذا كانت الكتابة هي حياة أخرى after life يكتبها كاتب يطل علينا من العالم الآخر كما تقترح ملاحظة شكري، فإن الطريقة الوحيدة لفهم ذلك إذا رفضنا توريط شكري في أية تأويلات روحانية أو دينية، هي أن الحياة الأخرى تلك ما هي إلا الواقع نفسه بعد أن أصبح عبر الكتابة قابلاً للتجاوز. أي أن الكتابة ليست انسحاباً عن الواقع، بل هي نقد مبطّن له، في طريق تجاوزه. الكتابة هي الواقع بعد أن يصبح غريباً عن نفسه، وليست صورته عن نفسه. والكاتب، إذا مددنا ملاحظة شكري على استقامتها، وظيفته أن يموت، أي ألّا يكون ابناً باراً للواقع، بل عليه أن لا يتوقف عن عقوقه. وظيفته أن ينفي الواقع لا أن يثبّته، أن يُهزه ويُدخِلَه عبر الكتابة إلى مِرجل التحولات.
لنعد إلى سؤالنا مرة أخرى: أين يقف الكاتب إذن؟ أين هو مكانه بالضبط؟ والإجابة استناداً إلى كل ما سبق هي أن مكان الكاتب هو قلب الواقع. لكن الواقع بالنسبة للكاتب ليس مكاناً للمساكنة والاستقرار، وإنما هو مكان مفتوح دائماً على إمكانية تجاوزه وتغييره، على إمكانية إعادة فكّه وتركيبه. وهنا يظهر الموت، إذ لا يمكن أن يحدث تجاوز أو تغير من دون موت. لكن هذا الموت هو موت مفعم بالحياة، وليس انتحاراً أو موتاً بيولوجياً. هذا الموت هو الخروج من الحياة الميتة، التي أضحت مجرد تكرار خانق، والعودة إلى الحياة الفائرة والمليئة بالاحتمالات. مكان الكاتب إذاً هو الموت والغياب اللذان يؤذنان بالتجاوز والتغيير. أو بصياغة أفضل، مكان الكتابة هو هذه الفجوة التي يشقها الأدب داخل الواقع ليوقف تكراره وتكلسه ويفتحه على إمكانية تغييره. هذه الفجوة هي الانقطاع الذي لا يجب وصله، والفراغ الذي لا يجب ملئه، هي ذلك الموت الذي يجب أن يحدث حتى يولد الواقع من جديد. وفي هذه الفجوة نفسها تحدث أيضاً القراءة، وليس في أي مكان آخر. فالقراءة هي إعادة فتح الواقع للعمل عليه بناءً على اقتراح من الكتاب قيد القراءة. العمل الأدبي يمكنه أن "يعمل" فقط إذا تساكن الكاتب والقارئ في هذه الفجوة، لا في المدينة أو الحي، أو حتى العصر. لكن في هذه الفجوة لا يوجد سكن أو استقرار، وإنما اضطراب وزعزعة. وهذا بالضبط ما هو فاتن في الأدب، وما هو مخيف أيضاً.
أدركت حرفةُ الكتابة شكري وهو في عقده الثالث. فقد انقطع ابن منطقة الريف عن التعليم مبكراً كما هو معروف، وقضى صباه فقيراً مشرداً في دروب طنجة السفلية. ثم بدأ يتعلم القراءة من جديد وهو شاب في عشرينياته. وعندما أجادها أخذ يلتهم كلّ ما تقع عليه يدُه من كتب. هناك في عزلة القراءة يُولد الكُتّاب. وعندما يولد كاتبٌ تُكتب حياةٌ جديدة لسلالة بأكملها من الكتاب السابقين عليه. أن يولد كاتبٌ يعنى أن تُبعث معه كتاباتٌ سابقةٌ عليه، فيقوم عبر كتابته بفحصها ومراجعتها ونفيها إذا استلزم الأمر، ليكتشف فيها إمكانات جديدة لم يلتفت إليها أحد. هناك في صحبة الكتاب الموتى والخفيّين، وعلى صفحات الكتب التي يسودونها، أنضج شكري أخيرا لغةً يستطيع بها أن يتحدث عن تجارب حياته الماضية، تلك الحياة التي كانت مستبعدة من الأدب العربي، ولم يكن لها لغة بعد. وجد شكري أخيرا لغةً مدببة الحواف يستطيع أن يكتب بها عن الدعارة، عن المثلية، عن الفقر المدقع، وعن الخراب الإنساني، عن كل تفاصيل الحياة الوحشية في قاع المدينة. كل ما كان يحدث هناك في الخفاء ظهر رويداً رويداً في كتابات شكري. وإذا كانت وظيفة الموت هي أن يكون انقطاعاً أو فجوةً يحدث فيها التغير والتحول، فلعلّ وظيفة الخفاء في الكتابة هي الإنصات لتلك القوى الخافتة التي تعمل في الظلام، هي الانشغال بما هو غائب عن الحاضر، ومن ثمّ البحث عن لغة مناسبة ليظهر فيها ما استُبعد. الأديب إما خفيّ وإما ميّت، كما قال شكري، لأن الأديب ببساطة ينحاز إلى ما استُبعد أو أُخفي، وينتمي إلى ما يولد من جديد.
السؤال حول مكان الكتابة قادنا إذاً لأن نرى كيف أن المكان الأكثر أصالة للكاتب عندما يكتب قد لا يكون هو الحاضر المُعطى، وإنما هو النقطة التي ينفتح فيها الحاضر على مستقبله أو ماضيه. أي النقطة التي تنفتح فيها إمكانية تجاوزِ الحاضر من خلال محاولة استحضار ما استبعد منه. الكتابة توجد إذاً داخل الواقع وخارجه في الوقت نفسه، أو في النقاط التي ينفتح فيها داخله على خارجه. وأين يمكن لهذا أن يحدث؟ يمكن أن يحدث هذا في اللغة فقط. ففي اللغة فقط يمكن للكاتب أن يتفاوض مع الحدود التي تفصل الخارج عن الداخل، وفي اللغة فقط يمكن للكاتب أن يجد شكلا لما هو عصيٌ على التشكل، أو لما هو محرومٌ منه. السؤال حول مكان الكاتب قادنا إذن، وعبر طريق وعرة، إلى اللغة. الآن يمكننا أن نقول هذه الإجابة البسيطة عن سؤالنا: مكان الكاتب هو اللغة. واللغة هنا ليست رحماً للهوية، وإنما مكان للتفاوض والتشكّل. ولا يوجد مثال أوضح على طبيعة اللغة تلك من حالة الكاتب الذي يعيش وسط تعددية لغوية. فلغة الكتابة عنده هي المكان الذي يُمارس فيه التفاوض المستمر بين اللغات المتعددة، مما يجعل العلاقة باللغة الأم تتحول من معطى مسلم به إلى عمل شاق ودؤوب، بكل ما يحمله ذلك من لحظات كابوسية، وأخرى مضيئة.
لم يغادر شكري المغرب وهو يكتب روايته «الشطار»، ولعله لم يكن يفكر أثناء كتابتها تحديداً في التعددية اللغوية، أو في سؤال مكان الكاتب. لكن ما كتبه، حتى ولو عرضاً، يصلح لإنارة الطريق عند التفكير في أمر مكان الكاتب، لا سيما عندما يكتب من خارج سياق لغته. كأن شكري يريد أن يقول لنا إن الكاتب ميت أو خفيّ لأنه يسكن اللغة، أي ذلك المكان الذي تتشكل فيه الأشياء وتولد من جديد. وظيفة الكاتب لا تتمثل في أن يكون معاصراً للأحداث، ولا أن يكون حاضراً بجسده في سياق مكاني أو زماني بعينه، فهذه الاختيارات تحددها حاجات الكاتب الحياتية، وإنما وظيفته الملحّة هي العثور على اللغة المناسبة، أو خلقها إن استلزم الأمر، لكي يمكن للواقع أن يولد من جديد. وظيفة الكاتب ليست بالضرورة أن يشارك القارئ الواقع نفسه، وإنما أن يساعد القارئ في أن يضع يده على حدود واقعه، أن يلفت انتباه القارئ إلى ما استبعده ذلك الذي نسميه واقعاً. ولكي ينجح في وظيفته تلك لا بد من انقطاع. لكي يستعيد القارئ إمكانيةً فاتته ملاحظتها، لكي يولد الواقع من جديد، لابد أن يكون الكاتبُ غائباً عن القارئ. فقط في ذلك الغياب الذي يحتاجه الأدب، في تلك الفجوة التي تسمى القراءة، في ذلك الموت الذي هو حياة، يمكن أن تظهر إمكانية جديدة مفادها أن الواقع لا يجب أن يستمر على المنوال نفسه.
ورقة قُرئت في مؤتمر “كتابة (في) المنفى” الذي انعقد في برلين يوليو/تموز الماضي.