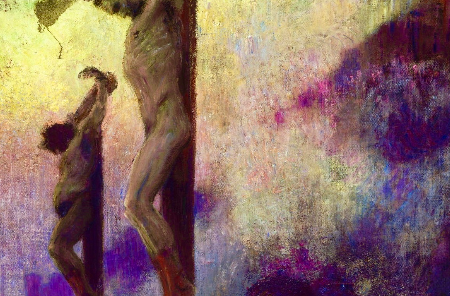مبنى وساحة الكابيتول في المدينة
إلا أن هذا النهر العظيم حيث شاءت الصدف أن أسكن في عطلتي هذه مقابله، لم يكفه أن أرسلَ لي حشراته الليلية التي لا مفر من لدغاتها، كما لا مفر من صوت ضفادعه التي تبدأ في لحظة واحدة، وكأن هناك منبه يومي يجعلهم يبدؤون النقيق معاً، بل أرسل هذا النهر بضخامته أعظم نوستالجيا للمدن داخلي، إنها الجيزة في مصر والزمالك أيضاً وكثير من القاهرة.
هناك مدن لا تنتمي لبلادها، لا تشبه أمها، أو الأرض الكبيرة التي تحتضنها، مدن مستقلة، هي بلاد بحد ذاتها.
هكذا شعرت حين زرت إسكندرية؛ سيادتها تكمن في البحر واللكنة وشعورك فيها، وليس بتبعيتها لمصر. اليوم مصابة بذات الإحساس في مدينة تولوز، أنني لستُ في فرنسا.
ربما هي الأماكن تنتمي إلى نفسها بالأصل، وليست إلى رابط سياسي مفتعل يضمها فتكون تحت علم واحد، إن بعض المدن تبقى على جماحها الأول، لا يوجد لجام يقهقرها فتشبه بقية الأرض السياسية.
الغريب في الأمر أن هذا أيضاً كان ظني حين قرأت اسم تولوز للمرة الأولى، كمدينة إقامة أحد الأصدقاء على الفيسبوك، اعتقدتُ أنها بلد ما، وكان هذا الاعتقاد مبني على جهل جغرافي، اليوم أنا في تولوز ومؤمنة بهذا الاعتقاد انطلاقاً من تواجدي في جغرافيا المكان، إنها ليست فرنسا، هي تولوز.
حين تطأ قدمي مدينة ما، لا يقف عقلي عن تداعياته ومقارناته، لأجد نفسي تشتمّ رائحة مدن أخرى في هذا المكان، وهكذا حدث مع كثير من الأماكن؛ على كورنيش بيروت رأيت شارع بحر غزة دون الروشة! في مدينة أفينيون الفرنسية رأيت القدس تستوطن جدرانها وبواباتها التاريخية. أما مدينة سيؤول الكورية فقد رأيتها في شوارع ومباني مدينة يوتبوري السويدية، وحتى إني سمعت اللغة الكورية تخرج من أصوات الحروف السويدية، لا أدري كيف! هي لعبة العقل والقلب حين يتعلق الأمر بنوستالجيا المدن.
عادة حين أصل إلى مدينة ما، لا أكون أحمل عنها أي انطباع مسبق ما عدا باريس، فهي باريس، بعض المدن تفوق شهرتها استقلالية الانطباع، فتتركك ضحية "الستريو تايبنج" سواء أحببتها أم كرهتها، فلا تعود تعرف شعورك الحقيقي اتجاهها، لأن الملايين شعروه عنك وتركوه لك مهما تملصت.
تولوز أنقذها الله من هذا النوع من الشهرة وفرط التكرار، وجعلها مختلفة على مقدار البشر، لا تفوقهم، بل هي مفصّلة كي تتناسب معهم، وحتى إن روحها تتسع لنوستالجيا مئات المدن الأخرى.
ربما كان هناك "نمط" لأهلها وطريقة عيشهم؛ سواء كانوا لاجئين أو فرنسيين، فتتوقع سلوكهم، لكن هذا أمر مختلف تماماً، فالمدينة مستقلة تماماً عن ساكنيها، إنها تعطي نفسها لكل الناس لكنها لا تتماهى معهم، أو تشبه أحداً ما.
متجددة كما نهرها "الچارون" الذي يتناسق مع شوارعها وجسورها فتشعر أنه جزء منها ولا يقسمها، لذلك لا تسمع عبارات مثل؛ "نسكن بعد النهر"، أو "قبل النهر"، أو في الشق الآخر، عكس نيويورك مثلاًًََ!
إلا أن هذا النهر العظيم حيث شاءت الصدف أن أسكن في عطلتي هذه مقابله، لم يكفه أن أرسلَ لي حشراته الليلية التي لا مفر من لدغاتها، كما لا مفر من صوت ضفادعه التي تبدأ في لحظة واحدة، وكأن هناك منبه يومي يجعلهم يبدؤون النقيق معاً، بل أرسل هذا النهر بضخامته أعظم نوستالجيا للمدن داخلي، إنها الجيزة في مصر والزمالك أيضاً وكثير من القاهرة.
إن للمدن توائم عليك اكتشفاها، وكل شارع في تولوز يذكرني بشيء في مصر، اليوم رأيت وسط البلد حول ميدان طلعت حرب، فتذكرت أن المباني هناك مصممة على النمط المعماري الفرنسي، وهذه الشجرات الخضراء حول النهر كما لدى نهر النيل.
إن نهر السين في باريس مختلف تماماً فلولا روايتيّ البؤساء والعطر، لما انتبهت إليه يوماً، لكن هذا النهر هنا يسكنك ويجبرك على إخراج الحنين، وإذا لم يكن حنينك إلى مصر فبالتأكيد سيبحث فيك حتى يجد حنينك الخاص ليصدره.
هذه التولوز تتركك صريع الحب والحنين؛ حبها هي وحنينك إلى مدن أخرى..
كم من المدن قابلت وتركتك على حريتك هكذا؛ فلا تقول لك كيف تشعر، بل تتشكل وتتغير مثل صلصال مع داخلك؟ كم من المدن تشم فيها رائحة مدن كثيرة أخرى؟ في تولوز عشت فجأة تحت شمسها بأبو ظبي، وشاهدت في مركزها برشلونة. لا أدري كيف، ولكن هذا ما يحدث للحظات ويختفي!
لن أقول أن ما ينقص تولوز البحر، لتكتمل أعجوبتها، فمن قال أن البحر تركها وحيدة، لقد تخلى عن شبحه لها. في بعض أحياء تولوز البعيدة عن المركز كنت أمشي وأنا اسمع صوت البحر وأشم رائحته، إنه فقط خلف هذه المباني وتلك الجدران، الهواء هنا هواء البحر.. شكل المنازل ولونها.
لا شيء يمنع أن يكون البحر هنا سوى ذاتك، فتولوز مدينة ساحلية مائة بالمائة وإلا كيف تحوز قلبك إلى هذا الحد إن لم يكن قد شُبه له.
هناك مدن أكبر من الإنسان ومدن أضيق منه، وهناك مدن تأتي على مقاس الإنسان، وهكذا هي تولوز، كافية كي يكون للفرد يقينه فيها.
إنها ليست على العهدة الفرنسية، بل هي الروح الأولى لفرنسا التي بقيت فيها، واختفت من المدن الأخرى.
تولوز لها غصتها العارمة، فهي ككل المدن الكبيرة؛ ليلها قاس، إنه ليل الغرباء، إذ تشعر فيه أنك وحيد بلا وطن أو أم أو أهل، أنت تنتمي فقط لموعد المترو أو الترام وإذا فوّته فكأنك فوّت أهلك.
تنظر إلى الوجوه القليلة التي حولك تحت أضواء عربة المترو القوية، جميع العيون بلا مآل نهائي، النهار هنا وطن، أما الليل فإنه ليل اللفظ والنكران، كأنك لا تعرف هذه المدينة، وكأنها المرة الأولى التي ترى هذه العيون الشاحبة من الحنين.
الذي لن تعرفه أبداً أن عينيك كما العيون المحيطة؛ هي أيضاً مجتثة من الوطن، وسكنتها الأماكن المؤقتة وليل الوحيدين.
هكذا شعرت حين زرت إسكندرية؛ سيادتها تكمن في البحر واللكنة وشعورك فيها، وليس بتبعيتها لمصر. اليوم مصابة بذات الإحساس في مدينة تولوز، أنني لستُ في فرنسا.
ربما هي الأماكن تنتمي إلى نفسها بالأصل، وليست إلى رابط سياسي مفتعل يضمها فتكون تحت علم واحد، إن بعض المدن تبقى على جماحها الأول، لا يوجد لجام يقهقرها فتشبه بقية الأرض السياسية.
الغريب في الأمر أن هذا أيضاً كان ظني حين قرأت اسم تولوز للمرة الأولى، كمدينة إقامة أحد الأصدقاء على الفيسبوك، اعتقدتُ أنها بلد ما، وكان هذا الاعتقاد مبني على جهل جغرافي، اليوم أنا في تولوز ومؤمنة بهذا الاعتقاد انطلاقاً من تواجدي في جغرافيا المكان، إنها ليست فرنسا، هي تولوز.
حين تطأ قدمي مدينة ما، لا يقف عقلي عن تداعياته ومقارناته، لأجد نفسي تشتمّ رائحة مدن أخرى في هذا المكان، وهكذا حدث مع كثير من الأماكن؛ على كورنيش بيروت رأيت شارع بحر غزة دون الروشة! في مدينة أفينيون الفرنسية رأيت القدس تستوطن جدرانها وبواباتها التاريخية. أما مدينة سيؤول الكورية فقد رأيتها في شوارع ومباني مدينة يوتبوري السويدية، وحتى إني سمعت اللغة الكورية تخرج من أصوات الحروف السويدية، لا أدري كيف! هي لعبة العقل والقلب حين يتعلق الأمر بنوستالجيا المدن.
عادة حين أصل إلى مدينة ما، لا أكون أحمل عنها أي انطباع مسبق ما عدا باريس، فهي باريس، بعض المدن تفوق شهرتها استقلالية الانطباع، فتتركك ضحية "الستريو تايبنج" سواء أحببتها أم كرهتها، فلا تعود تعرف شعورك الحقيقي اتجاهها، لأن الملايين شعروه عنك وتركوه لك مهما تملصت.
تولوز أنقذها الله من هذا النوع من الشهرة وفرط التكرار، وجعلها مختلفة على مقدار البشر، لا تفوقهم، بل هي مفصّلة كي تتناسب معهم، وحتى إن روحها تتسع لنوستالجيا مئات المدن الأخرى.
ربما كان هناك "نمط" لأهلها وطريقة عيشهم؛ سواء كانوا لاجئين أو فرنسيين، فتتوقع سلوكهم، لكن هذا أمر مختلف تماماً، فالمدينة مستقلة تماماً عن ساكنيها، إنها تعطي نفسها لكل الناس لكنها لا تتماهى معهم، أو تشبه أحداً ما.
متجددة كما نهرها "الچارون" الذي يتناسق مع شوارعها وجسورها فتشعر أنه جزء منها ولا يقسمها، لذلك لا تسمع عبارات مثل؛ "نسكن بعد النهر"، أو "قبل النهر"، أو في الشق الآخر، عكس نيويورك مثلاًًََ!
إلا أن هذا النهر العظيم حيث شاءت الصدف أن أسكن في عطلتي هذه مقابله، لم يكفه أن أرسلَ لي حشراته الليلية التي لا مفر من لدغاتها، كما لا مفر من صوت ضفادعه التي تبدأ في لحظة واحدة، وكأن هناك منبه يومي يجعلهم يبدؤون النقيق معاً، بل أرسل هذا النهر بضخامته أعظم نوستالجيا للمدن داخلي، إنها الجيزة في مصر والزمالك أيضاً وكثير من القاهرة.
إن للمدن توائم عليك اكتشفاها، وكل شارع في تولوز يذكرني بشيء في مصر، اليوم رأيت وسط البلد حول ميدان طلعت حرب، فتذكرت أن المباني هناك مصممة على النمط المعماري الفرنسي، وهذه الشجرات الخضراء حول النهر كما لدى نهر النيل.
إن نهر السين في باريس مختلف تماماً فلولا روايتيّ البؤساء والعطر، لما انتبهت إليه يوماً، لكن هذا النهر هنا يسكنك ويجبرك على إخراج الحنين، وإذا لم يكن حنينك إلى مصر فبالتأكيد سيبحث فيك حتى يجد حنينك الخاص ليصدره.
هذه التولوز تتركك صريع الحب والحنين؛ حبها هي وحنينك إلى مدن أخرى..
كم من المدن قابلت وتركتك على حريتك هكذا؛ فلا تقول لك كيف تشعر، بل تتشكل وتتغير مثل صلصال مع داخلك؟ كم من المدن تشم فيها رائحة مدن كثيرة أخرى؟ في تولوز عشت فجأة تحت شمسها بأبو ظبي، وشاهدت في مركزها برشلونة. لا أدري كيف، ولكن هذا ما يحدث للحظات ويختفي!
لن أقول أن ما ينقص تولوز البحر، لتكتمل أعجوبتها، فمن قال أن البحر تركها وحيدة، لقد تخلى عن شبحه لها. في بعض أحياء تولوز البعيدة عن المركز كنت أمشي وأنا اسمع صوت البحر وأشم رائحته، إنه فقط خلف هذه المباني وتلك الجدران، الهواء هنا هواء البحر.. شكل المنازل ولونها.
لا شيء يمنع أن يكون البحر هنا سوى ذاتك، فتولوز مدينة ساحلية مائة بالمائة وإلا كيف تحوز قلبك إلى هذا الحد إن لم يكن قد شُبه له.
هناك مدن أكبر من الإنسان ومدن أضيق منه، وهناك مدن تأتي على مقاس الإنسان، وهكذا هي تولوز، كافية كي يكون للفرد يقينه فيها.
إنها ليست على العهدة الفرنسية، بل هي الروح الأولى لفرنسا التي بقيت فيها، واختفت من المدن الأخرى.
تولوز لها غصتها العارمة، فهي ككل المدن الكبيرة؛ ليلها قاس، إنه ليل الغرباء، إذ تشعر فيه أنك وحيد بلا وطن أو أم أو أهل، أنت تنتمي فقط لموعد المترو أو الترام وإذا فوّته فكأنك فوّت أهلك.
تنظر إلى الوجوه القليلة التي حولك تحت أضواء عربة المترو القوية، جميع العيون بلا مآل نهائي، النهار هنا وطن، أما الليل فإنه ليل اللفظ والنكران، كأنك لا تعرف هذه المدينة، وكأنها المرة الأولى التي ترى هذه العيون الشاحبة من الحنين.
الذي لن تعرفه أبداً أن عينيك كما العيون المحيطة؛ هي أيضاً مجتثة من الوطن، وسكنتها الأماكن المؤقتة وليل الوحيدين.