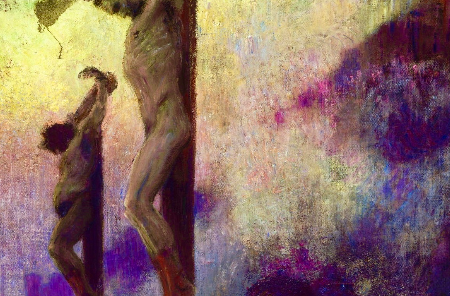لقد كان هذا الشهر شاقاً علي، لم أستطع كتابة شيء، الحقيقة إن ما يحدث يجعل عقلي يعيش في حالة تشويش غير مسبوقة. كنتُ أتصفح "الفيسبوك" حين رأيت ماريا أمين تعلن عن معرض رسم لها في "تل أبيب"، وهي طفلة من غزة؛ أُصيبت بشلل كامل بعمر العشرة سنوات، واستشهد شقيقها وعمها وجدتها ووالدتها في استهداف طائرات الاحتلال للقيادي محمد الدحدوح من "الجهاد الإسلامي" عام 2006.
ماريا الآن تدرس في مدرسة يهودية عربية، إسرائيل أعطتها ووالدها وشقيقها اللذين نجيا من القصف، هوية إسرائيلية، ويقيمون هناك، حيث يتوفر علاجها.
أتذكر جيداً يوم الحدث، كان الانفجار قوياً، وكنا نسكن في حي تل الهوى، جنوب غزة، حيث لا نبعد كثيراً عن منزل عائلة ماريا، ذهبنا للعزاء، وكان عويل النساء والرجال يضج بين الجدران.
استغربت وقتها من اسم العائلة وسأبقى أتذكر تلك اللحظة لأنني اليوم سأستغرب من جديد أن تعيش تلك الطفلة بين الإسرائيليين، لا استطع فهم الأمر كلياً، لكن هذا غير مهم طالما أن علاجها هناك يبقيها على قيد النجاة، ويعوضها قليلاً عن الألم الذي عاشته.
الاستغراب أيضاً كان إحساسي حين شاهدت تقريراً عن المحاكمة التي حضرها الدكتور عز الدين أبو العيش في إسرائيل، قبل شهرين، حيث رفع قضية ضد الدولة بعد مقتل ثلاثة من بناته، وابنة شقيقه في قصف إسرائيلي عام 2009 شمال قطاع غزة، وقد حضرها مع بقية عائلته الناجية، قادمين من كندا، وكان قبلها بعام قد قابل الرئيس الإسرائيلي.
لا يسمح لي ضميري بأن أطلق أحكاماً على كلا العائلتين، فقد ذاقتا عذاباً لن نشعر به إطلاقاً إلا إذا جربنا الفقد المرعب ذاته، لكن شعور الاستغراب ينبع من ذاك الاستعداد لتحييد الكره والألم، والتعامل مع العدو!
إن غزة مدينة غريبة قد يخرج منها تطرف يؤيد أقصى درجات التعايش مع إسرائيل، وتطرف يرفض حتى ذكره، وهذا يحدث حين يعيش كل هؤلاء في مدينة استثنائية ظروفاً استثنائية من الحصار والفقر والسيطرة المسلحة والظلم.
وليس بالضرورة أن مكاناً كغزة يجعلك متطرفاً دينياً، بل قد يجعلك أيضاً ملحداً متطرفاً، وليس بالضرورة أن يجعلك متطرفاً وطنياً، ولكنه يجعلك أيضاً عميلاً للمحتل متطرفاً بإخلاصه للخيانة، إن العيب ليس في المكان بل الظروف الاستثنائية وفقدان الإيمان برمز أو مثال في حالتنا الفلسطينية.
فإذا كانت حماس في يوم ما مثالاً للمقاومة والطهارة الوطنية، فإن دخولها معترك السلطة، ومسؤوليتها عن المُعاش اليومي قضى على ذلك.
أذكر حين جاء ناشط مصري لغزة في زيارة، وكنت أعرّفه على المدينة حين دخلنا لنشتري من أحد المحال، بدأ صاحب المحل يمتدح مصر، والشكوى من الوضع في غزة ويسب على الحكومتين، ومن ثم ترحّم على أيام الاحتلال وتمنى عودته، لقد صُدم الناشط يومها، وظل يحدث نفسه طوال الطريق "كيف لمن ذاق ظلم الاحتلال أن يترحّم عليه؟"، وشرحت له أن الأمر أعمق من ذلك، وأن التشكيلة الاجتماعية لغزة ليس من السهل قراءتها، فالناس أصبحوا أكثر قسوة على بعضهم بعد تجربتهم مع الحروب والانقسام، وغالباً الشعوب التي تمر بكارثة كبيرة تفقد ثقتها بكل شيء.
الوضع الآن أسوأ من ذي قبل، كما أن حاضر غزة على الدوام أفضل من مستقبلها، إنها تعيش "حم السكين" أي أقصى درجات ردود الأفعال جنائياً وأمنياً ووطنياً ودينياً، وفي هذه العاصفة جاء مصير ثلاثة عملاء للاحتلال من قطاع غزة شاركوا في اغتيال الشهيد مازن الفقهاء. وقد أصدرت محكمة الميدان العسكرية في غزة حكم الإعدام بحقهم، يوم الأحد الموافق 21 مايو 2017، وكان الحكم صدر خلال أسبوع واحد فقط من بدء المحاكمة التي اشتملت أربع جلسات، كما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان .
وأضاف المركز أنه تابع وقائع الجلسات، مؤكداً على أن المتهمين لم يتم إعطاؤهم حق الدفاع بشكل حقيقي، فقد ادعت هيئة القضاء العسكري أن المتهمين رفضوا توكيل محام، ولذا انتدبت المحكمة محام يعمل في النيابة العسكرية، والذي اكتفى بطرح بيّناته في جلسة واحدة، دون أن يطلب أي مهلة زمنية لإعداد دفاعاته. وتابع المركز "مما يثير شكوك حقيقية حول صورية المحاكمة".
وهنا يحضرني السؤال الأهم: هل سيوجد عملاء لو لم يكن هناك احتلال؟، كيف لنا أن ننسى البديهيات؟ كيف نطالب الشعب بالمقاومة والصبر خلال 11 عاماً من الحصار والفقر وغلاء الأسعار، ومنع السفر وضياع الأحلام وانتشار المخدرات، وننتظر منهم أن يكونوا ملائكة، وحين يخطئون لا نعطيهم فرصة للدفاع عن أنفسهم والتوبة؟ كيف نعاقب الناس بنفس السرعة التي نغضب بها وننتقم ونحن ندعي كل يوم أننا قادرون على إدارة شؤون البلاد؟.
قبل ثلاثة أسابيع اختفى قريب عزيز لي، طيب القلب، لم يتخطّ 22 عاماً بعد، بحث عنه الجميع، ليتم إعلامنا لاحقاً أنه تسلل عبر الحدود مع آخرين ليقاتل في سيناء، لم تجف دموعنا عليه؛ نحن ووالدته ووالده وشقيقاته، لقد كان يحمل حيرة الأسئلة وشعوراً بالتهميش حين جاء أحدهم ومنحه قوة من نوع مختلف.. قوة الطائفية وأنه يستطيع حماية دينه والأمة بالقتال مع الجماعة في سيناء.
نحن نحمّل الناس فوق طاقتها في وضع استثنائي، وحين لا يستطيعون، نقضي عليهم مرتين، مرة بالعقاب، ومرة أخرى بألسنة الناس. ضعوا أنفسكم مكان الشباب الذين لا يرون جديداً، ولا يسافرون، ولا يستطيع ذووهم توفير الحاجات الرئيسية بشكل لائق، ويعيشون يومياً في إطار خطاب ديني متزمت، وفي ظل عائلة هشمتها الحاجة ولم يعد هناك أحد يستمع إليهم. كيف لن يذهبوا إلى سيناء للقتال مع تنظيم الدولة، أو يقع بعضهم في فخ العمالة، أو يهربوا إلى الغرب ويعلنوا كفرهم بكل شيء من هناك!
قد تقولون أن الوطنية مبدأ، وأن الدين وازع، وليس لكليهما علاقة بالفقر والحاجات، ولكن ما الذي قدمناه لهؤلاء الشباب كي يحملوا هذا المبدأ وهذا الوازع؟ وكيف سيحترمون الوطنية أو الدين وهم يعيشون وسط انقسام واقتتال وتجريح وسب علني وكره متبادل وتدين شكلاني؟ أين هو نموذج الوطنية الذي سيكون قدوتهم؟ كيف سيغلبون سماحة الدين على شيطانهم إذا كان اليأس بلغ الحناجر، وعدم الإيمان بشيء عنوان مرحلتهم؟!
نحن بحاجة إلى استراتيجية اجتماعية وإنسانية ونفسية تنقذ أهل غزة من أنفسهم، نحن بحاجة لوعي سياسي ودبلوماسي للتخفيف من الضغط على الناس وفتح المعابر، في حاجة لبرنامج إصلاحي ينبذ العنتريات والبلطجة باسم السلطة، والخطاب الديني المتطرف. الشعب يحتاج "شمة نفس"، ولا تقولوا لي هناك البحر، لأن البحر أصبح راكداً كمستنقع تشم فيه كل شيء إلا النفس.
لقد وصلنا إلى ظروف اقتصادية صعبة، نادراً ما نشعر بها، طالما أن الكثيرين منا في راحة ولديهم راتب، ظروف تجعل المائة دولار إغراءً كي يصبح أحدهم جاسوساً للعدو، وتجعل وعداً بالسفر كافٍ لبيع الوطن والشرف.
وصلنا إلى مرحلة صعبة من الحصار الاجتماعي، وإطلاق الأحكام والتصنيفات، وتضخم التفاخر بالمثاليات وغرور التديّن، مقابل النميمة والحكم على الناس بالظاهر، وملاحقة السُمعة وإلتقاط الأخبار من موائد الآخرين، إلى درجة أن التهديد بـ"شات" على الفيسبوك يجعل عميلاً يرتعب ويسلم نفسه للمحتل.
يجب على الجميع أن يمارس شيئاً واحداً: "الحكي". سواء الحكومة أو الأسرة أو المدارس أو الأجهزة الأمنية، جيل الشباب يحتاج إلى نصيحة وتفهم، وأحد ما يستمع إليه، فلم يكن يوماً الحل الأمني رادعاً لأي شكل منحرف من التفكير أو الخيانة.
إن هؤلاء يحتاجون لأن يشعروا بالأمان كي يتركوا الماضي ويتغيروا، وليس الحل سعار انتقام من بعضنا البعض، ونتسابق من يفضح الآخر باسمه وصورته وعائلته، وننسى تماماً أن هناك احتلال خطّط لكل ذلك.
لقد وصل بنا الأمر إلى أن نقيم الطقوس للإعدام، وندعو الناس ببطاقات أنيقة، وكأننا في مدرجات الإمبراطورية الرومانية التي كانت تأتيها الجماهير للهتاف وتشجيع منازلات الإعدام الدموية.
لقد كان شهراً مغبشاً، تصدمني فيه رغبتنا في إلقاء أنفسنا إلى مزيد من التهلكة الدولية والعزلة، بدل تقديم نموذجاً بأن غزة رغم أنها محاصرة لكنها عادلة مع أبنائها حتى الخائنين والمخطئين منهم. لقد راكمنا خطاباً وطنياً ودينياً عنيفاً لنحصد اليوم ما زرعناه طوال عقد من الزمان، ولكننا لا نعترف، بل على العكس نُسَيّر أقلاماً حزبية ومراهِقة للمباركة، وننسى جميعاً أن العالم يرى.