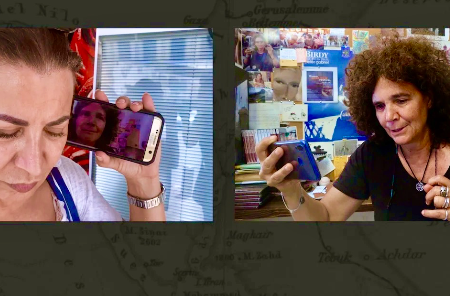من خلال فيلمها هذا، تواجه لينا شكلين من الصمت: صمت عائليّ ، يبدو أنّه تفرضه التقاليد، في عدم التعبير عن المشاعر، وكتمان الحميميّة، وعدم الرغبة في الحديث عن صعوبات الحياة الماضية، والمنفى، والعمل الشاق. وهو صمت مستمر وحاضر بقوّة لدى الجدّة كما لدى الجدّ. وشكل ثاني من الصمت، هو صمت رسميّ، يأتي من إنكار هويتهم في التاريخ الفرنسيّ الرسميّ كلاجئين من الأيدي العاملة.
حَملتْ المُخرجة لينا سويلم كاميرتها حين عَلِمتْ بقرار جدّيها الانفصال عن بعضهما البعض، بعد أن تجاوزا الثمانين، وبعد أكثر من ستين عاما من الزواج والحياة المشتركة. وكان هذا سعي حثيث من قِبلها للغوص في قصّتهما التي لا تعرف عنها إلا شذرات، وأطراف حكايات، وقصص مبتورة غير مترابطة، خلّفها صمتٌ مُزمن متراكم غمر حياتهما السابقة. فعملت على مدى مشاهد الفيلم على ملاحقة تفاصيل سيرتهما الغائبة بعين الكاميرا، وهذا في جوهره فعل ثنائيّ آنيّ مركّب يسعى للكشف أولا وللتوثيق ثانيا. والكشفُ نفسه هنا يأتي على مستويين، أولا أمام المخرجة وثانيا أمام المُشاهد ! ويحدث هذا بشكل آنيّ أيضا.
يبدأ الفيلم (المعروض حالياً ضمن مهرجان "أيام فلسطين السينمائية"، في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر 2021) بمشاهد حقيقيّة مأخوذة من الأرشيف العائلي لقريّة "تيير" الفرنسيّة التي عاش فيها جدّاها بعد أن أتوا من الجزائر للعمل والإقامة في فرنسا. تتوالى هذه الصور مصحوبة بتعليق المُخرجة عليها، ثم ننتقل إلى أول مشهد في الفيلم يحيل إلى الحاضر، وهو مشهد نقل أغراض، وبيت فارغ وشاحب، فيما يبدو أنّه نقل أثاث من بيت قديم إلى بيت آخر. لنفهم من هذا المشهد أنّ جدّها وجدّتها ينفصلان عن بعضهما لكنهما يقرّران العيش في بيتين منفصلين متجاورين! تطبخ له، وترسل الطعام إلى بيته، لكنها تعيش منفصلة عنه، وتستطيع بفضل ذلك دعوة صديقاتها للبيت وهذا ما لم يكن ممكنا حين كانا متزوجين! فيما يبدو أنّه تعايش إنسانيّ مع حالة قطيعة. وهذه الحالة المُربكة من الانفصال والتواصل تخلق مشاهد غنيّة، على مدى الفيلم، مشحونة بمزيج من التناقضات التي لا تتجاور عادةً: الارتباط والانفصال على مقعد واحد، العناية والجفاء في مشهد واحد، الصمت المشترك والنظر باتجاهين مختلفين في لحظة واحدة. ونصل كمشاهدين إلى الذروة حين نرى العجوزين المنفصلين يجلسان على مقعد واحد ويصعدان القطار الكهربائيّ، حيث ينظر كلّ منهما عبر نافذته، والفراغ يكاد يبدو شخصا ثالثا بينهما! لكنّ القطار الكهربائيّ يحملهما في نفس الاتجاه، ويصعدان إلى نفس المكان رغم المسافة العالقة بينهما. وفي مشاهد أخرى، يتبادلان بعض الكلمات من وقت لآخر، قبل أن يشيح كل منهما وجهه إلى الطرف المقابل، دون أن يكون هذا نفورا قاطعا، لكنه تعايش سلميّ مع حالة انفصال دائم. فما زالا مرتبطين بحاضر يخلق أواصر بينهما قائمة على المساعدة والمساندة الحقيقيّة، وغير المتكلّفة، لكنها في ذات الوقت تخلو من العواطف والمشاعر.
المشاهد السينمائيّة تأتي طبيعيّة، متقشّفة، يوميّة، في حديث يجري على مائدة المطبخ أو في الصالة. وهي حوارات تتوزّع على مدى الفيلم وتحاول المخرجة من خلالها إنطاق جدّها وجدّتها، من خلال وسائل وحيل نفسيّة تمنح الفيلم فنيّته وطابعه الإنسانيّ الخاص. فتعرض المخرجة لجدّتها صورة أمها، لترى ردّة فعلها. وهذا محاولة لنبش وتثوير ذاكرة راكدة عصيّة على البوح، لم تعد تمتلك من المفردات ما يمنحها القدرة على التنفيس والتعبير عن مشاعر مزمنة. وتأخذ لينا سويلم كذلك جدّها إلى عمله السابق في مصنع السكاكين، لترى ردّة فعله. وتُعرض له صور قريته في الجزائر لترى أخيرا عينيه دامعتين رغم أنّه كان يبدو بصدرٍ مغلقٍ طوال الفيلم، ولا يجيب على الأسئلة إلا بنعم أو بلا فقط.
من خلال فيلمها هذا، تواجه لينا شكلين من الصمت: صمت عائليّ ، يبدو أنّه تفرضه التقاليد، في عدم التعبير عن المشاعر، وكتمان الحميميّة، وعدم الرغبة في الحديث عن صعوبات الحياة الماضية، والمنفى، والعمل الشاق. وهو صمت مستمر وحاضر بقوّة لدى الجدّة كما لدى الجدّ. وشكل ثاني من الصمت، هو صمت رسميّ، يأتي من إنكار هويتهم في التاريخ الفرنسيّ الرسميّ كلاجئين من الأيدي العاملة. فجدّها يرمز لجيل كامل من العمّال الجزائريين الذي قدموا إلى فرنسا صغارا وعملوا في مصانعها، وسكنوا الأبراج العالية المنفصلة عن الأحياء الفرنسيّة، ولم يتم الاعتراف بمساهمتهم في الدولة الفرنسيّة، وتمّ بالإضافة لذلك تهميش قصّتهم. وكان المثال الساطع على ذلك، حين زارت لينا سويلم متحف مصنع السكاكين حيث كان يعمل جدّها طوال عمره، فلم تجد أيّ ذكر في المتحف عن العمّال الجزائريين الذي قضوا عمرهم بين جدران هذا المصنع، واكتفى المتحف بالإشارة إلى أنّ صنّاع هذه السكاكين العالية الجودة هم فرنسيون، وهم فخر للصناعة الوطنيّة. تعبّر لينا عن هذا المشهد كما جاء في حوار منشور في مجلّة رمّان قام به صالح ذباح: "وقف جدّي هناك في المتحف وقد خسر كل شيء عرفه في حياته، زوجته، عمله، ووطنه. أضحى وحيدا وهو في هذا السنّ ممتلئا بالحسرة". لذا لجأت لينا إلى الأرشيف العائليّ، وأدمجتْ صورا منه في الفيلم، فالبنسبة لها: "تلك الشرائط هي برهان وجود لكَ عندما تُنكر هويتك، ولذا أَعتبرُ مشروعي هذا نوع من المقاومة البصريّة"، لا سيما حين "تنشأ في دولة لا تتشارك معها في التاريخ لكن تتشارك معها في الثقافة".
الفيلم الوثائقيّ كخيار فنّي
كل فنّان يمتلك حساسيّة لشكل فنيّ خاص، يعتمده كخيار وأسلوب في أعماله. ولينا سويلم أدركت منذ وقت مبكّر أنّ الفيلم الوثائقيّ الطويل يجمع نزوعين عميقين لديها، وهما الهاجس التوثيقيّ والمحتوى الاجتماعيّ، من إشكاليّات الهويّة والمنفى والأصول العائليّة. تقول: "أردتُ البحث عن طريقي الخاص، لذا درستُ تاريخ العلوم السياسيّة، بعد أن درستُ الصحافة، وعملتُ في منظّمة لمهرجان حقوق الإنسان العالمي في بيونس إيرس، هناك اكتشفتُ الفيلم الوثائقيّ، الذي يجمع لديّ انجذابي للسينما واهتمامي بالإشكاليّات الاجتماعيّة، ثم كان انفصال جديّ في 2017 المُحفّز لكي أقف وراء الكاميرا". وإن كان موضوع الجذور والهويّة موضوعا شائعا في الأفلام بشكل عام والوثائقيّة بشكل خاص، إلا أنّ انفصال عجوزين في نهاية عمرهما، عن بعضهما البعض، وتَجاوُر هذا الانفصال هو أمر ملفت وخاص في الفيلم.
ورغم أنّ لينا سويلم، ابنة الممثلة القديرة هيام عباس والممثل الجزائري زين الدين سويلم، تروي لنا من خلال هذا الفيلم الوثائقيّ الحميميّ، بشكلٍ خاص، قصة جيل من العمّال الجزائريين، لكن الترحيب به تجاوز هذه الفئة إلى جمهور عام شدّته مفارقات انسانيّة تحتشد في هذا الفيلم، وتظهر بشكل ملفت في شخصيّة الجدّة، التي بدت ضاحكة مبتسمة، وكريمة مُحبّة، رغم أنّها افتقدت دائما لكلمات الإطراء والمحبّة من زوجها، مما دفعها للكتابة على ثلاجة المطبخ أنّها "أجمل جدّة في العالم" بخطّ يدها، بحثا عن إطراءات هي بحاجة نفسيّة لها.
بلا خطّة ولا سيناريو
الأفلام الوثائقيّة تقوم عادةً على سيناريو مُسبق، حتّى وإنّ تعرّض للتغيير والتعديل خلال التصوير، إلا أنّ لينا سويلم في هذا الفيلم قادت الكاميرا دون أيّ حدّ أدنى من التخطيط، أو أيّ شكل من أشكال السيناريو، بحيث كان المُشاهد يكتشف معها في ذات الوقت قصّة جدّيها، التي تتفرّع وتتخذ اتجاهات مفاجئة. إنها عمليّة تحرّي متواصل واستقصاء، وتوثيق بالصوت والصورة، وما يصاحبها من مشاعر مكبوتة. ففي الحوار المنشور في مجلّة رمّان، تقول لينا سويلم "كانت هنالك أحاديث حقيقيّة وجديّة، لم يُبن الفيلم بمنطق ميزانسين سينمائي معيّن، صوّر الفيلم بشكل طارئ مع كاميرتي وحدي، كنتُ أصوّر وأسجّل الصوت، واستعنتُ أحيانا بأختي وأبي وبعض أقاربي، حاولتُ أن أُفعّل عنصر الذاكرة في الحياة العائليّة اليوميّة...".
بدأت بعض صالات السينما في فرنسا بعرض فيلمها بدءاً من 13 أكتوبر، وقد شارك منذ صدوره في مهرجانات عربيّة وأوروبيّة متعدّدة، من أهمها Vision du réel وهو مهرجان للأفلام الوثائقيّة في سويسرا، ومهرجان الجونة السينمائيّ في مصر، ومهرجان عمّان السينمائيّ لأوّل فيلم، ومهرجان الفيلم الفراكفوني في فرنسا، ومهرجان L'International Documentary Filmfestival Amsterdam الذي يعتبر أهمّ مهرجان للفيلم الوثائقيّ في العالم، وغيرها من الأفلام. لينا سويلم تعمل الآن على فيلم بعنوان "مع السلامة طبريا" لتروي هذه المرّة ذاكرة عائلة أمّها في فلسطين، وهي تشير أنّ هذا كان أيضا "استجابة لحالة طارئة وحاجة نفسيّة بليغة".