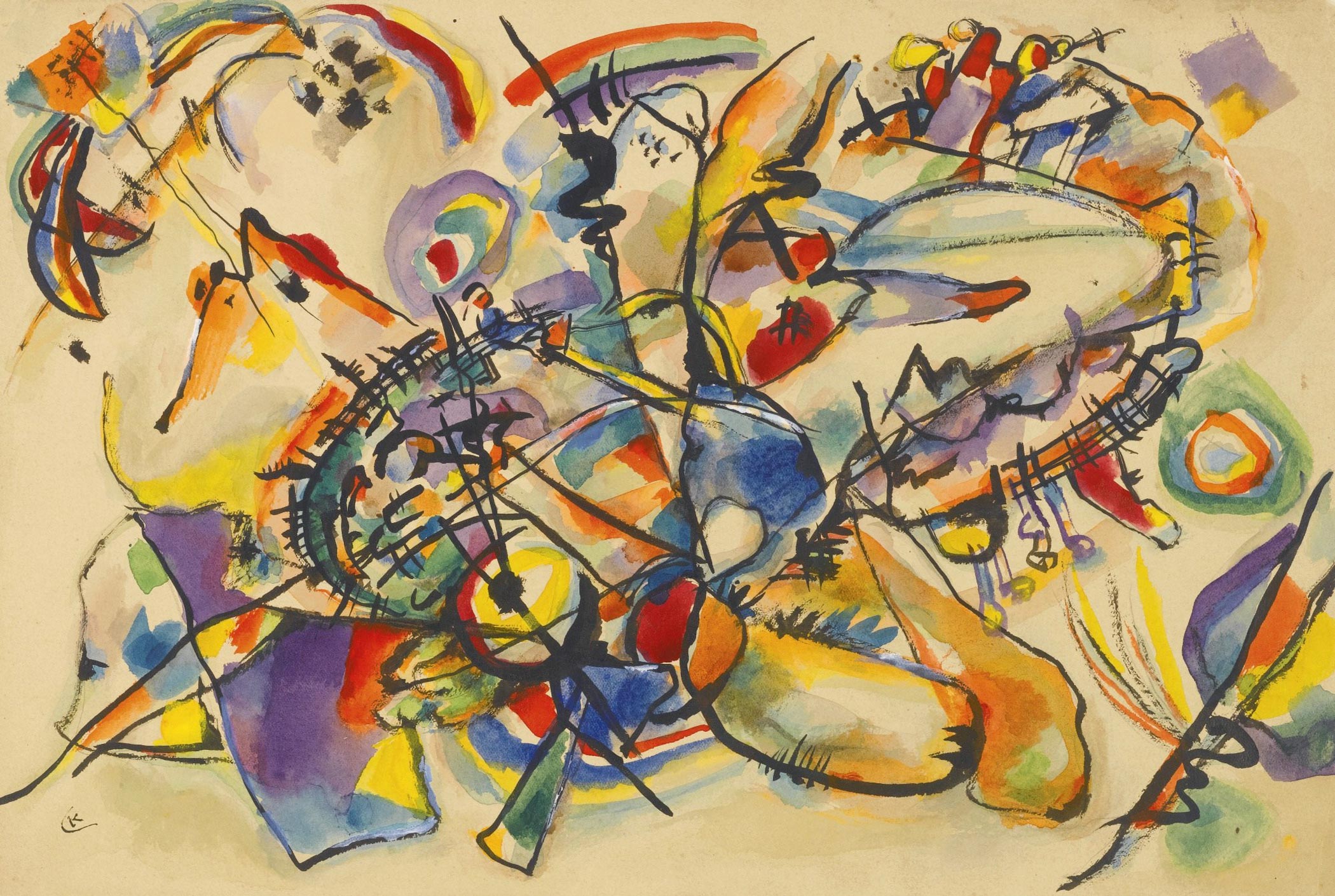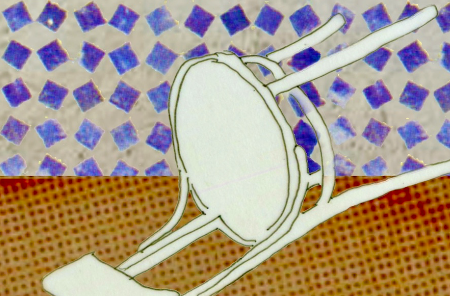الرّسالة الخامسة
عزيزي،
صباح الخير .. أو مساء الخير ففي الأُسبوعِ الثّامنِ مِن منعِ التّجولِ تصبحُ الحياة والموت سيان.. يحصدُ الوباء أكثر مِن مليون روح وأكثر من ثلاثة ملايين مصاب.. فيما ننشغلُ نحنُ ببقاء لا يُحتمل.
"عندما يستعدُ الوطن للعودةِ، عاديات المنفى سوف لَنْ تُلْزِمَنَا، فقط استعادة الحنين وحقيبة سفر كل ما نحتاج". اقتبست ما قالته شاعرة فلسطينية لأُخبرَ أصدقائي منذُ أكثرَ مِن عشرينَ عاماً حين زرتُ عكا صيف 1999 عن البلاد.
لم يترك أبي لنا غير المنفى والقلق وأمل بعودةٍ لا نعرفُ متى؟ لم يترك لنا بيتاً نحتمي بين جدرانه من الزّمن، فكلّما هممتُ بالانتقالِ من بيتٍ لآخر، ألملم بعضاً منّي وبقايا أثاث منه وصناديق كثيرة من الأسرار والأوراق الثّبوتية. لم يورثني أبي بيتاً ولا سيارةً ولا حياةً كاملةً، دوماً هناك ناقص وغياب.. لم أرث غير اسمي ووثيقة اللاجئين، بعضٌ مِن ملامحه، قدرٌ كنعانيٌّ، وصمودٌ كما عسقلان، المدينة التي رسمت خطوطها في الجينات الخاصة بنا، وبعضٌ مِن حُلْمٍ وأملٍ بعودةٍ باتت تؤرّق منامنا.
تخبرني أُمّي أنّي بنتُ أبي، فأنا أشبهه تماماً.. كلّما تأملتني وأنا غارقة في هذا الحُلْم تبكي على هذا القدر وهذا التّشابه. حيوات غير مكتملة، منافي تضييقُ بنا، أحبّة غائبين، وخوف من قادمٍ يشي بالأمل.. قالت أُمّي يوماً حين مزّقتُ بعضاً مِن منشوراتٍ سريّة كنتُ أُخبّأها في سلّةٍ قشيّةٍ بين نافذتي ونافذة الجيران "كما أبيكي ستعيشين مطاردة بين المنافي وأحلامك ".
كلّما حاولتُ بناء بيتٍ لي ورسم ملامح تشبهني، كانت تقول: لا تتعلّقي به فهو كأبيكِ غائب.
ما هذا المستقبل الذي أراده أبي، ما الذي فكّر به حين اسماني" بيسان " هذا الاسم الكنعاني الحزين، كُلّما نطق به حبيبي شعرَ بالفقدِ مِن شدّةِ الجمال. كلّما اقتربنا ابتعدنا. كُلّما هممنا بالعودة اتسع المنفى.
عدتُ قسرا للمنافي، صار السّؤال: أليسَ الوطنُ مستعداً لعودتنا، هل نحن لسنا مستعدّين لذلك؟ هل في منفانا بقايا حياة يجبُ أنْ تُعاشَ دون أنْ أُدركَ أنّ "ما يزال وطني محتلاً".
في الحقيقةِ، طيلةُ رحلتي الأولى للبلادِ وأنا انتظر تصريحاً مِن المحتلِ بعودةٍ ولو لساعاتٍ، على طولِ معبر ايريز على حدود غزة الذي انتظرتُ عنده قُرابة عام لأتمكّن من رحلةٍ إلى ذاكرةِ الأجداد. كانت الأسئلةُ تدورُ في رأسي عبر الممرّ الحلزوني الزّجاجي الذي يفصلُ غزة عن الضّفة الغربية. تلك الرّحلة التي لم أكتب عنها شيئاً خوفاً مِن أنْ تنتهي؛ فالحكايات تنتهي حين نخبرها للآخرين! هكذا عاهدتُ نفسي ألّا أُخبر تفاصيلها لأحد كي تظلّ تسري في الرّوحِ وتركن في مكانٍ قصيّ في أقصى الذاكرة وتملأني بالأمل.
كان عليَّ في أقلِّ مِن 48 ساعة أنْ أجوبَ تاريخاً ممتدّاً منذ عام 1948 وحاضراً ، كيف ستكون رحلتي؟ نظراً للحدودِ والحواجزِ والمستوطناتِ التي قسّمتْ بلدات الضّفة أدركت بخيبةِ أملٍ وهي أني سأزور رام الله فقط، أضعت قرابة 12 ساعة على الحواجز لأصلَ مِن غزة إلى الضّفة الغربية.. لم يكن لديّ متسعٌ مِنَ الوقتّ!
وأنا انتظر بعض الرّفاق في مقهى " زرياب" الذي ترتاده النّخب الثّقافية في رام الله كانت لحظة الحسم، قال رفيقي "استعدي للسّفرِ إلى القُدسِ والنّوم في أحضان جبل الزّيتون"، ودونَ أنْ أدركَ معنىً للوقتِ ولا الزّمان ولا الاحتلال أسرعتُ إلى سيارته التي ستقودني عبر الجبال لتفادي الحواجز والمحاسيم، بَلْ إِنَّنِي سَأَبِيتُ ليلتي في الأرضِ المقدّسة، هي بالفعل مُقدّسةٌ حين تراها من أعلى قمةِ جبلِ الزّيتونِ. بيوتها وأزقّتها وكنائسها ومساجدها وتلك القبّة الذّهبية التي تحتضنها السّماء في آخر النّهار.. كُلّما اقتربتُ احترقتُ شوقاً ولهفةً وخيالاً يعجزُ الشّعرُ أنْ يصفَهُ. تقتربُ رويداً رويداً تحتضنك المدينة كُلّها وكأنك ترى حبيباً يفتحُ ذراعيه ليلملم تعبكَ بين يديه، وكان لقاؤنا الأول.
ما بين القُدسِ وعكا محطتي الأخيرة -محطة أخي الأولى- بكيتُ خوفَ أنْ لا أرى تلك البلاد مرّةً أُخرى. كانت عكا آخرَ ما أبصرتُ بعد رحلةٍ دامت أشهُراً ولم اكتفِ، لكنّه كان قراراً بالعودة إلى ذاكرتي وليس ذاكرة أجدادي. صار المكان مكاني ولي فيه ما أريد، أعرف تفاصيله التي حفرتها بيديّ وليس بالصّور أو حكايات الجدّات كلّما اشتد الشّوق لديهن وكبرنَ في منافيهنَ.
"عكا" المدينة التي استعصت على الجميع وخرّ ساجداً كلُّ مَنْ أرادَ اقتحامها دون إذنٍ مسبق، دون أنْ يُلقي على أهلِها السّلام أو يرمي القرابين في بحرها لتفتح ذراعيها طوعاً له. رميتُ قُرباني لديها وعلمتُ أنّي سأرجعُ يوماً ما لأنّ موجها قبّل قدماي حين رحتُ أُداعبُ البحر على شاطئها.
كذلك فعلَ أخي في رحلته الأولى القصيرة حين تعرّفَ على زوجته في غزة وهي تزورُ بعض الأقارب، عرفَ حينها أنّها ستكون امرأته وإنْ طالَ الزّمن، وحين سافر لرؤيتها في عام 2000 أخبرها عند البحر: سأمنح البلاد أطفالاً فلسطينيين مثلك، ولن أقبلَ أنْ يُمنحوا وثائق لاجئين. هذا عهد بيني وبينك وكانت المدينة شاهدة على ذلك. 12 عاماً عُمر زواجهما. تقابلا مرّةً أُخرى في 2005 لإتمام عقد القِران، أكمل مراسم الزّواج حين أرسل عقد وكالةٍ لقريبٍ لها بأن يتزوجا في فلسطين المحتلة، ويكون اللّقاء الأوّل كأزواجٍ في المنفى. ولسنوات صار يلتقيها في شرم الشّيخ يعيشانِ قُرابةَ الشّهر سوياً ثم يفترقانِ ليُكملا السّنة عبر أدوات التّواصل الاجتماعي.
رُزِقا بطفلين؛ يزن، الطّفل الذي أصرّ أبويه أنْ يولدَ في فلسطين المحتلة حتى وإنْ مُنح جنسية اسرائيل، تلك الدّولة التي حرمته مِنَ الذّاكرة والتّاريخ، تلك الدّولة التي حرمت أخي مِن أنْ يرى ابنه يستقبلُ حياته الأولى حين يبصرُ البلاد؛ ومرّةً أخرى حين حرمته أنْ يرى ابنته لجين حين استقبلتها البلاد. كان عزاؤه في المنفى أنه جنّب أبناءه المصير نفسه بأن يكونا لاجئين، تلك الوصمة التي ترسم على ملامحنا زمان ومكان وتاريخ وجغرافية لا تشبهنا.
عشر سنوات في المحاكم الإسرائيلية خلالها ثلاث مرّات هجرة لبلاد بعيدة؛ بلادٌ لا تستقبل الأم وابناءها تارةً، وتارةً أُخرى تقابل أخي بالرّفض التّام. لم يجتمع شمل تلك الأسرة ساعات قليلة إلا في الإنترنت، تصحو العائلة يومياً على الهواتف الخلوية، ويظلّون على هذه الحال حتى يناموا. يرتّب أخي وزوجته أمر تلك العائلة عبر الإنترنت يُذاكر ويلعبُ ويحكي ويأكل مع ابنائه عبر كاميرات السّكايب والفايبر والواتس والماسنجر.
الحياة توقّفت في شكلها الطّبيعي. الأطفال يخرجون في مظاهراتٍ لجمع الشّمل تقوم بها أُسر فلسطينية تواجه المصير ذاته. أكثر مِن 30 ثلاثينَ ألف عائلةٍ ممزّقة بين هنا وهناك، بين المنافي والبلاد، بين الضّفة الغربية وغزّة والبلاد المحتلة، الجميع وجد في الإنترنت فضاءً يقرّبُ شمل العائلة.
كانت عبارة "خطر يهدد أمن اسرائيل" تعتلي ملفّه كلّما تقدّم إلى المحكمة، ذلك لأنه يحمل اسم "عدوان"، الاسم الذي اقترن بمقاومة الاحتلال. كيف سيُقنعُ دولة الاحتلال، التي قتلتنا مرّاتٍ ومرّات ولا تزال، أنّه يريد أنْ يعيشَ بين ابنائه؟ كيف يخبرهم أنّه أصبح كهلاً لن يقدر على المقاومة بعد الآن! ماذا يُخبر أطفاله حين يتابعون معه حرب غزّة والثّورة وفلسطين؟ كيف سيتقبّلونه بعد سنواتهم العشر عبر الإنترنت أباً لهم من لحم ودم؟
أعرف أنّ أحوالنا ليست على مايرام ولا تلك البلاد التي تحيا فينا، تلك التي ورثنا انكسارها وهزائمها في فترات تشبه تلك التي جاءتنا في القرن العشرين مع الجراد والمجاعات والكوليرا والتيفود والاحتلال واللّجوء والهروب.
رغم الوباء والمنفى والعزل الانفرادي لا أزال أحبُّ تلك البلاد، تلك المدن، وذلك البحر الذي يطوي أسرارنا، فحين يزوم ويصرخ في الرّيح ويوشوشني بتلك الحكايات عن النّاس والبلاد والغائبين، أخاف الرّحيل الذي بات يُطاردني كجواز سفري "لا بيتَ، لا حُبَّ، لا حياةَ لكم، أنتم مطرودون، أنتم غرباء، أنتم ملعونون بهذا الحبِّ.. لعنة تلك البلاد ستُلاحِقنا، سأظلُّ أهربُ من كُلّ القصص والحكايات التي لن تشبه البلاد وحنطتها ومخملها وصخبها وضجيجها وسكوتها ووجعها وأنينها وروحها التي سرت فينا منذ آلاف السّنين وتركتنا منذ 1400 عاما ويزيد.
سأظل أكتبُ رسائلَ حتى تعود الحكايات للبلادِ، فانتظرني.
الرّسالة السّادسة
عزيزي،
مساءُ الخير أو صباحُ الخير سيان ففي العزل تتوقفُ عقارب السّاعةِ عند آخر مشهد صباحي تجوّلتُ فيه بالمدينةِ لشراء حاجاتٍ لمواجهة الحظر الكُلّي الذي صار يُزينُ مدينةَ التّلالِ السّبع "اسطنبول" ، فهي المدينة التي بُنيت على سبعِ تلالٍ، يعلو كُلُّ تلّةٍ مسجدٌ كبيرٌ.
في العزلِ والمنفى تفقدُ الكثير منك.. يقلُّ الكلامُ، ترتفعُ درجاتُ حرارتِكَ، يدبُّ البردُ بينَ أوصالكَ، يمرُّ الوقتُ في المنامات ملاذك للحنين، تزورك الكوابيس ليلاً، وتدركُ الصّباحاتِ مِن زهرةِ عبّاد الشّمسِ التي ترسلُها لي كُلَّ نهار عبر الهاتف الذّكي لتُبقي الشّغف عند حدّه الأدنى، ولكن ما أنْ يحلَّ اللّيلُ يُداهمني حُزنٌ عميقٌ، تماماً كما "كلوني اليونانية" حورية البحر التي شغفها حبُّ أبولو، وهو يخرجُ بعربتِهِ مِن أبوابِ السّماءِ في كُلِّ صباحٍ مُمسكاَ بأعنّةِ جيادِهِ الأربعة، فيغمرُ الكونَ بأشعةِ الشّمسِ المشرقةِ، وما أنْ غابَ حتى صارت زهرة شمسيّة عاشقة تنتظرُ حبيبها كُلَّ صباح علّهُ يعود مرّةً أُخرى.
ألم أُخبركَ بعدُ أنّ صاحبَ الورد التّركي مات؟! لم يتحملْ جسده العجوز الوباء، أخبرني الشّاب الذي ورث الورد والدّكان عنه، حين اشتريتُ منه قصيص مِن زهرةِ عبّاد الشّمسِ لأعتني بها في البيت لتؤنسني حين يُداهمنا الموت.
في الأُسبوع العاشر مِنَ الجائحة وأعداد المصابين لا تزالُ تملأ شاشات التّلفاز والمواقع الالكترونية بجانبِ مؤشراتٍ بانخفاض عدد النّاجين والموتى تارةً وازدياد أعدادهم تارةً أُخرى، لا نعرفُ بالضّبط.. فقدنا الشّغفَ بتفاصيل الحياة اليومية.
في بلادِ الأناضول صرنا نخرجُ من حجرٍ كُلّي إلى آخر، ومن منع تجوال إلى منعٍ جديدٍ وكأنّ هناك مباراة بين أولي الأمر على ادارة البلاد، لا أعرف بالضّبط، فأنا لم أجد التّأقلم بعدُ كما لم أجد اللّغة التركية.
في الوطن كما في المنفى يحضرني درويش "أجلس لا سعيداً.. لا حزيناً بين بين.. ولا أُبالي إنْ علمتُ بأنّني حقاً أنا أو لا أحد". الحزنُ ليس سيئاً، الحزنُ يُصفّي الرّوحَ ويحدّ البصرَ، ويهدّئ النّفسَ فتنجلي الحقائق.. عندما تحزنُ وحدكَ فأنت تدركُ أنّ لا أحدَ في المشهدِ وأنّ الحيوات التي عِشتها منذ أربعين عاماً وربما سبعين عاماً هي محض خيال صنعناه مِن أجلِ النّسيان. وما بين بين تُقام في داخلي مجازر لا تتوقّفُ منذُ رحيلي القسري عن البلادِ حينَ خُتِمَ على جواز سفري بالحزن.
أكثرُ مِن ربعِ قرن مضى على زيارتي الأولى للبلاد، زرتُ فيها حيفا برفقة صديقتي الفلسطينية الحيفاوية في زيارةٍ تاريخيةٍ خاطفةٍ، وسرّيةٍ. دخلتُ البلاد دون تصريحٍ مِن دولةِ الاحتلال، ودونَ تدابير وإجراءات مِنَ السّلطةِ الفلسطينيةِ، دخلتها عنوةً وبدون موافقةٍ مِن أحد، عدتُ إلى البلادِ، عدتُ لأرى ذاكرة جدّتي وأصنعَ ذاكرةً خاصّة. دخلتُ حيفا ليلاً كعادتي التي رافقتني طِوال سنيني التّالية.. حين أزورُ المدنَ أدخُلها ليلاً فإنْ صحوت صرتُ مِن أهلها. تنفّس الصّبحُ سريعاً، عصّبتْ صديقتي عينّي وأخذتني لشُرفتها وأزالت الغمامة فانجلت حيفا وكرملها مثل امرأةٍ تسلبُ العقل والرّوح، تسمّرتُ أمام الشُرفةِ وأنا أرقبُ البحرَ والجبلَ والمدينةَ السّاحرةَ، ومن شدّةِ الوله بكيتُ، تعجّبتْ صديقتي من ذلك وسألتني متعجبة، أتبكين؟ كانت الكرمل أولى بناتي، وحيفا حين استراح الجبل على شاطئها.
حيفا، مدينةٌ مثل طائرٍ اسطوري فردَ جناحيه على البحرِ ليَلِدَ دُرَّته. تجوّلتُ فيها وحفظتُ عن ظهرِ قلب كُلَّ المباني والطّرقات والشّوارع والأماكن التي أخبرتني بها صديقتي: تلك مدرسة السّباعي، والمدرسة الإسلامية، وتلك مقبرة "الاستقلال" كما يسميها الصّهاينة، والتي كانت مُلكاً لآل القطّ، وتلك عمارة آل عابدي في شارع "ستانتون" وأُخرى في شارع "سيركن"، وها هي دار نفاع، كيّلو، رنّو، بكير (من أصل طيراوي)، وها هو جامعُ الحاج عبدالله (أبو) يونس، يطلُّ شامخاً مِنَ الحليصة، وها هي السّرايا، مقر القائمقام، وها هي أملاك دار الخمرة - الصّغير في درج الأنبياء، والجدع والدّحبور وتوما وطوبي والقلعاوي والزّعبلاوي وأبو زيد وخوري وصهيون وكوسا.
ها هي ساحةُ الخمرة غرباً إلى سكّة الحجاز (عامود فيصل شرقا). تخرجُ منها داخلاً إلى حارةِ الكنائس معرّجاً على "السّرايا"، مُتجوّلاً في سوقِ الشّوام حيث كنيسة الرّوم وجامع الجرينة، ثم تخرجُ منهما إلى شارعِ العراقِ، وبعدها تستطيعُ التّنزه في حارة "أرض اليهود" عابراً شارع سيركن ونزهة والبرج لتدخلَ المدرسة الإسلامية "مدرسة الجمعية" لتصل إلى محطةِ الكرمل لترى البساتين عبر شارع القشلة وابن الأثير لتنتقل بعدها عبر الموارس إلى بوابة الدّير ومِن ثمّ إلى وادي النّسناس، وفي الطّريق ترى حديقة البهائيين وحين تنتهي المدينة المقدسة لبهاء الله تدرك أنّ الله استراحَ في حيفا في اليوم السّابع.
هذه الرّحلة القصيرة التي أخذتك إليها تجعلك تفقد الإحساس بالزّمان والمكان، تجدُ تاريخك وهويتك وفلسطينيتك، تجعلك أمام التّاريخ، تستنطقه ليُخبرك عن أخبار ضاهر العمر الزّيداني ورشيد الحاج ابراهيم، عبد الرّحمن الحاج، والقسّام وغيرهم من الأسماء التي تعجز ذاكرتنا عن احتوائها، وتخبرك البنايات والرّقعات المهدومة والحجارة بكُلِّ ما حدثَ في ربيع 1948 وما قبلها.
أتعرف أنّي أقطن بجوار حارة تسمى "زقاق إزاك" بالطّبع كانت حارة يقطنها يهود تركيا الذين عاشوا أكثر من 500 عامٍ هنا حتى عام 1942 حين انتقم القومويون الأتراك دفعة واحدة مِن كُلِّ الذين لم يكونوا أتراكًا، فخرج الشّوام واليهود مِن تركيا وخسر الأتراك دولة متعددة الشّعوبِ وأسّسوا جمهورية؛ وأنذروا المقيمين مِن غير التّرك بأنَّهم لا يحقّ لهم "سوى أنْ يكونوا عبيداً" فرحل الجميع ولم يبقَ غير بضعة الآف منهم ومباني وشواهد بطول البلاد.
كان عليّ كلّما سمحوا لنا بالخروج مِنَ العزلِ لبضعِ ساعاتٍ أنْ أجوبَ الشّوارعَ للتعرّفِ عليها؛ وتدريباً على الكلامِ كنتُ أحاولُ تهجئة اليافطات في الحي؛ كان ذلك يساعدني على فهم كُنه اللّغة في محاولةٍ منّي لأكتشاف العربية منها، أتعرفُ أنّ هناك 4000 مفردة عربية في لغتهم، فاللّغة صوتُ البلاد.. كم هي قاسية.
يذكر كاتب تركي يهودي وهو "ماريو ليفني" في كتابه "إسطنبول كانت أسطورة": "لم يكُنْ أحد يستطيع تحديد اللّغة التي تتحدّث بها إسطنبول". كانت اللّغة الييدية وكذلك اليونانية والأرمنية والفرنسية والعربية هي ما يسمعها المرء في شوارع المدينة."
لا يزال يعيش في عاصمة مضيق البوسفور عشرون ألف يهودي من اليهود الشّرقيين، في حين كان يعيش مائتي ألف يهودي في جميع أرجاء البلاد قبل حوالي مائة عام. هؤلاء اليهود حافظوا على لغةٍ جلبوها معهم فيما مضى مِن بلادٍ عاشوا بها. وبوسعِ المرء أنْ يُميّزَ تلك اللّغة ببساطةٍ. ففي فصل الصّيف تلتقي، على الجزرِ الأميرية أو في المقاهي الممتدة على ضفافِ مضيق البوسفور، سيّدات مُسنّات ونشيطات لاحتساء الشّاي ولعب الورق، ينتقلن فجَأةً مِنَ الحديث باللّغة التّركية إلى لهجةٍ إسبانية مدهشة تُعرف باسم لادينو Ladino ، حافظوا عليها منذُ العصور الوسطى وإلى يومنا هذا.
مدينةٌ مليئة بخرائب تحكي قصة إسطنبول بلغات غريبة، تحكي عن بيوت خشبية آيلة إلى السّقوط وما تزال تسكنها أرواحٌ قديمة لا أستطيع أنْ أراها لكنّي أشعر بها حين تتجوّل الذّاكرة في مدن سكنتني، وعرفت كيف أسبر أغوارها: حيفا، يافا، عكا، القدس، غزة، دمشق، القاهرة، الاسكندرية، بورسعيد، فإسطنبول، المدينة المجروحة.
الرّسالة السّابعة
عزيزي،
اليوم فُتِحت البلادُ وسُمِحَ لنا بالخروجِ والذَّهابِ إلى العملِ والتّسوق والمحلات التّجارية والمطاعم وأماكنِ عامّةِ أُخرى، كم أشتقتُ لهذا الضّجيج الجميل.. أعرفُ أنّك لا تحبُّ كُلَّ هذا الصّخب، ولكن بعدَ منع التّجوّل والحجر الصحي وفترات العزل الطّويلة.. فالضّجيجُ مرادفٌ للحياةِ.
في بلادنا، هُناك مساحةٌ ضيّقةٌ للبوحِ، كُلّما زادت الحرية، ضاقت العبارة. فحينَ تَبوحُ النّساء، اعْلَمْ أنّ هُناك أحكامٌ مُسبقةٌ توصمُ بها، ربما تصلُ للقتلِ على خلفيةِ الشّرفِ. لكنَّ الرّسائل التي نكتبها للأصدقاء والغرباء نافذة لبقاءٍ يُحتملُ وطوقُ نجاةٍ مِنَ الموتِ البطيء.
في فترةِ العزلِ كانَ البحرُ هو الذي يُناديني، أعرفُ أنّ البحرَ قريبٌ مِنَ البيتِ الجديدِ، أشعرُ به، أشمُّ رائحتهُ، أبحثُ عنه كُلّما خرجتُ في ساعاتِ المسموحِ بها لشراءِ الطّعامِ، يُبصرني مِن فوق التّلالِ.. أمشي باتجاه الزُّرقةِ غير المحدودةِ، لكنّي أتوه ولا أصلُ إليه إلا قليلاً.
أتعرفُ أنّ أيمن صفيّة ذلك الرّاقص الفلسطيني الذي كانت فسحتهُ الوحيدةُ هي البحر، كانَ يرقصُ علي الموجِ ويُخبّئ البحر في عباءتهِ؟ منذُ أيامٍ غابَ في البحرِ ولم يعُد، لم تنقذه شرطةُ الاحتلالِ لأنّهُ ببساطة ليس يهودياً.. هكذا ردّت سُلطات الإنقاذِ على صاحبيه حين استنجدوا بهم: هل هو عربي أم يهودي؟
نام صفية بين الموج إلى الأبد، كانت كُلُّ تهمته أنّه فلسطيني، بينما البحر كان حنوناً عليه وأعادهُ إلى البلادِ، إلى شواطئ طنطورة. وطنطورة تعني المسكن بالكنعانية.
وحدة ألكسندروني في الجيش الإسرائيلي بمفردها اقترفت في 23 مايو 1948 مجزرةً بحقّ أهالي قرية الطّنطورة، قضاء حيفا غداة احتلالها، وقتلت 230 فلسطينياً في المجزرة وهجّرت باقي أهلها البالغ عددهم 1700 فلسطينياً إلى الضّفة الغربية وبلاد الطّوق.
أنْ تكونَ فلسطينياً يعني أنْ تُصابَ بالشّقاءِ الجميل، صفيّة أخذته البلاد وعادَ لها، والبحرُ طريقُنا للعودةِ، والبحرُ يا عزيزي هو مستودعُ أسرارِنا وأمانينا، يأخذُ الكلامَ ويسري به إلى الله. ما الذي باح به أيمن صفيّة للهِ قُبيلَ غيابه؟
في منفاي القسري والعزلُ الإجباري أخافُ أنْ أُخبرَ اللهَ بما أُريدُ، فالبحرُ يغيّر الأمنيات. كُلّما ساقنا الشّوق للبوحِ تتغيّر المسارات والأقدار، لن يحتملَ عقلي وقلبي تلك العاصفة التي تجتاحنا، فالبحرُ في بلاد الأناضول ليس كبحرِ البلادِ.
في حضرة البوسفور، الصّمت أفضلُ مِنَ البوحِ، هناك شيء بيننا عصيٌّ على الفهم. "فأنا لستُ صوتاً انتخابياً، وأنا لستُ مواطناً، بأي شكلٍ مِنَ الأشكالِ، ولست منحدراً مِن صُلبِ دولةٍ تسألُ بين الفينةِ والأُخرى عن رعاياها.."، نحنُ فقط أبناء أرضِ البرتقال الحزين، لن نعرفَ متى أو كيف يؤخذ مِن اختلافك معهم حرباً تُمحي معها مدن وتُهزم البلاد.
سبّبَ رحيلُ أبي، لأكثرَ مِن خمسٍ وعشرين عاماً دون علمٍ مسبقٍ، خوفاً شديداً لنا، كيف رحلَ وتركنا في تلك المنافي، لم يحتمل عقلهُ حين صافحَ أبو عمار بيريز وشامير في البيتِ الأبيضِ في منتصفِ التّسعينيات؛ رأيته يقفُ خلفَ المحل الزّجاجي الذي كان يعرض شاشات جديدة للتّلفاز وقمّة واشنطن تُعقدُ لتصفيةِ الحُلْمِ، تركَ يدي وأنا صغيرة ونسيني، مشى هائماً كالمجنونِ يصرخُ ويبكي قائلاً "راحت فلسطين".
كانَ عليَّ أنْ أتصلَ بأُمّي لتأتي إلى وسطِ البلد وتقلّني إلى البيتِ الذي يبعدُ عن العاصمةِ قُرابة 40 دقيقة، رحلَ مِن يومها ورحلَ معهُ الأمان وترك غضباً لم ينتهِ إلا بموته.
سنواتٌ مِنَ الغضبِ والخوفِ ملأت منافينا.
لم يتصل إلا بعد عشرة أعوامٍ حين أخبرنا أنه حيٌّ يُرزق وأنّه يعيش في ليبيا؛ حاولت أُمّي رغم غضبها أنْ تُخيط الجرح الذي سبّبهُ لنا ذلك الرّحيل وأنْ تُخبرنا أنّ أباكم تم ترحيله، لكن تلك اسطورةٌ نسجتها لنا، كان في الحكايةِ بعضاً من الحقيقةِ حيثُ فقد إقامته في المنفى فكان عليه الرّحيل إلى بلادٍ تقبله كلاجئ.
ذات يومٍ حَصَلتُ على مِنحة لدراسةِ الأدبِ في السّوربون، فقامت أُمّي ببيع كُلَّ محتويات البيت لتوفرَ ثمن تذكرة الطّائرة، وجمعتُ وأخي مبلغاً من المال لنتصل به دولياً عبر السّنترال لتأتي اجابته قاتلة، تلك الإجابة غيرّت مسار العائلة، لكنّي احتفظت بالغضب الجميل، أي نعم، إنّه غضبٌ جميلٌ وموجعٌ، يظلُّ وجعه يرتديك حتى يوم مماتك ويرسم كُلَّ ملامح حياتك القادمة. إجابته كانت: " بدك تصيعي في باريس ويقولوا عن بنتنا ضاعت". كانت إجابته مفترق حياةٍ بالنّسبة لي ولإخوتي.. أحسستُ لحظتها أنّ أبي غير الذي عرفناه.
ما بين الغضبِ والحبِّ كان حُلْماً جميلاً لا يُخان. فالحبُّ ليس رواية شرقية في ختامها يتزوّج الأبطال، الحبُّ أنْ تظلَّ على الأصابعِ رجفةٌ وعلى الشّفاهِ المُطبقاتِ سؤالٌ. أما الغضبُ فيُغشى البصر، ولكن ما أنْ ينحسرَ حتى يصبحَ بإمكانك أنْ ترى الأشياءَ بجلاءٍ أكثر مِن أيِّ وقتٍ مضى.
الأمرُ أشبهُ بحركةِ المدِّ والجزرِ، عندما ينحسرُ الماء كاشفاً عن كُلِّ الأشياءِ الغارقةِ الملقاة هناك طِوال الوقت: زجاجاتٌ محطّمةٌ، قفّاراتٌ قديمةٌ، عبواتُ صفيحٍ صدئة، عظامٌ، وأشياءٌ تراها حين تجلسُ في الظّلامِ وحيداً بعينينِ مفتوحتينِ، غافلاً عمّا يخبأه لك المستقبل.
عشرة أسابيع مِن جائحة كورونا، رسم العزلُ والوحدةُ خارطةً جديدةً للحياةِ، أُصيبَ الجسدُ باليباسِ، فيما القلب تقاطرَ بداخلِ تلك الحيوات التي عِشتُها. كانَ الخروج اشبه باسترجاع ذاكرة الدّهشة، لم يعد هُناكَ مُتسعٌ للصّمتِ، البوح هو الملاذ الآمن للبقاء، فقط علينا أنْ نُدرّبَ أنفسَنا على النّجاةِ مِنَ المؤقت، من الهامشِ الذي خُتم على جوازِ السّفر، ففي العزلِ لن تخش أنْ تُخبر الآخرين عن الحكاية.. فمن يملكُ الحكايةَ يرثُ الأرضَ.
الآنَ يجبُ أنْ أعودَ إلى البيت.. هبط اللّيلُ وأنا أخافُ ظلام اسطنبول، أخافُ أنْ أتوهَ في البلادِ الغريبةِ.