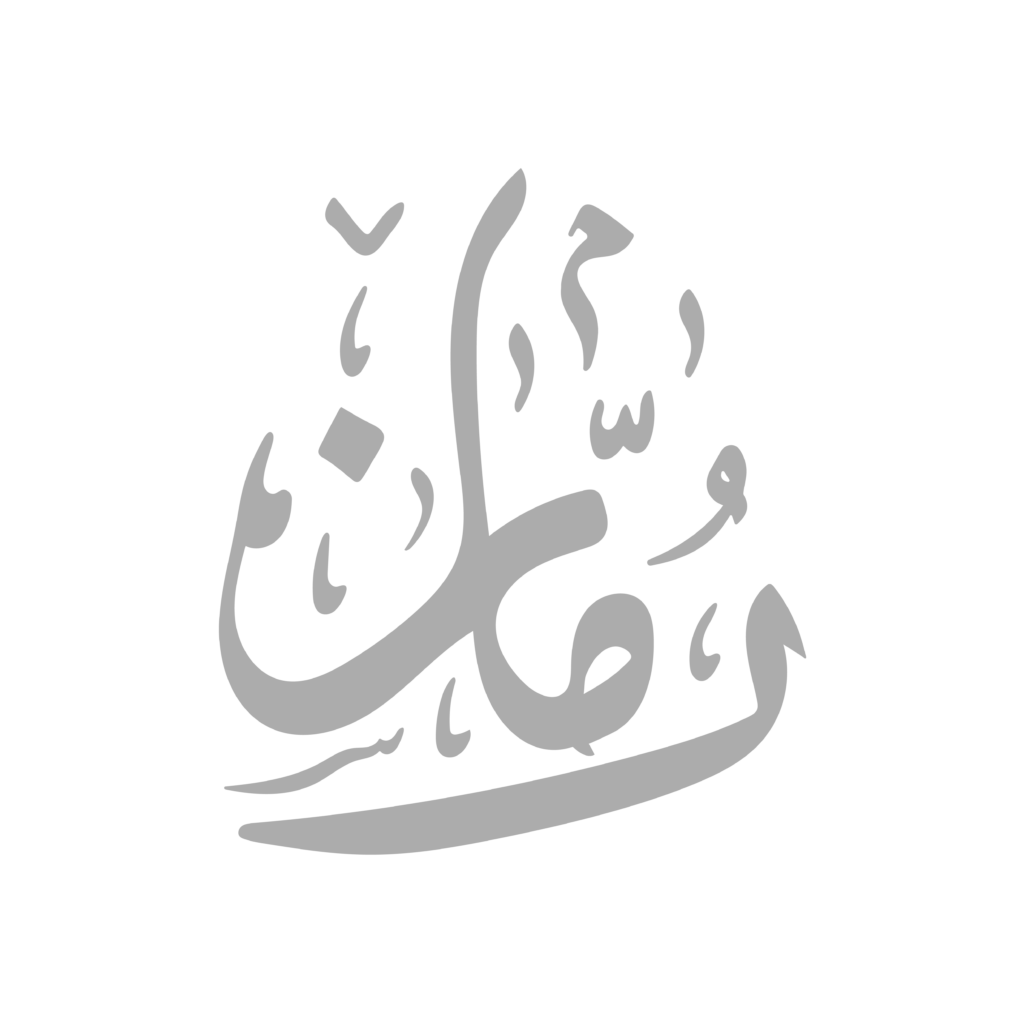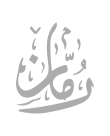منذ النكبة، عمل المشروع الاستعماري الإسرائيلي على محو الذاكرة الفلسطينية، سواء عبر تغيير أسماء القرى، أو تدمير البنية التحتية، أو تجريف الأرض، أو الاستيلاء على الأرشيف. في المقابل، يشكّل التوثيق البصري الذي يقوم به الأطفال اليوم خطّاً دفاعياً غير متوقع ضد هذا المحو. إذ يبدو أن الأطفال في غزة لم يكونوا "يُصادَفون" في المشهد الإعلامي، بل يصنعون حضورهم بأيديهم، بعدساتهم، وبأنفاسهم اللاهثة وسط الركام، ذلك أنهم وفي خضم العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، وبينما كانت الطائرات تُمزق المباني، كانوا يحملون هواتفهم المكسورة ليوثقوا ما لا يُوثق؛ فقدان الأهل، تدمير المدارس، تشظي الحياة اليومية، وتمسك غريزي بالحياة وسط العدم. لم يكن هذا التوثيق محض صدفة، ولا مجرد صرخة في العتمة، بل ممارسة رمزية عميقة تعكس إدراكًا مبكرًا لمعنى الكينونة في مواجهة المحو. أمام هذا الفعل المتكرر، لا تعود الصورة مجرد انعكاس للواقع، بل تصبح أداة لبنائه وتحديه، ونموذجاً يحيل إلى تلاشي الحد الفاصل بين المدني والمقاتل، بين الطفل والراوي، بين الضحية والشاهد.
في السياق الفلسطيني، لم تعد الطفولة مساحة آمنة محايدة، فقد برز حضور الأطفال الفلسطينيين على المنصات الرقمية بوصفهم شهوداً مباشرين، لا ضحايا فقط. لقد تحولت عدسة الهاتف المحمول إلى سلاح بيد طفل لا يتجاوز العاشرة، كان يصوّر لا لأنه يعرف ما هي "الذاكرة الجمعية" أو "البروباغندا المضادة"، بل لأنه يشعر أن عليه أن يفعل شيئاً. لم تكن هناك حاجة إلى كلمات كثيرة؛ العيون المرتبكة، الملابس المغبرة، الخلفيات المنهارة، كلها كانت كافية لرواية الحكاية. يتحدث أطفال غزة أمام الكاميرات عن العدالة، والحصار، والقصف، وحتى الشهادة، معلنين رفضهم للاقتلاع، لا لأنهم أُقحموا في السياسة، بل لأن الحرب اقتحمت طفولتهم. لتتحول هذه الصور والمقاطع بدورها إلى مادة للذاكرة أو إلى "أرشيف شعبي" بديل، وعفوي، يخرج من الهامش ليشكك في صحة المصادر "الرسمية"، وإلى أدوات لبناء سردية وطنية متماسكة. بالتالي، فإن فعل التوثيق ليس لحظة عابرة، بل خطوة أولى في استعادة المدينة، والكرامة، والعدالة، وهو تحدٍ للمحو، وإحياء رمزي لمن رحلوا، ولمن بقوا على قيد الوجع والكرامة.
حين يفتح الطفل بثاً مباشراً من خيمة متهالكة، أو ينشر صورة لبيته المدمّر، فإنه لا يمارس البوح فقط، بل يخلق سردية مغايرة، يتحدى بها رواية المحتل ومفردات الإعلام الدولي، وقد بات ممكنا ملاحظة وجود تصاعد لافت في استخدام الأطفال الفلسطينيين للهواتف المحمولة لتوثيق تفاصيل حياتهم اليومية في ظل القصف. لا تقتصر هذه المواد على مشاهد الدمار، بل تشمل أيضاً لحظات من اللعب، والرسم، والغناء، وحتى الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم. وهي ممارسات لا تقاوم الموت فقط، بل تصرّ على الحياة بلغة صامتة، لكنها أكثر بلاغة من الخطب. لا يكتفي الأطفال الغزيون بالتعبير عن الألم، بل يصوغونه بلغة بصرية تتحدى السرديات الجاهزة، لقد اخترعوا أصواتهم، وعدساتهم، وسردياتهم، وبينما يحاول العالم أن ينساهم، فإنهم يلتقطون صورهم ليبقوا. في هذا المشهد، تتحول الطفولة، التي تعاملها المنظومة الاستعمارية بوصفها خطراً كامناً، من رمز للضعف إلى فاعل يحمل رسالة رمزية كثيفة، وتشكل امتداداً وجدانياً ليس فقط لمحاولة النجاة، بل إصراراً على الاحتفاظ بما تبقّى من عوالم الأطفال ومحيطهم. فلا يمكن اختزال ما يقوم به أطفال غزة في توصيفات سطحية مثل "مقاومة ناعمة" أو "توثيق شخصي"، ذلك أن ما نشهده هو فعل سياسي وثقافي وأخلاقي عميق، يعيد تعريف مفاهيم الطفولة، والمقاومة، والسرد، والمكان.
كما أن هناك ثمة مفارقة جوهرية في فعل التوثيق هذا؛ ما يبدو هشًا في الظاهر -بكاء طفل، صرخة أم، خيمة مُمزّقة-يتحول إلى قوة سياسية كاسحة حين يُوضع في مواجهة الصمت الدولي أو التواطؤ الإنساني، ولا يعود مشهداً من البؤس، بل اتهاماً صريحاً للمنظومة التي تقبل بهذا الموت كأمر واقع، وتعرية للخطاب "الإنساني" حين يُفضي إلى الصمت أو الحياد. إذ لا تقتصر ممارسات الأطفال على التوثيق المباشر، بل تمتد إلى التمسك بعناصر الحياة التي يحاول القصف محوها، حيث تُشير اللحظات التي يوثقونها إلى أنهم لا يتمسكون بالألعاب والدمى والحيوانات الأليفة فقط لأنها تمنحهم السلوى، بل لأنها تمنحهم المعنى. فالدُمية هنا ليست لعبة، بل رفيقة بقاء، ووسيلة لحماية الطفولة من الاندثار. والاحتفال بعيد ميلاد في خيمة مؤقتة ليس مناسبة عابرة، بل إعلان واضح بأن الحياة مستمرة، رغم الدمار، والطفل حين يبكي أمام الكاميرا لا يُظهر ضعفه، بل يُدين العالم الذي تركه وحيداً، وحين يبتسم رغم الدمار، فإنه لا يستسلم، بل يتحدى ويربك المنظومة الإعلامية، ويُحمّل الإنسانية مسؤولية تاريخية.
في لحظة الخراب الشامل، وبين زوايا الركام، حيث تتهشم البيوت وتتناثر الأحلام، تولد صورة. ليست مجرد صورة عابرة، بل مشهد يحمل العالم كله في نظرة طفل صغير يحتضن قطة بين يديه، فيما تُصرّ طفلة على لبس فستان العيد، وتحتفظ أخرى بدُمية فقدت يدها في القصف. هذه الأفعال البسيطة، العابرة ظاهرياً، هي في جوهرها إعلان عن الكرامة، واستعادة للذات، وتمسك بالحياة. هؤلاء الأطفال لا ينتظرون أن "يُنقَذوا" فقط، بل يشاركون في صناعة الرواية، وفضح الجريمة، والحفاظ على الأمل، وممارسة أرقى أشكال المقاومة، وهذه الصور القادمة من وسط أزقة غزة المدمّرة، تختزل ما تعجز عنه تقارير المنظمات الدولية، وما لا تستطيع نشرات الأخبار إيصاله. هي ليست وثيقة فقط، بل فعل مقاومة رمزية صامتة، تُصرّ على سرد الحكاية بلغة البصر لا بلغة البنادق، إنها لحظة مكثفة من الحياة، في مواجهة منظومة تسعى إلى النفي الكامل؛ نفي الجسد، ونفي الصوت، ونفي الذاكرة.
مئات، بل آلاف الأطفال في غزة باتوا يوثّقون لحظاتهم اليومية أمام عدسات هواتف محمولة، أو عدسات مصورين أجانب أو محليين، دون أن يدركوا ربما أنهم يُشاركون في صناعة واحدة من أعقد روايات العصر. في كل مرة يظهر فيها طفل فلسطيني يتحدث بوعي مفاجئ عن العدالة، أو يصرخ من خيمة النزوح أنه لا يريد مغادرة مدينته، يتحول من "موضوع" أو "مادة" للرثاء إلى "فاعل" ثقافي وسياسي. يزعج ظهوره هذا النظام العالمي الذي يحب أن يرى الأطفال ضحايا، لا شهوداً، يريدهم صامتين، لا ناقدين. لكن هذا الطفل، الذي يصور مدرسته المهدّمة، أو يحمل دميته المحروقة، أو ينقل عبر "بث مباشر" لحظة إسعاف أهله، يخلخل هذا التصور، لا يعود ضحية وحسب، بل شاهداً يعرّي جُبن الصمت، ويُربك التواطؤ الأخلاقي. ولعل الفضاء الرقمي، الذي غالبًا ما يُتهم بالسطحية، صار بالنسبة لهؤلاء الأطفال ساحة نضال لمن لا يملكون منصات إعلامية كبرى، ولا يكتبون المقالات، لكنهم يلتقطون اللحظة، ويُحمّلونها معنى، ويفرضون على العالم أن يرى الواقع من دون فلتر، ومن دون مونتاج.
هذا النوع من التوثيق لا يُشبه التوثيق الصحفي التقليدي؛ إنه أقرب إلى "البوح السياسي"، حيث يتحول البكاء إلى خطاب، والمشهد الشخصي إلى اتهام أخلاقي للمنظومة الدولية. وحين تتكاثر هذه الصور، تُصبح جداراً مضاداً لمحاولات المحو الممنهج التي تعتمدها القوة الاستعمارية. فالمحو ليس فقط عبر القصف أو التهجير، بل عبر السرد، وعبر صناعة ذاكرة بديلة تُفرغ الفلسطيني من المعنى، وتُعيد تمثيله ضمن قوالب جاهزة؛ الضحية الضعيفة، أو "التهديد الإرهابي". أما الطفل الذي يوثق لحظة فقده، فإنه يُنتج حكاية مضادة، ويُعيد للمدينة هويتها، وللمخيم ذاكرته، وللأرض اسمها. بذلك، تنقلب الصورة من استعطاف إلى مساءلة، ومن وجع فردي إلى موقف جمعي، ومن ذاكرة شخصية إلى سردية مقاومة. وحتى حين تنتهي الحرب -أو تتوقف مؤقتاً- لا تتوقف هذه الأفعال، بل إن الصورة التي صنعتها براءة الأطفال قد تتحول إلى وثيقة، وربما إلى دليل في محكمة مستقبلية، وقد يصبح هذا الطفل، الذي التقط صورته يوماً على أنقاض بيته، معمارياً يعيد ترميم المكان، أو كاتباً يعيد حياكة السرد وصياغة الحكاية.
فالصور التي بدت بسيطة وعابرة، كانت في واقع الأمر البذرة الأولى في مسار طويل نحو استعادة الذات، ونحو الانتصار على النسيان. ولعل ما يلفت النظر في هذه الصور هو أنها تُعيد تعريف مفاهيم الطفولة، لا بوصفها مرحلة من البراءة، بل كمرحلة من الإدراك المبكر للفقد، ومن التعلم السريع لكيفية أن تكون إنساناً في عالم يصرّ على نزع الإنسانية عنك. وهذا ما يجعل من كل صورة لطفل غزي ليس مجرد حالة توثيق لحظي، بل تعريفاً جديدًا للحياة في وجه الموت، وللأمل في مواجهة القهر، وللوجود في مواجهة المحو. وهنا تكمن المعجزة؛ أن يولد جيل في قلب الحرب، ويختار أن يبوح لا أن يصمت، أن يكتب تاريخه بالصورة والصوت والحركة، أن يروي الحكاية على طريقته، لا كما يُراد لها أن تُروى، وهذا الفعل مهما بدا بسيطًا، لكنه في وجه الاحتلال، فعل وجودي بامتياز.