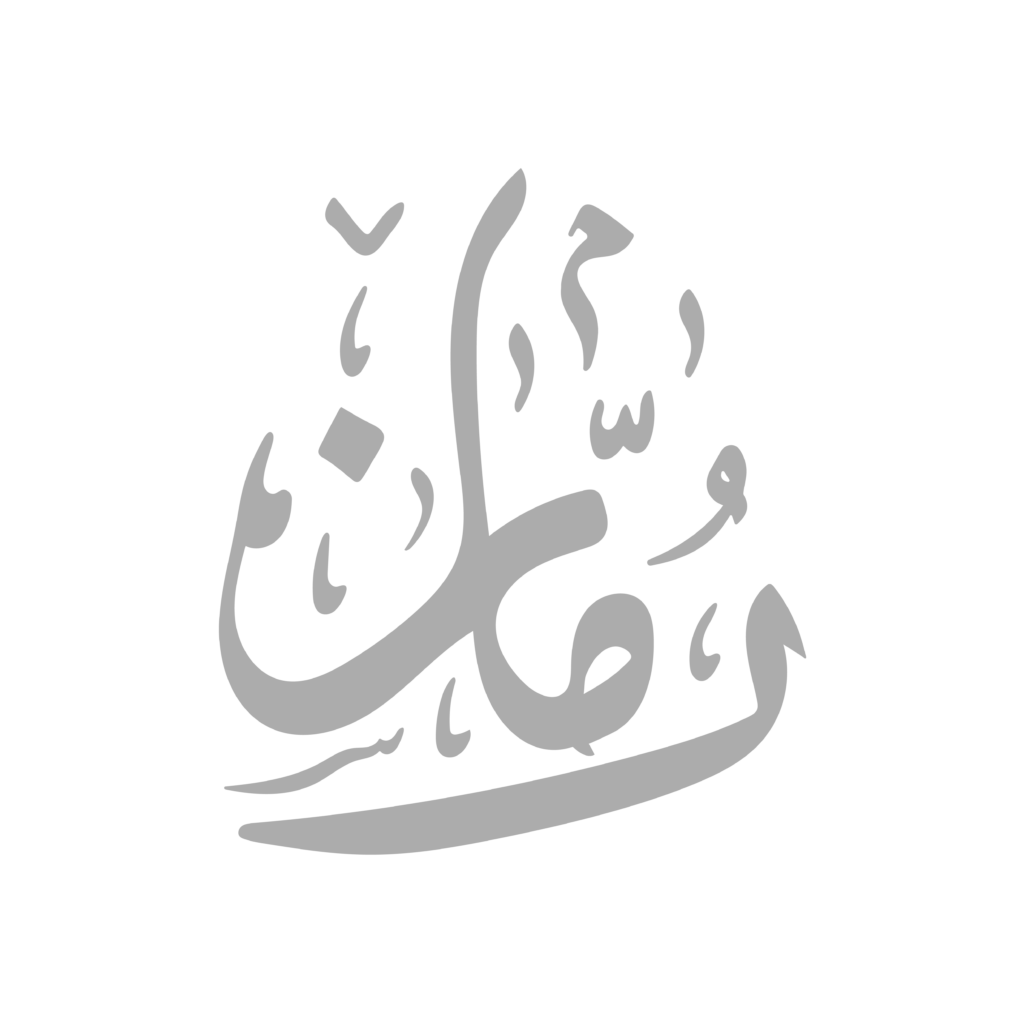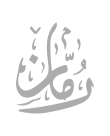في الأنظمة الشمولية ، لا تقتصر السلطة على أدوات القمع الخشنة، بل تمتد إلى آليات هيمنة ناعمة تُنتج سردياتها الخاصة، وتُعيد تشكيل الوعي الجمعي بما يخدم استمراريتها؛ ليبرز "مثقف السلطة" بوصفه أداةً مركزية في تأبيد البنية الاستبدادية، من خلال تبرير السياسات، وتشويه المعارضة، وصياغة خطاب عقلاني يبدو كأنه من صُنع نخبوي مستقل، بينما هو في جوهره صدى مدجّن لأوامر رأس الهرم السلطوي. وفي المقابل، يبرز لدينا "مثقف الدولة" الذي ينتمي إلى فكرة الدولة بوصفها مؤسسة، أي كيان مستقل عن الحاكم، ويعمل على خدمة استقرارها، وسيادتها، ومصالحها العليا وترتيب روايتها أمام الإعلام بما يتناسب مع المنطق والحقيقة، ويبتعد عن مصالحه الخاصة لصالح العامة. قد يكون قريبًا من النظام السياسي، لكن ولاءه ليس مطلقًا له، بل مقيد برؤية طويلة المدى تتجاوز الأشخاص. غير أن الحدود بين "مثقف السلطة" و"مثقف الدولة" ليست دومًا واضحة، فثمة مثقفون خدموا في مواقع رسمية، لكنهم حافظوا على قدر من النزاهة الفكرية أو السلوك الأخلاقي، مما يجعلهم في موقع يستحق التفكيك لا الإدانة الفورية.
تنقلنا هذه المقدمة والحديث عن نمطين للمثقف السياسي، إلى الحديث عن فاروق الشرع بوصفه مثقفًا سياسياً ودبلوماسيًا من الرعيل الأول في سورية، والذين عاصروا حكم الأسد الأب والأسد الابن؛ وروى في الجزء الثاني من مذكراته "مذكرات فاروق الشرع 2000-20215" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢٥) شهادات على مراحل حساسة ومفصلية في تاريخ سورية المعاصر، والروابط بين القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والأجهزة الأمنية في البلاد لتشكيل ملامح السياسة الداخلية والخارجية وإشرافها على ملفات حساسة لا سيما ملفات لبنان والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى عرض صراعات السلطة وشخصيات القيادات وعلاقاتهم بالأنظمة العربية والدولية؛ وصولًا إلى الثورة السورية 2011، والاجتماعات الغنية والحساسة التي شارك بها والخطابات المتوازنة التي ألقاها في عدة مناسبات دولية.
في عُرف نظام الأسد، لا يُمنح المثقف بأي صفة يحملها ، سواء دبلوماسية أو سياسية أو اجتماعية تقليدية، هامشًا للمعارضة أو حتى النقد البنّاء. بل تُعاد صياغته ليكون صوتًا وظيفيًا، يستعير مفردات التحليل والعقلانية ليخدم رواية السلطة. "مثقف السلطة" ليس بالضرورة بوقًا مباشرًا للقمع، لكنه غالبًا ما يكون شريكًا في شرعنته، باسم الدولة، وباسم الهوية، وباسم التاريخ أحيانًا. يُنتقى من بين النخب القادرة على الصياغة، على التبرير، وعلى تمرير القسوة بلغة الحرص، والانغلاق بلغة السيادة، والموت بلغة القدر الوطني. يختلف فاروق الشرع عن هذا النمط من المثقفين، لا سيما وأن الشرع لم يكن على ذات الصفحة التي كان عليها بشار الأسد، سواء اقتصادياً، أو أمنياً، أو حزبيًا، أو سياسيًا.
وعلى الرغم من أن أدوات فاروق الشرع في تصدير خطابات الدولة أمام المحافل الدولية كثيرة تبدأ من الانتقاء التاريخي، والتصنيم الرمزي للرئاسة السورية، والحديث عن المفاهيم الكبرى كالديمقراطية والسيادة والاستعمار، إلا أن الشرع لم يتبع منهج مثقف السلطة القائم على التبرير الأخلاقي للعنف، وتسويق الرواية الرسمية كحقيقة مطلقة، وتشويه المعارضة بوصفها مشروعًا خارجيًا، أو حتى صناعة خطاب "نخبوي" مزيف يدّعي الموضوعية.
إنّ دبلوماسيًا مثقفًا مثل فاروق الشرع ليس ظاهرة جانبية، بل هو جزء بنيوي من جهاز الحكم، وضروري للسلطة كي تبدو متزنة، وقاسية، ولكن عقلانية. ولذلك، حين نتحدث عن فاروق الشرع، فإننا لا نحاكم شخصًا فقط، بل نحاكم نموذجًا لمثقف جمع بين الثقافة والدبلوماسية، ووقف على حافة الهوية بين الدولة والسلطة، دون أن يتجاوزها.
بين الدولة والنظام؛ واجهة العقل وضريبة الصمت
وُلد فاروق الشرع في محافظة درعا السورية عام 1938، ودرس الأدب الإنجليزي ثم العلاقات الدولية، ليصعد سريعًا في السلم الدبلوماسي السوري، متحوّلًا إلى أحد أعمدة السياسة الخارجية السورية من السبعينيات وحتى بداية الألفية. وعلى مدى عقدين، مثّل الشرع وجه سوريا الرسمي في محافل دولية كبرى، من مدريد إلى جنيف، مقدمًا خطابًا عقلانيًا بدا ،مقارنة بسلوك النظام ، أكثر تهذيبًا واتزانًا. تميّز بلغته الدقيقة، وبلاغته المدروسة، وحرصه على تقديم "الدولة السورية" كفاعل عاقل، بعيد عن الفجاجة الأمنية التي طبعت النظام في الداخل.
لكن خلف هذه الواجهة، لم يكن الشرع سوى أحد تروس ماكينة السلطة. فقد دافع، بوعي أو تحت الإكراه السياسي، عن رواية النظام في أكثر اللحظات دموية: مجزرة حماة، قمع الإسلاميين، وملف توريث الحكم. لم يُسجل له يومًا اعتراض علني، ولم يستقل حين بدأت سلطة الوراثة تهمّش جيله من البعثيين. ظل على ولائه لبنية الحكم، وإن كان بطريقته الخاصة: خطاب عقلاني دون عنف لغوي، لكن دون فعل سياسي مستقل. ومع صعود بشار الأسد، بدأ نفوذ الشرع في التراجع، لينتقل في 2006 إلى منصب "نائب الرئيس للشؤون الخارجية"، وهو منصب بلا صلاحيات حقيقية، أقرب إلى الإخراج البروتوكولي لإنهاء دوره دون كسره علنًا.
وجاءت الثورة السورية عام 2011 لتضع كل المثقفين الرسميين أمام اختبار حاسم. وكان الشرع أبرز هؤلاء. فقد انتظر السوريون أن يكون صوتًا أخلاقيًا، أو وسيطًا ممكنًا. لكنه اختار الصمت، تحت ضغط الالة القمعية للنظام الأسدي البعثي، وفاروق الشرع هو الذي اختبر وعرف هذا الآلة ومآلات معارضتها سواء. يُقال إنه رفض التوقيع على بيان يُهاجم المتظاهرين، فتم تهميشه وإقصاؤه بهدوء. لم يظهر بعدها سوى مرة واحدة في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013، وألقى خطابًا بدا وكأنه اعتراف بالعجز أكثر مما هو موقف. هذا الصمت الذي استمر لعشر سنوات، يفتح تساؤلات مؤلمة: هل كان الشرع مثقفًا عاجزًا؟ أم سياسيًا مأزومًا؟ أم بيروقراطيًا أخطأ في الحسابات وبقي في الظل يدفع ثمن تردده؟
ليس الغرض من تناول تجربة ومذكرات فاروق الشرع إصدار أحكام أخلاقية مبسطة: هل هو خيّر أم شرير؟ بل المطلوب هو تفكيك البنية التي جعلت من رجل مثل الشرع بثقافته، وخبرته، وخطابه الهادئ مجرّد ظلّ في نظام لا يسمح بالضوء إلا للولاء المطلق. الشرع لم يكن من زمرة القتلة، ولم يتورط، بحسب الشهادات التي أظهرها كتابه والكلمات التي عبرت عن ذاكرته، في التخطيط الأمني أو التعذيب أو الفساد. لكنه في ذات الوقت أيضًا لم يخرج عن النص الذي حددته سلطة آل الأسد، لم يُصادم، لم يحتجّ، لم يستقل. بقي داخل الحدود المرسومة له، وبقي صمته في لحظة الحقيقة علامة على الأزمة الأخلاقية التي يعيشها مثقفو الدولة حين لا يعود هناك فرق بين الوطن والنظام.
تجربة الشرع تلخص مأزق "مثقف الدولة" في نظام قائم على العائلة والمخابرات: إما أن تنخرط بالكامل في ماكينة الولاء، أو أن يتم تهميشك. ليس هناك منطقة وسطى. وإن وجدت، فهي مجرد انتظار بطيء للنهاية. في هذا السياق، يُمكن قراءة الشرع كشخصية حاولت أن تخلق فرقًا في حدود الممكن، لكنها فشلت، أو لم تمتلك الإرادة الحاسمة لفعل ذلك. وربما كان يدرك حجم البنية السلطوية التي يواجهها، فاختار الانكفاء على الذات، بدلًا من الاصطدام معها. لكن هذا الخيار ، في منطق التاريخ والعدالة، لا يعفي من المسؤولية، ولا يمنح صكّ البراءة.
إن مأساة الشرع، شأنها شأن مأساة كل مثقف رسمي في الأنظمة الاستبدادية، تكمن في أنه يظل مرهونًا بالسلطة حتى حين يبدو أنه يخدم الدولة. وهكذا، حين تتغيّر المعادلات، ويأتي زمن الأسئلة، لا يعود المثقف الذي صمت يُنظر إليه بوصفه حكيمًا، بل كشاهد لم يتكلم، كشريك صامت في الجريمة، أو على الأقل كشائنٍ لفرصةٍ ضائعة.
في محكمة العزلة
لحظة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث أعادت فاروق الشرع، الرجل الذي عايش قلب النظام السوري لأربعة عقود، ليطلق شهادته الثانية على زمنين متداخلين: زمن الدولة وزمن الانهيار. المثير أن صدور الكتاب تزامن مع حدث تاريخي غير عابر: سقوط النظام السوري نفسه في عام 2025. لكن هذا التزامن لا يندرج ضمن سيناريوهات اختيارية، بل هو محض مصادفة، إذ أن الشرع كان قد أنهى كتابة الجزء الثاني منذ عام 2019، وركن بعدها إلى عزلة طويلة في منزله الدمشقي، بعيداً عن الضوء، شاهداً على انطفاء الدولة التي ساهم في بنائها، ومراقباً بمرارة ما خلفه "الوريث". الوريث الذي لطالما وصفه الشرع بالسايكوباتي، ووصفه السوريون بالقاصر، الذي أودى البلاد إلى هلاك وارتهانات بيد دول عدة.
مذكرات المثقف هذه المرة ليست مجرّد وثيقة سياسية، بل هو عمل ثقافي إنساني خالد في جوهره، يتيح الدخول إلى خفايا آل الأسد ودهاليز القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتفاصيل وفاة واغتيال أصدقاء سياسيين وأمنيين رسموا معالم سورية الحديثة إلى مدة غير بعيدة ، وأسسوا لمستقبل انتهى بسقوط النظام البعثي. إنه نصّ يعيد تعريف مفهوم "مثقف الدولة" لا بوصفه أداة تنفيذ أو مدافعاً عن النظام، بل باعتباره شاهدًا حقيقيًا على انكسار المشروع الوطني من الداخل، وباحثاً في الوقت الضائع عن صيغة نجاة لم تتحقق. ففي ثقافة الاعتراف والذاكرة، لا يكتفي الشرع بسرد الأحداث، بل يحاكمها أخلاقيًا وسياسيًا، من موقع من يعرف أكثر مما يُقال، ويقول أقل مما يُعرف.
يمثّل الشرع في كتابه هذا نوعًا خاصًا من المثقفين السياسيين: من أولئك الذين لم ينشقوا، ولم يصمتوا، بل اتخذوا موقفًا مركّبًا بين التراجع والمراجعة، بين الحذر والكشف، بين الإدانة والصمت المبطّن. هو مثقف الدولة حين كانت الدولة تتسع لجميع السوريين، ثم أصبح شاهداً على اغترابها عن ذاتها وانزلاقها في الغنيمة والخراب.
الرواية التي لم تُروَ
في مذكراته الثانية، لا يتحدث الشرع عن نفسه بقدر ما يتحدث عن دولة تتفكك، ورئيس يتلاشى في نرجسيته، ونظام يتخلى تدريجيًا عن السياسة. يعاين من موقعه مسؤولاً ووزيرًا ونائباً للرئيس تحول بشار الأسد إلى حاكم معزول عن الواقع، غارق في الهوس الإعلامي، فاقدٍ للتعاطف، وعديم الوفاء بوعوده. يصفه بوضوح مدهش بأنه "نرجسي سيكوباتي"، فاقد للشعور، يعيش في وهم الأبدية، وينتج نظاماً من التبلّد الأمني والخواء السياسي.
يحفل الكتاب بقراءة دقيقة لكواليس القرار السياسي في سوريا، وكيف تحولت الاجتماعات إلى مناسبات للتهرّب من المسؤولية، وتحوّل الحوار إلى غطاء زائف للعنف. يروي الشرع بأسلوبه المتأني كيف خُذلت المبادرات السياسية منذ أيامها الأولى، بدءًا من اللقاء التشاوري في 2011 الذي ترأسّه، وكان أوّل محاولة جادة لإنقاذ البلاد سياسيًا، لكن بشار انقلب عليه وسرّب أوامر إلى اتحادات البعث لتشويه المؤتمر ونزع شرعيته. يوضح الشرع، المثقف البعثي السابق، كيف جرى تخريب اللحظة السورية داخليًا، وليس فقط نتيجة للتدخلات الخارجية، منتقدًا الانحطاط الأخلاقي في الأداء الرسمي، والعجز السياسي عن الإصلاح، والانصراف إلى "الهيبة الشكلية" عوضًا عن احتواء الشارع الغاضب.
الدولة بصفتها منفى
تتيح لنا هذه الذاكرة عرضًا واسعًا لتفاصيل الإقصاء السياسي التي تعرّض لها بعد 2013. لم يُقَل له إنه مرفوض، لكن أُغلِق مكتبه، وجرى تسريح موظفيه، ومنع زملاؤه من زيارته، في واحدة من أكثر عمليات "الإبعاد الناعم" وحشيةً في تاريخ البيروقراطية العربية. ولم يكن هذا سوى تتويج لمسار طويل من العزل الرمزي بدأ منذ لحظة تراجع الأسد عن الحوار الوطني الذي كلفه الشرع بترأسُه. في هذا السياق، يُستدعى مفهوم "مثقف الدولة" بصفته وظيفة لا تنفصل عن شروط السلطة، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بإمكانية التحول إلى ضميرها. فالشرع ــ الذي لم ينشق كما يوضح ــ لم يترك النظام لأنه لم يؤمن بأن البدائل الدولية تقدّم مشروعًا وطنيًا، لكنه اختار "الاعتكاف" كصيغة احتجاجية نادرة في تراث السياسيين السوريين.
الشرع، المثقف الذي كان شاهداً ومشارِكاً ومهمَّشاً، لم يُرد أن يكون شريكاً في تدمير سوريا، فكتب شهادته واعتكف. وفي هذا، يقدّم نموذجاً مركباً ومؤلماً عن المثقف الذي يعي حدود الممكن، ويفضّل أن ينسحب بصمته لا أن يبرر بالجهر، ولكنه في الوقت نفسه يكتب، ليقول: لقد كنتُ هناك، ورأيت، وأردت شيئًا آخر.
من الذاكرة إلى الورق
إذا كان المثقف التقليدي في النظم السلطوية يُستدعى ليبرر السياسات القائمة، فإن الشرع يقلب هذا الدور. هو لا يبرر، بل يروي. لا يدين الشعب، بل يُدين النظام. ولا يكتفي بالمراجعة، بل يكشف، رغم بعض المسكوت عنه. وهو إذْ يفعل ذلك، ينتقل من موقعه الرسمي إلى موقعه الثقافي، حيث تصبح الذاكرة وثيقة، ويصير الاعتكاف مقاومة رمزية، وتغدو الكتابة وظيفة أخلاقية. هكذا لا يعود كتاب "مذكرات فاروق الشرع 2" مجرد سجل سياسي، بل نصًا ثقافيًا، يجمع بين سرد السيرة وتحليل البنية، وبين كشف التفاصيل وتشريح الكارثة. وفي لحظة ما بعد السقوط، يمكننا أن نقرأه كوثيقة تأسيس لرواية سورية بديلة، تحاول أن تقول ما لم يُقَل، وتعيد الاعتبار للسياسة بوصفها حوارًا لا رصاصة. إنه نص المثقف السياسي في أقصى تجلياته: المتردد، الناقد، الموجوع، والمُصرّ على أن الحكاية لم تنتهِ بعد.