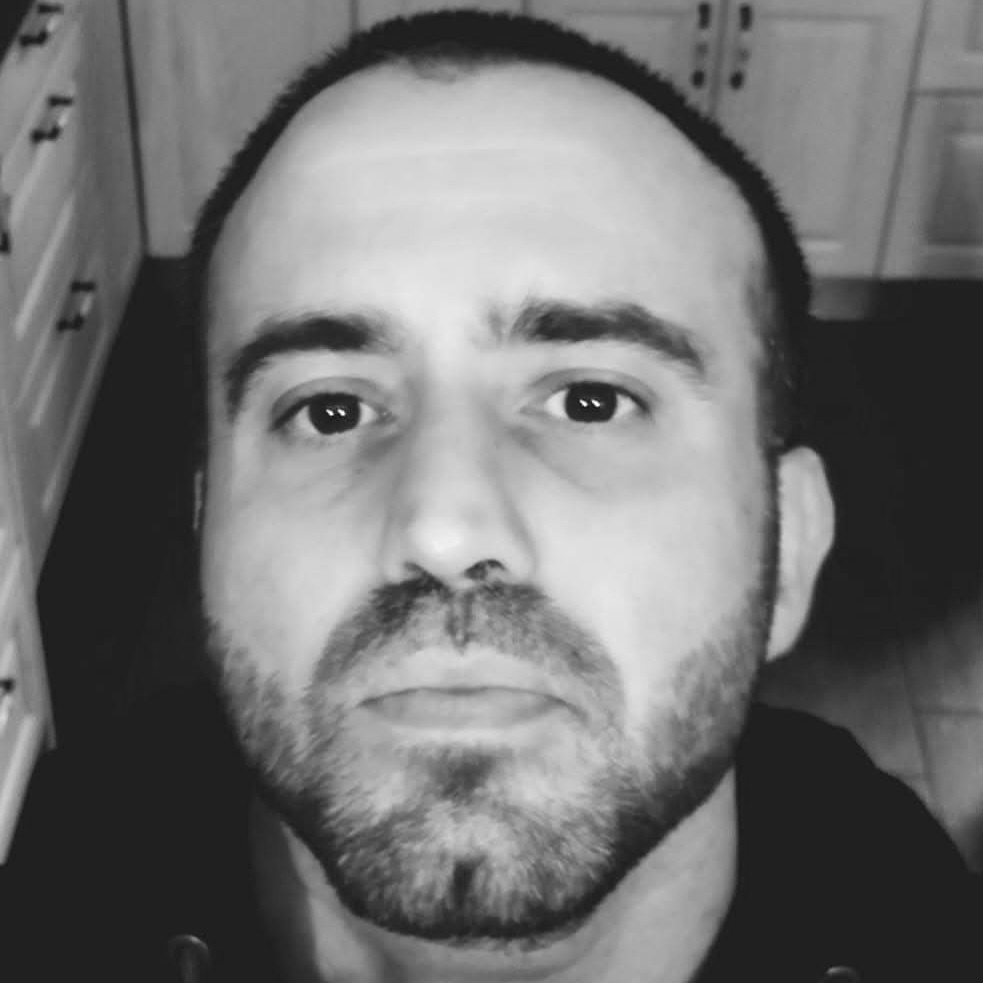كانت سليمة، كما تفعل خمس مرّات بالأسبوع، تقف وحيدة تحدّق في اللامكان تنتظر باص الساعة السادسة وخمسون دقيقة لينقلها إلى المدرسة، حين مر بجانبها أبو صالح، جارها السبعينيّ الأرمل وسألها مع ابتسامة مزوّرة على أشداقه يتوسّل بها قليلًا من الاهتمام والاعتبار: "صباح الخير، كيف حالك يا سليمة؟"
على غير عادتها لم تجبه هذه المرة بـ "صباح النور، تمام، الحمد لله" لكنها تابعت تحديقها في اللامكان من دون أن ترنو بعينيها اتجاهه، وكأنها تشاهد فيلمًا تشويقيًا في ذروة حبكته. ارتعدت سليمة، كما لو كانت لسعتها حشرة سامة، اربدّ وجهها، ارتبكت وتسمّرت في مكانها، ثقلت أنفاسها وانقطع اللغط من حولها على حين غرة.
يا له من سؤال مُرعب، هل أعترف له بالحقيقة؟
- لا لا، لم يحن الوقت بعد لكي أسلّم نفسي لنفسي وانتحر مصلوبة على مرآتها، لا زلت اقمع رغباتي الدفينة بالاعتراف حتى أمام نفسي، ولا حتى أمام الكاهن، لماذا لي ذلك، وأنا أصلًا لست كاثوليكيّة...؟
كيف أعترف له عن حالي وأني حتى لو تجاوزت الأربعين لا زلت أرغب بالانتقام من جاريَ الذي أخذني بحضنه وأخذ يداعب مؤخرتي بأصابعه النتنة قبل ستة وثلاثون عاماً، هل أعترف له إني ومنذ سنتين كل ليلة قبل أن أنام أرسم مشهدًا غاية بالإرهاب وأنا أعذّبه وأجلد جسده الخبيث، وانتزع أذنيه، وأشج جلده ببطء على إيقاع موسيقى نجاة الصغيرة بموس الحلاقة الأزرق الذي كان يحلق به أخي مُحسن، ثم أقوم بتعديل المشهد والتدقيق بتفاصيله كل ليلة من جديد... أم اعترف له بأني لا زلت أكره أمي التي توفّت قبل تسع سنوات لأنها نعتني بالـ "شرموطة" حين رفضت الالتزام بالحجاب عندما كنت بالصف العاشر، آهه، لا زلت أشتهي أن أهشّم رأسها بعصاة البيسبول تلك التي كان يخبئها أخي محمود تحت كرسي السائق في سيارته، لن أسامحها على كل تلك الإهانات والقهر وأيام الذل والشقاء وما مارست علي من ساديّتها واستبدادها.
هل أعترف لأبي صالح أني أشعر أن الحياة قذفتني ككيس قمامة إلى هوامش العزلة بعد انفصالي من ذلك الوغد الذي لا زلت أحبه على مبدأ "نفسي فيه وتفيه عليه"، أم أعترف له بذلك الشبق المجنون الذي ينخر رأسي منذ أن سألت تلميذي تامر ابن السابعة عشرة عن اسمه في أول حصة من حصص الجغرافيا في مدرسة النور الثانوية... وكيف تساورني يا أبا صالح تلك الأحلام الرطبة وأنا أدفعه الى مخزن المدرسة وأجعله يلتهم فرجي بنهم كما يبتلع طبيخ أمه صفاء الوقحة المتنوّقة التي أبغضها بذات مقدار شبقي لابنها. آخ لولا إصر المهنة الذي يُكبّلني لكنت مزّقت ثياب أشرف ذلك الشاب مفتول العضلات الذي يوزّع الطعام في مقصف المدرسة ومررت بشفتيَّ على جسده الأسمر وهو يطلق بصوته الرخيم كلماتٍ بذيئة صوبي تأجج نار غرائزي وتُسيل لعابي. وأني أريد أن أصفع المديرة وأبصق بين عينيها قبل أن أرمي أمامها استقالتي من تلك المهنة الرتيبة الباهتة، وأني لا أقدر على إخماد حرائق القلق ولا على الانعتاق من أصفاد هواجس المستقبل كوني امرأة مأزومة اقتربت من العقد الخامس ولا تزال عزباء وحيدة تمارس العادة تم تنكب على سريرها وحيدة مكروبة تكبح لجام نزقها وطيشها الذين لم تمارسهما أثناء مراهقتها، وأني استنفذت رياء الابتسامات المزيّفة التي أُطلقها بوجه زملائي، وكيف يتملّكني الذعر حين أفكّر في شيخوخة أبي التي تجعلني عنوة اتفكّر بمعنى حياتي الذي لم أجده بعد، وأني لا أزال ألعق جراح طفولتي التي لم يتحمّل القدر مسؤولية شفائها. هل تعلم كم مرة يا أبا صالح اشتهيت أن أحرق البناية عليكم جميعًا بعد أن أطلق رصاصتين على رأس البوّاب؟
كل تلك الآثام وغيرها من الخطايا التي لم ارتكبها لكنها لوثّت روحي يا عمي أبو صالح... كيف اعترف لك وأني أعتقد لو دَوّن حتى ذلك الذي يُعتبر أبسط البشر وأكثرهم طيبةً وأشدّهم سذاجة وغشامة مثلي أنا، تلك المرأة العبيطة، ما يدور بذهنه ويتخمّر بدياميس نفسه من فنتازيا يوميًا قبل المنام، لكُنّا قد استغنينا عن أفظع الروايات وأقبح أفلام الرعب... آخ يا عمي...
"سليمة”!
-جفلت سليمة وشعرت بالدوران والغثيان وكاد قلبها أن يفر من بين أضلاعها – كيف حالِك عمو، لي بترديش؟" قالها بنبرة صارمة ونظرة مشحوذة تحثّها على الإجابة.
"منيحة" أجابت -تنهدت سليمة- ثم استطردت: "تمام، تمام، كيفك انت عمي أبو صالح؟"